حمو النقاري وثنائية المشترك الإنساني والصور المستمدة من الوحي: قراءة نقدية
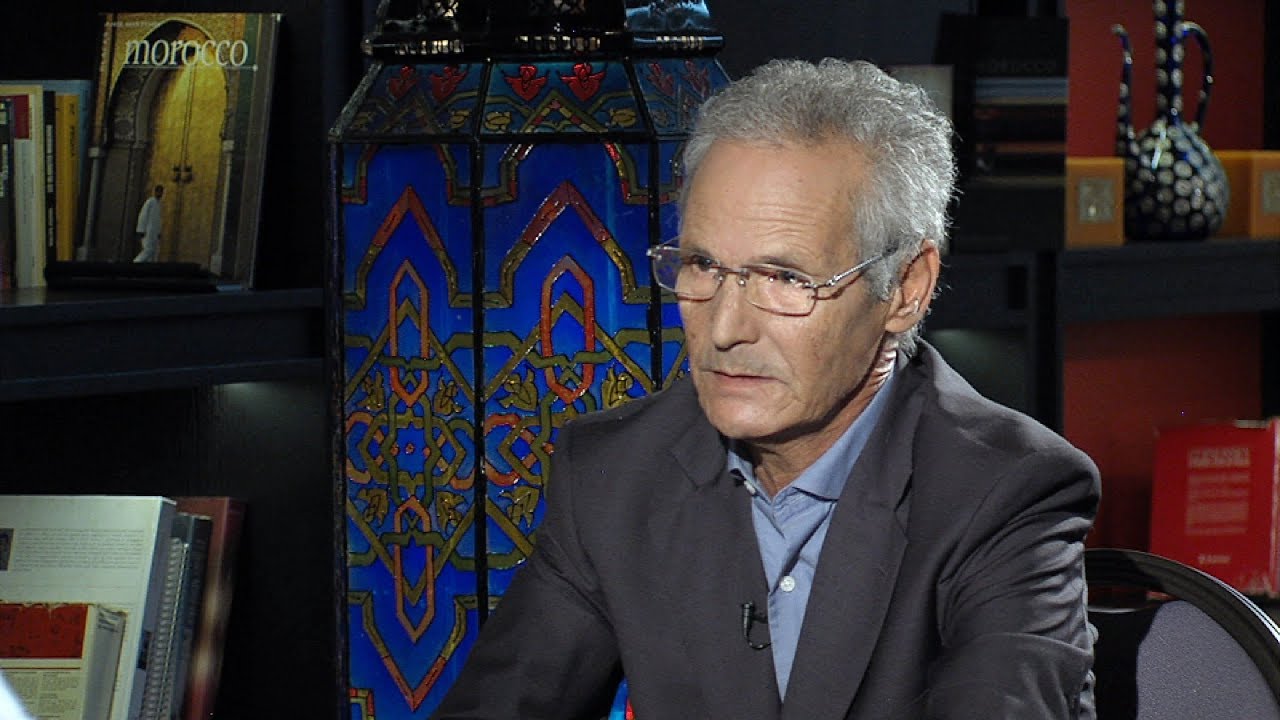
طارق هنيش
لما سألني الأستاذ عبدالله أحمد عن موقفي مما أورده الأستاذ حمو النقاري في مقالته، رأيت أن أميط اللثام عن نظري، وأبسط القول في تفكيك أطروحته، بيانًا لما استبنتُه من وجوهها، وتمييزًا لما انطوت عليه من صحيح وسقيم. إن دعوى التأثّر، لا تنعقد في موازين التحقيق إلا بشرطين مركّبين متداخلين، لا يتمّ انتسابهما إلى مقام السببية إلا باجتماع وجهيهما: الاتحاد في العلّة الباعثة التي تتقوّم بها جهة الإحداث، والتسوية في المقدمات المنتجة التي تُفضي إلى تطابق الاستنتاج وتواطؤ النتائج.
ومن دون ذلك، فإنما هو قذف بالأثر في غير مسبب، وتعليق للحكم على فراغ، وضرب من الاعتباط الظنيّ الذي لا يزكّيه برهان، ولا يحتمله مناط. فأما من رام إثبات التأثّر لمجرد المشابهة في بعض الفروع الجزئية، أو التلاقي في بعض الصور العرضية، فقد أخطأ وجه القياس، وأفسد جهة النظر، إذ خلط بين التماثل الصوري الذي لا يدل على تواطؤ الماهيات، وبين الاتحاد الجوهري القائم على الاشتراك في العلل التأسيسية. وهذا غلط منطقيّ يوقع صاحبه في مغالطة اشتراك الاسم واختلاف المسمى، ويفتح عليه باب الشُّبَه الالتباسية التي هي أضعف طرائق الاستدلال.
وقد أهمل الأستاذ حمو نقاري ـ أو تجاهل ـ الفرقان المحكم بين اللازم الذاتي الذي يتفرّع عن ماهية الشيء بمقتضى حقيقته، وبين العارض الاتفاقي الذي يلابس الشيء من خارج من غير أن يتقوّم به، فراح يقرّب البعيد ويباعد القريب، ويصوّر الأشباه متّحدة دون نظر في عللها القريبة أو البعيدة، الذاتية أو العارضة.
ولو تأمّل لعلم أن التشاكل في بعض الأحكام لا يدل البتّة على اتحاد في المباني الأصولية، كما أن تشابه المآلات لا يستلزم تقارب المناهج والمقاصد، بل كم من متماثلين ظاهرا مختلفين باطنا، وكم من متقاربين رسما متباعدين حقيقة، كما تقرّره القواعد الكلامية في تمييز الصفات بالاعتبارات الذهنية. فلا جرم أن من تمسّك بمثل هذا الوهم، فإنما هو ممن يسلك مسلك الجدليّين لا البرهانيّين، إذ يعتمد على مشابهات وهمية واستنباطات غير متصلة بعلة محقّقة، فيقع في مغالطة العلّة المتوهمة التي تزيّن ظاهر الربط وتخفي فساد التلازم. وهذا، بعينه، ما عدّه المتكلمون من باب المركّبات المشبَّهة، التي هي أشدّ فتنة في باب الاستدلال، لأنها توهم صحة القياس فيما لا قياس فيه، وتغرّ الناظر بمقدّمات مسلّمة لكن موصولة على غير وجه معتبر.
هذا المسلك، إن لم يُفرّق فيه بين التماثل العرضيّ والاتحاد الذاتيّ، ولا بين المشارَكة في بعض اللوازم والاشتراك في الأصول والمبادئ، أفضى إلى فوضى في التنسيب، واختلاط في الانتساب، فجعل الطوارئ العارضة كالأصول الراسخة، والأشباه الظنية كالمقارنات البرهانية، ولا عبرة عند أرباب التحقيق بمثل هذا الخبط المتهافت، الذي يلبس رداء الاستدلال وهو عارٍ من أركانه، وينتحل صورة التحقيق وهو واهٍ في بنيانه. ذلك أن المعلولات، وإن اتفقت في صورتها الظاهرة، أو تشابهت في رسومها الإدراكية، أو تقاربت في مخرجاتها التطبيقية، فإن هذا التوافق الظاهري لا يُعدّ دليلًا على اشتراكها في المبادئ القبلية، ولا برهانًا على اتحادها في العلل الغائية، إذ التشاكل الصوري لا يُنتج تواطؤًا جوهريًا، ولا يُفضي بالضرورة إلى الاشتراك في السنن الاستدلالية التي تُنتج الأحكام. فكم من متماثلين في الصورة متباينين في العلة؛ أحدهما ناشئ عن علّة ضرورية تستفاد من نصوص قطعية، والآخر مستند إلى قرينة عقلية ظنية، لا يجمع بينهما إلا شبه اتفاقي في الصورة دون اتحاد في المبدأ أو المقصد، وكم من متقاربين في الحكم، مباينين في مناطه، إذ يتأتى الحكم من جامع مختلف، فقد يكون العلّة في أحد الموضعين مناسبة خفية، وفي الآخر نصًّا تعبديًا صريحًا، فتشابه الحكم لا ينهض برهانا على وحدة المصدر.
هذا هو المعنى الذي أشار إليه الأصوليون في باب العلة المركّبة، حيث قد تتضافر عدّة أسباب بنسب متفاوتة في إنتاج حكم واحد، وكل منها يُنسب إليه الفعل من جهة خاصة، دون أن يدلّ ذلك على تطابق المصادر أو اتحاد الأصول. وكذلك في الجامع الظني، فإنما هو تركيب ذهنيّ يستبطن اشتراكا في بعض الأوصاف لا كلّها، ويُستعمل لربط جزئيات شتّى بمعنى مشترك، من غير أن يكون ذاك المشترك مناطًا تامًّا للحكم.
ومن لم يحكم التمييز بين العلل الذاتية والعوارض الاتفاقية، وبين الجامع التام والجامع الناقص، وقع في خلط مخلّ، وألزم النظام الفقهي ما لم يلزمه، وظنّ أن تماثل الصورة يستلزم اتحاد المورد، وقاس الفقهيّات الإسلامية المستندة إلى النص والإجماع والقياس المعتبر على النظم البشرية المنحوتة من التأملات العقلانية المقطوعة عن سلطان الوحي. ولو فتح هذا الباب، أي باب الاعتماد على التشابهات الظاهرية لإثبات التأثر والتداخل، لاقتُحم بذلك حمى العقائد والأحكام والمقاصد، ولقيل بتأثر الشريعة بالإسرائيليات من جهة المشاركة في بعض القصص، وبالتقاطع مع الرومان في بعض الحدود، ومع الفرس في بعض التدابير السلطانية، وهو خلط مردود، إذ لم يُفرّق فيه بين المشترك الفطري والاقتباس التاريخي، ولا بين القدر العقليّ المشترك بين بني الإنسان والاستمداد المخصوص من منظومة بعينها.
فالواجب على الناظر، إذا رام التحقيق، أن يُعمل ميزان التفريق بين أوجه الاتفاق اللازمة للمشترك الإنساني، وبين الصور المستقلة المستمدة من الوحي، وأن لا يُغترّ بمجرّد التشابهات العرضية، فإنها، في ميزان المتكلمين، لا تنعقد حجة، ولا تُستدل بها على علّة ناقلة ولا باعث محدث، بل غايتها أن تكون تواطؤًا اتّفاقيًا لا أثر له في جهة الفعل ولا مناطه، كما نصّ على ذلك الإمام الرازي في تحقيقه لجهة العلّة الشرعية.
ثم إن الفقه الإسلامي، في جوهره المركّب وصنعته الاجتهادية المحكمة، ليس مجرد بناء نظري يُستنبط بالعقل المجرّد أو يستوفى من طريق التأمل الفلسفي الصوري، بل هو بنية استدلالية تنتظمها قواعد الأصول، وتحرسها ضوابط الاستنباط، وتغذّيها عوائد الاستقراء وأنحاء التعليل، وهو في مجمله ثمرة تفاعلٍ دقيقٍ بين النصّ الشرعي المحفوظ والملكة الفقهية الراسخة، لا يصدر عن عقل مطلق، ولا يتأسس على تمثلات ميتافيزيقية مجردة، بل هو عقل مأمور، منضبط، مقيّد، يدور حيث دار الوحي، وينحرف عمّا حاد عنه. فالاجتهاد فيه لا يُعدو كونه استخراجًا منظّمًا، يجري على سبيل التحقيق لا التخمين، ويُبنى على المعاني المقصودة لا الصور المتوهَّمة، ويُراعى فيه الشرط التعبّدي والحدّ التوقيفي، مما يجعله مخالفًا في أُسّه ومنهجه لما سطره فلاسفة اليونان، الذين أقاموا أنساقهم على مقدمات عقلية محضة، لا تخضع للوحي، ولا تقف عند عتبة الشرع، بل يضربون صفحًا عن سلطان النص، ويتيهون في فضاء العلل الغائية والصور النوعية والهيولات الأولى، فلا مرجعية لهم إلا العقل المفارق، ولا حاكم عليهم إلا المقولات الماورائية، التي لا تثبت بحد، ولا تنضبط بقيد، بل هي أهواء فكرية متكلفة، تأنف من الوضع التعبدي وتستنكف عن الاستمداد من خطاب النبوة.
فهل يظنّ بفقه، هذه مادته، وتلك آلته، وهذه غايته، أنه يأخذ من هؤلاء؟! أفيرتضي فقيه من أهل الاستنباط، وهو الذي لا ينطق إلا بلسان القياس المعتبر، ولا يحرّك ساكنًا إلا وفق سد الذرائع أو فتحها، ولا يُفتي إلا حيث العلّة المنضبطة بالمعنى المعقول، أن يستقي من فلاسفة لم يضعوا للنبوة ميزانًا، ولا للرسالة مقامًا؟! حاشا وكلا، بل إن الفقيه، بما هو فقيه، لا يبني حكمًا إلا حيث نصّ أو إجماع أو قياس جارٍ على سنن الاستدلال، ولا يعتبر من المعاني إلا ما صحّ سندًا وجرى اعتبارُه عرفًا وتقرّر أصلُه شرعًا، فهو عبد النص لا عبد الفرض، وتابع للوحي لا مقلّد للخرص.
ثم إن تلك الفلسفات، لو عُرضت على محكّ الأصول، لردّها الفقيه من باب المصلحة الملغاة، ولسقطت في ميزانه من جهة العلّة غير المنضبطة، إذ ليست مقاصدها مقاصدَ شريعة، ولا وسائلها وسائلَ استنباط، بل هي ظنون مترامية، يعوزها التقييد والتأصيل، ويغلب عليها الإطلاق الذي يُبطِل القياس، والتحكّم الذي يُسقِط العلة. وكيف يُقال بالتأثّر من جهةٍ لا تعترف حتى بمبدأ التكليف، وتُنكر العبودية الاختيارية، وتؤسس رؤيتها للإنسان على مجرد كونه حيوانًا ناطقًا، لا مكلفًا مخاطبًا؟! فشتّان بين فقهٍ أُسِّس على خطاب الربّ لعبده، ورعاية الشرع لمصالح خلقه، وبين فلسفة تُبنى على فرضيات خيالية، وتأملات عقلية غير مسندة، تجحد ما لم تحط به علمًا، وتردّ ما لم تصل إليه بمجرّد الذهن. ومن لم يُحسن التمييز بين هذا وذاك، فهو من أهل التوهمات التماثلية، الذين يخلطون بين التماثل الصوري والاتحاد المنهجي، ويحسبون كل شَبهٍ تأثُّرًا، وكل اتفاقٍ في النتيجة اشتراكًا في العلّة، وهذا مذهب ضعفاء النظر، لا أرباب التحقيق من أهل الأصول والجدل. فأما ما يُتداول من دعوى أن بعض الفقهاء قد ورثوا ما يُسمى تمييزًا جندريًّا عن فلاسفة اليونان، فهو تقوّل مجازف، وتحكّم متعجِّل، لا يقوم على ساق من استدلال، بل هو خبط تشبيهيّ بين نظم متباينة في أصولها، متخالفة في مآخذها، وخلط بين مأخذ العلة ومظهر الحكم، وظنٌّ موهوم بأن التشابه في بعض المخرجات دليل على وحدة المنشأ أو اتحاد المقصد، وهو من قبيل التماثل الظاهري الذي لا ينهض في مقام التحقيق، ولا يُعتد به عند المحققين من أهل الأصول والجدل.
أما وجه المجازفة الأول، فإنه يتجلّى في نُبْوَةٍ بيّنةٍ ومَغَبّةٍ مُهلكة، إذ يُحكَم على مناطات الأحكام الشرعية بغير ما أنزل الله، ويُجعل مناط التكليف خاضعًا لتوهّماتٍ تخييليةٍ اجتماعيةٍ تُنْسَج من نُتَفِ الأعراف ومنتجات الوضع البشريّ، لا من موارد الخطاب الشرعيّ ومآخذ الأحكام الأصولية. فإنّ مَن رام تأسيس التكاليف الشرعية على التمييز النوعي من حيث هو هو، أي باعتبار الذات المجردة عن أوصاف التكليف وشروطه، فقد أخطأ جهة النظر، وجعل ما لا يصلح مناطًا مناطًا، وارتكب مغالطة إهمال القيد، وهي من أعظم ما يفسد مسالك الاستدلال.
ذلك أن مناطات الشريعة لا تُستفاد من مجرّد الأنواع الكلية، ولا من الصور الجوهرية على النحو الأرسطيّ، ولا من المعاني المتخيّلة لأدوار النوع في السياق الاجتماعيّ، بل هي مربوطة بعلل معتبرة، دلت عليها الأدلّة السمعية والعقلية، واستقرت عليها صيغ الاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر، المربوط بعلّة منضبطة، متحقّقة الوجود أو متوقّعة التحقّق، داخلة تحت أمهات القواعد، أو مستنبطة من مقاصد الشريعة الكلية. ومن ثم، فإن الفرق بين حكم الرجل والمرأة، إذا تحقق، فهو فرق شرعيّ، لا ذاتيّ، وفرع عن خطاب تكليفيّ، لا عن تقدير جوهريّ أفلاطونيّ أو تصنيف عرقيّ لاهوتيّ.
ولا مدخل في ذلك لمقولات التفاضل بين الأرواح، ولا لترجيحات القِدماء القائلين بمراتب الصور الكونية في سلسلة الفيض، إذ الشريعة أبَتْ أن تُعلّق التكاليف بالجوهر المجرد أو الصورة النوعية، بل رتّبتها على الاستعداد الخِلقي، والقابلية الفطرية، والوظيفة العمرانية، والمصلحة الشرعية التي تدور معها الأحكام وجودًا وعدمًا. وبعبارة أهل الأصول: فإن التكاليف جارية على موجب الخطاب الموجّه إلى من شأنه الامتثال، لا على مقتضى الذات الكلية، بل على ما تحقّق فيه وصف التكليف، وانضبطت فيه شروطه وموانعه. فالتفاوت في الأحكام حيث وُجد، إنما هو من باب تخصيص العامّ بالصفة أو تقييد المطلق بالقيد، لا من باب إثبات التفاضل بين الذكورة والأنوثة في ذاتيهما، ولا من جهة الاعتقاد بأن للنوع الذكري فضيلة جوهرية تزيد على النوع الأنثوي، فإن هذا من القول على الله بغير علم، ومن التعدّي في مسالك الاستنباط. بل الذكورة ليست مناط فضيلة، ولا الأنوثة مناط نقص، وإنما الأحكام منوطة بعلل شرعية معتبرة، وقواعد استقرائية منضبطة، يراعى فيها حال المكلَّف، واستعداده، وطاقته، وموقعه من خطاب الشرع، بما لا يُخرج الحكم عن كونه توقيفيًا، وإن كان اجتهاديًا في وجهه الاستنباطي، لأن غاية المجتهد في هذا الباب إنما هي تحقيق المناط، لا تغييره، وتعيين العلة، لا ابتداعها، وضبط مقتضى النص، لا مزاحمته بمحض الاعتبارات الوضعية أو الثقافات الدخيلة.
وأما الوجه الثاني، فهو أن الفلاسفة اليونان أنفسهم لم تجمعهم كلمة واحدة في النظر إلى المرأة، بل قد تباينوا تباينًا فاحشًا، ووقعوا في مضايق شتى، فمنهم من أنزلها عن رتبة الكمال الإنساني، كما فعل أفلاطون إذ عدّها رجولة ناقصة، ومنهم من أسقط عنها قابلية العقل أصالة، كأرسطو الذي جعلها هيولى تابعة بلا صورة، ومنهم من نظر إليها من زاوية نفعية محضة، كما في تصوّر السياسة الطبيعية عند الرواقيين، حيث كانت الأنثى تابعة لناموس الطبيعة لا ذات حقّ جوهري. فهل يُتصوَّر أن يَرِثَ فقهاء الإسلام، وهم أهل فطنة واستدلال، وسدنةُ النص والاجتهاد، تصوّراتٍ تضادّ صريح الوحي وتناقض بدائه الشرع؟! حاشاهم، بل هم أرباب تحقيق، لا ينزلون عن حكم إلا بنص أو إجماع أو قياس جارٍ على موجب الأصول. وما من فرقٍ بين الرجال والنساء في الأحكام إلا وله علّة معتبرة، إما منصوصة أو مستنبطة، لا تستند إلى جوهر نوعي، بل إلى وصف مؤثّر معتبر في الشرع.
ثم إن هذه الدعوى التي تُطلق بغير زمام، إنما صدرت ممن ظنّ أن كل تمايز في الحكم هو تمييز في القيمة، وكل تفريق في التكليف هو تحيّز في النظر، وهي مغالطة مبنيّة على مصادرة الحدّ ونقض مناطات الأحكام، بل هي إسقاط للأنظمة الغربية الحديثة على البنى الفقهية الإسلامية، وإرغام لها على منطق الحقوق الفردية المنفصلة عن التكليف الشرعي. وهذا غلط في التصور قبل أن يكون غلطًا في الاستدلال. فلو أن المنصف رام أن ينظر إلى وضع المرأة في الشرع نظرًا مقارنًا، لرأى أن الشريعة، في مقابل ما قرره فلاسفة الوثنيات، قد أقامت المرأة مقام الكرامة والتكليف، وخاطبتها بما تخاطب به الرجل من أوامر ونواهٍ، ولم تَجعل إنسانيّتها موضع اشتباه، بل قررت أنها شقيقة الرجل في الأحكام، مساوِيَة له في أصل التكليف، مختلفة عنه فيما يقتضيه الجنس من تباين الوظائف، لا من تفاوت الجوهر.
أما أولئك الفلاسفة، فحدّث ولا حرج عن تصوّراتهم التي تجعل المرأة كائنًا طفيليًّا أو خادمًا للنوع، لا ذاتَ تكليف ولا موضع خطاب، فضلاً عن أن تكون موضع وحي وتشريع. أفبعد هذا يُقال إن الفقه قد ورث عنهم؟! وهل يُتوهّم الاشتراك في الثمرة مع افتراق الأصل، ويُدّعى التأثر عند انعدام الشرط؟! هيهات، بل تلك دعوى فاسدة بشاهد النقل والعقل والضرورة الفقهية. فلا جرم أن هذه الدعوى، إن أُحكم النظر فيها، تبيّن أنها من باب التمويه المنطقي الذي يوهم الاتّصال بين متغايرين، ويُظهر التشابه حيث لا جامع إلا في الصور، وهو من جنس الشبهات الخطّافة التي نصّ الغزالي على فساد التعويل عليها، إذ تُشبه القياس وليست منه، وتُوهم الدليل وهي مركّبة من اشتراك في الصورة مع اختلاف في الغاية والمقصد. فتوسعة الأستاذ حمو نقاري لمفهوم “الجندر” وتشقيقه لفروعه وتوابعه، إنما تجري في مجرى نسقٍ ليبراليٍّ دخيلٍ، منتحلٍ للخطاب الحقوقي الغربيّ، مبنيّ على مقولات مفارِقة لأصل الخلقة، ومجترئٍ على الماهية البشرية كما هي في مقتضى الفطرة ومقررات الوحي، إذ ذاك التوسيع لا يقف عند حدّ الفصل الوظيفيّ، بل يتعدّاه إلى نفي الماهية الطبيعية، ومسخ الفروق الخَلقية بين الذكر والأنثى، وجعلها محضَ “بناء اجتماعيّ”، يُعاد تشكيله بحسب الإرادة الذاتية والتخيّل النفسي، على طريقة ما بعد البنيوية، وهو أمرٌ لا يُستند فيه إلى ميزان التكليف، ولا يُراعى فيه التقويم الإلهيّ الذي نصّت عليه آيات الخلق والتسوية، بل هو نَفَس إلحاديّ دفين، ينفخ في القول نفيًا للمقدّس، وتذويبًا للفروق الفطرية، ومصادرةً للمبنى القرآنيّ في التنويع التشريعيّ، وتقسيم الأدوار الوجوديّة. وإنّ هذا المسلك، على ما فيه من تلطّف اصطلاحيّ وتظاهر بـ”التفكيك”، لا يمتّ إلى فهم التراث بأدنى صلة، بل هو إسقاط إسقاطيّ، لا يتجاوز المراوحة بين الترجمة والتقليد، وإنما يلبس لبوس التأويل ليخفي انتحال النموذج، إذ يُؤخذ المفهوم الغربيّ الذي نُحت في سياق الصراع الحداثيّ مع الكنيسة وميراثها الذكوري، ويُلقى به على النصوص الشرعية بمقاصّ التأويل، لا من جهة فقه المعاني، بل من جهة التمثّل الثقافي القهريّ، فكيف يُزعم بعد ذلك أن هذا ضربٌ من الفهم الموروث أو استئناف لمنهج الفقهاء؟ بل هو، في التحقيق، من جنس ما نُعِب به على بعض فقهاء القرون، حين اتُّهموا بالتأثّر بالفلاسفة، بيد أن أولئك ـ إن صحّ الاتهام ـ إنما جاوروا ولم يستبطنوا، ووازنوا ولم يستبدلوا، بخلاف هذه الحال، حيث تُنبذ مقررات النص، وتُستبدل بمقولات نشأت في سياق إبستمولوجيّ مفارق، لا يعترف لا بالوحي مصدرًا، ولا بالخلقة معيارًا، بل هو قائم على جدل الهوية والسلطة والخطاب.
فكيف يستقيم إذن أن يُستقبح على الفقيه المشتغل بالنص أن يقارب تصورًا يونانيًا في مسألة عقلية ـ وهو ما قد يُحمل على الاجتهاد في مأخذ من المآخذ ـ، ثم يُستحسن على المعاصر أن يؤسّس تأويله الشرعيّ برمّته على نظرية “جندرية” تنفي الفطرة، وتبطل التكاليف، وتُلغي الخصائص، وتُعيد تفسير الدين نفسه بلغة الشك البنيويّ؟! أليس هذا من الاضطراب المنهجيّ والتحامل الثقافيّ، بل من التناقض المستبطن، إذ يُدان القديم إن وافق بعض مفردات التصور الإغريقي، ويُكرَّم المعاصر وهو ينقل نسقًا غربيًّا كامل البنية، مفصول الجذر، مشبوه الغاية، ويُلقي به على صعيد الشريعة مطلق اليد، غير مقيّد بميزان ولا موصول بأصل؟! فأنّى يستقيم هذا في منطق الإنصاف؟ بل كيف يُقبل في ميزان التحقيق؟ وهل غدا الفقيه الغابر أهونَ من المؤوِّل الحاضر، حتى نكيل بمكيالين ونزن بميزانين؟! وهل العدل إلا أن يُعرض كلّ قول على موازين الأصول، لا على أهواء الأجيال؟!



