هذه أسباب تراجع البحث العلمي الرصين
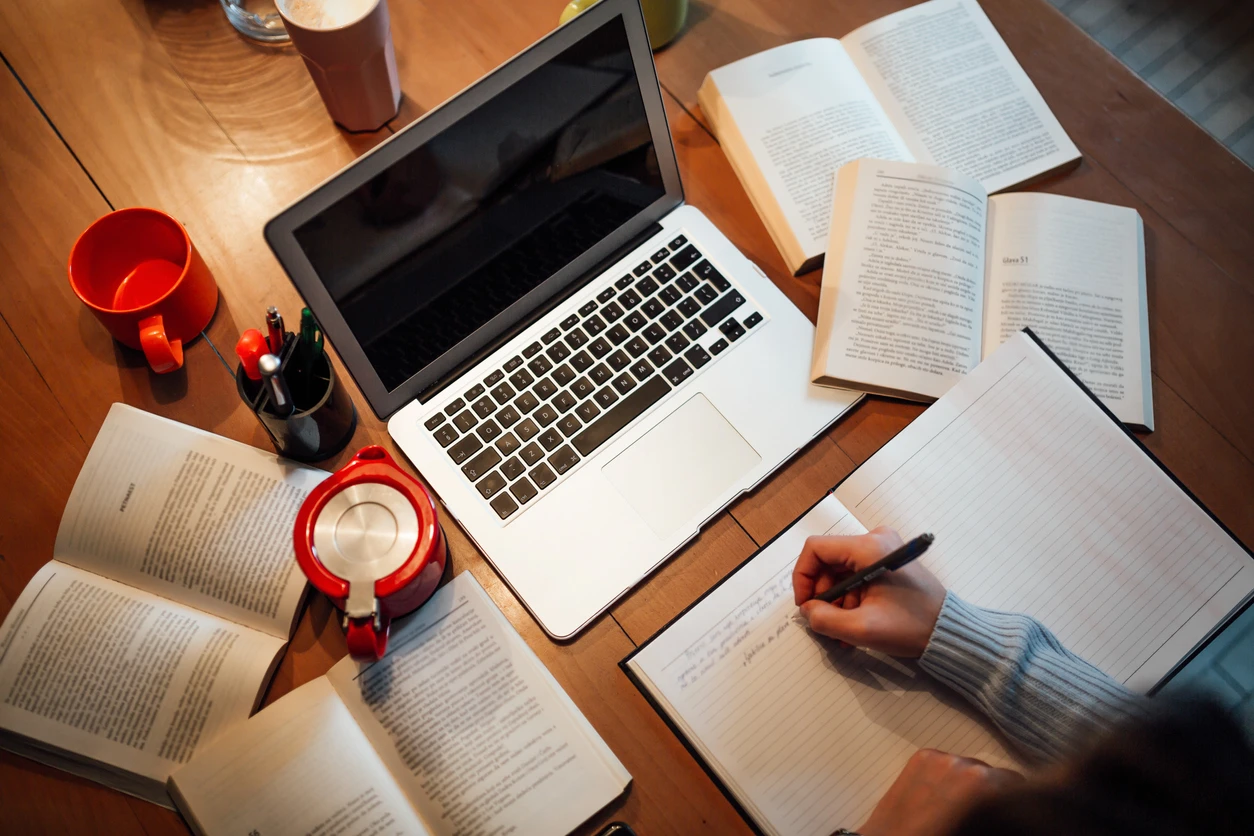
سليمة عبد الجليل بن جلون. باحثة مغربية تقيم في أمريكا
تراجع البحث التاريخي الرصين لا يُعد وليد لحظة عابرة، بل هو نتيجة مسار طويل من التفكك المعرفي والانزياح المنهجي الذي أصاب البنية الداخلية للحقول التاريخية الجامعية. ويمكن تحليل هذا التراجع من زوايا عميقة تتجاوز التفسير السطحي أو الخطابي، نحو مساءلة البنيات المعرفية، والخيارات المنهجية، والممارسات التكوينية التي تحكم إنتاج التاريخ اليوم.
أولاً، انحسار التكوين الإبستمولوجي يمثل جوهر الأزمة. فالتاريخ لم يعد يُدرّس بوصفه علمًا له أدواته في التحليل والتركيب، بل بوصفه سردًا زمنيًا يُستعاد بشكل خطي وتراكمي. غُيّب النقاش حول المفاهيم الكبرى: الزمن، البنية، الحدث، الوثيقة، التفسير، واستُبدلت بمقاربات محفوظة تُعيد إنتاج ما هو قائم دون مساءلته. غاب الوعي بتاريخ الكتابة التاريخية ذاتها، وفقد الطالب قدرته على التمييز بين الواقعة كما حدثت، والتاريخ كما يُكتب ويُفكَّر فيه.
ثانيًا، تفكك الحس النقدي لدى الباحثين. لم يعد الطالب يتعامل مع النصوص بوصفها موضوعًا للفهم والاختلاف، بل بوصفها حقائق جاهزة تُجمَّع وتُرتّب داخل نسق خطابي مغلق. يغيب التساؤل وينعدم التأويل، لتحلّ محله ثقافة الحفظ والتكرار. البحث التاريخي الرزين يقوم على الشك والتحليل وإعادة البناء، لا على الانبهار بالمصادر أو الخضوع لسلطة المرجع.
ثالثًا، هيمنة النزعة الموضوعاتية الفارغة من المعنى التحليلي. تحول كثير من الباحثين إلى صانعي عناوين لا صانعي معرفة، فتُختار المواضيع لغرابتها أو طرافتها أو طابعها الإثاري، دون أن تُصاحبها أسئلة حقيقية أو مداخل نظرية واضحة. يصبح الموضوع هدفًا في حد ذاته، لا مدخلاً لسبر بنية زمنية أو فهم تحوّل اجتماعي أو تفكيك منظومة عقلية.
رابعًا، تراجع العلاقة بالوثيقة المصدرية. لم يعد التعامل مع الوثائق التاريخية فعلاً تفسيرياً نقدياً، بل صار مجرد تجميع لما هو متاح من نصوص مطبوعة أو أرشيف رقمي. يُنقل النص كما هو، دون وعي بسياقه، أو بحدوده، أو بأيديولوجيته الضمنية. يغيب التدريب على التحقيق، على المقارنة، على تأويل الصمت والغياب في المادة المصدرية، وهي مهارات لا غنى عنها في التاريخ الرصين.
خامسًا، القصور في التفاعل مع المناهج المتعددة. يعاني كثير من الباحثين من عزلة معرفية تجعلهم يُنتجون تاريخاً مغلقاً على ذاته، دون أن يتفاعلوا مع نتائج الأنثروبولوجيا، والسوسيولوجيا، واللسانيات، والعلوم الاقتصادية. لم يعد التاريخ يُكتب بوصفه علماً مشتبكاً مع حقول أخرى، بل بوصفه تكراراً لما قاله السابقون بأسلوب جديد.
سادسًا، اختزال الزمن في الوقائع والوقائع في الأشخاص. يتحول البحث إلى سرد للأسماء والتواريخ والتحركات العسكرية، دون إدراك للبنيات العميقة التي تحكم الحقب التاريخية. لا يُطرح سؤال: كيف كان يُبنى القرار؟ كيف تشكل الوعي الجماعي؟ ما الذي يجعل طائفة تُقاوم وأخرى تستكين؟ التاريخ الرزين ليس وصفاً لما جرى، بل تحليل لما كان ممكنًا أن يجري، لو توفرت شروط أخرى.
سابعًا، غياب مشاريع بحثية تمتلك نسقًا إشكاليًا وتراكمًا معرفيًا. كل بحث يُبنى من نقطة الصفر، دون انتماء إلى مدرسة، أو إطار معرفي، أو تقليد بحثي نقدي. غابت المشاريع الجماعية، وغابت حوارات الأجيال، فصار كل باحث يُعيد اختراع العجلة، ويدور في نفس مدار التكرار.
ثامنًا، ضعف اللغة الأكاديمية وعدم ترسيخ الكتابة التاريخية بوصفها فعلاً معرفيًا وأسلوبًا في التفكير. تُكتب الأطروحات بلغة تقريرية وصفية، يغيب عنها التوتر المفهومي، والثراء الاصطلاحي، والبعد التفسيري العميق. وكأن التاريخ يُكتب ليُنسى، لا ليُخلخل.
هذه العوامل لا تتعلق بعرض سطحي أو نزوة جيلية، بل هي أعراض لتآكل عميق في البنية المفهومية والمنهجية والمعرفية للبحث التاريخي. إصلاح هذا التدهور لا يمر عبر صياغة شعارات أو فرض موضوعات، بل يتطلب إعادة بناء الحقل التاريخي من الداخل، من خلال استعادة الوعي بالإبستمولوجيا، وتعزيز الحس النقدي، والقطع مع وهم الحياد والوقائع، والانتقال إلى تاريخ يُفكّر ويؤرّخ لا يُسرد فقط.



