من العطالة الاستعرافية إلى الجمود المعرفي: نماذج في السياسة والاجتماع
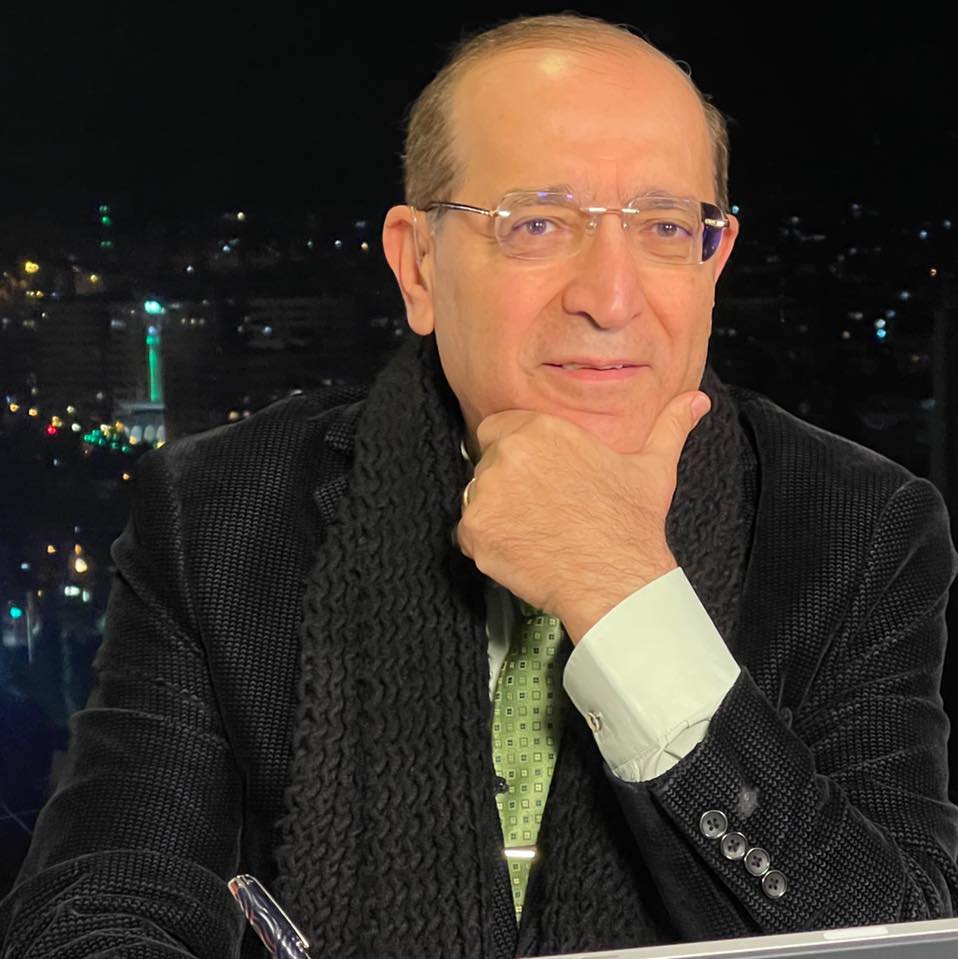
عماد فوزي شعيبي. مفكر من سوريا
يُشير مصطلح ” القصور الذاتي ” الفيزيائي إلى مقاومة التغيير وهنا المقصود فيه مقاومة التغيير في أسلوب معالجة القضايا معرفيًّا. أي إنه الميل – في توجه معين في تفكير الفرد نحو مسألة أو اعتقاد أو استراتيجية – إلى مقاومة التغيير. وكثيرًا ما تصفه الأدبيات السريرية والعصبية بأنه نقص في الدافع لتوليد العمليات المعرفية اللازمة للتعامل مع مسألة أو مشكلة. ولكن في قناعاتنا أن جزءاً كبيراً من عطالة المعرفة يكون بنيويّاً أي طبيعة الشخصية نفسها، وبعض الشخصيات تستمر هذه العطالة معهم إلى الأبد، وبعضهم يكون لديه استعداد للتغيير كطبيعة ثانية، ولكن تقاوم طبيعته الأولى الطبيعة الثانية! ويتناوب نوسانهُ المعرفي بين العطالة والتغيير ولكن بعد عناء.
ويُخلط عادةً بين القصور الذاتي المعرفي والمثابرة أو التصلّب في الاعتقاد. [Belief perseverance]
لأن القصور الذاتي أو العطالة الاستعرافيّة تكمن في آلية تفسير المعلومات، وليس في المثابرة في الاعتقاد نفسه. كما هو الحال في المثابرة في الأخيرة. لأن الأخيرة هي التمسك بالمعتقد (المعروف أيضًا بالمحافظة المفاهيمية) هو الحفاظ على الاعتقاد على الرغم من المعلومات الجديدة التي تناقضه بشدة.
في الإطار السريري، تم استخدام الجمود المعرفي-أيضاً- كأداة تشخيصية للأمراض العصبية التنكسية، والاكتئاب، والقلق.
تعود فكرة الجمود المعرفي إلى نظرية المعرفة الفلسفية. ويمكن العثور على إشارات مبكرة إلى تقليل العطالة الاستعرافية في الحوارات السقراطية التي كتبها أفلاطون. إذ يبني سقراط حجته باستخدام معتقدات المنتقد كفرضية لاستنتاجات حجته. وبذلك، يكشف سقراط عن مغالطة فكر المنتقد، مما يدفع المنتقد إلى تغيير رأيه أو مواجهة حقيقة أن عمليات تفكيره متناقضة.
عرّف أحد أوائل الباحثين في الشخصية، دبليو. لانكيس، الاستمرارية بشكل أوسع بأنها “الانحصار في الجانب المعرفي” وربما “المقاومة بقوة الإرادة”.
كانت هذه الأفكار المبكرة عن الاستمرارية بمثابة مقدمة لكيفية استخدام مصطلح الجمود المعرفي لدراسة أعراض معينة لدى مرضى الاضطرابات العصبية التنكسية، والتأمل، والاكتئاب.
في علم النفس المعرفي، تم اقتراح نظرية الجمود المعرفي في الأصل من قبل ويليام جيه ماكجواير في عام 1960، وتم بناؤها على النظريات الناشئة في علم النفس الاجتماعي وعلم النفس المعرفي التي تركزت حول الاتساق المعرفي، واستخدم ماكجواير مصطلح الجمود المعرفي لتفسير المقاومة الأولية لتغيير كيفية معالجة الفكرة بعد الحصول على معلومات جديدة تتعارض مع الفكرة.
في دراسة ماكغواير الأولية التي تناولت القصور الذاتي المعرفي، أبدى المشاركون آراءهم حول مدى احتمالية وقوع مواضيع مختلفة. بعد أسبوع، عادوا لقراءة رسائل تتعلق بالمواضيع التي أبدوا آراءهم بشأنها. عُرضت الرسائل على أنها حقائق، وكان الهدف منها تغيير اعتقاد المشاركين باحتمالية وقوع المواضيع. بعد قراءة الرسائل مباشرةً، وبعد أسبوع واحد، خضع المشاركون لتقييم جديد حول مدى احتمالية وقوع المواضيع. ونظرًا لعدم ارتياح ماكغواير لتناقض المعلومات ذات الصلة من الرسائل وتقييماتهم الأولية للمواضيع، فقد اعتقد أن المشاركين سيتحمسون لتغيير تقييماتهم للاحتمالية لتكون أكثر اتساقًا مع الرسائل الواقعية. ومع ذلك، لم تتحول آراء المشاركين فورًا نحو المعلومات الواردة في الرسائل. بل ازداد مع مرور الوقت اتجاه نحو اتساق الأفكار حول المعلومات من الرسائل والمواضيع، وهو ما يُشار إليه غالبًا باسم “تسرب” المعلومات.
وقد تم تفسير الافتقار إلى التغيير على أنه يرجع إلى استمرار العمليات الفكرية الموجودة لدى الفرد والتي تمنع قدرته على إعادة تقييم رأيه الأولي بشكل صحيح، أو كما أطلق عليه ماكجواير، الجمود المعرفي.
نموذجه في السياسة:
يُقترح اعتبار أن استمرار الانتماء إلى جماعة سياسية وأيديولوجيتها يعود إلى جمود كيفية إدراك الفرد لتجمع الأفكار على مر الزمن.
وغالبًا ما تكون المنظمات الحكومية مقاومة للتغيير أو بطيئة للغاية في التغيير جنبًا إلى جنب مع التحول الاجتماعي والتكنولوجي. حتى عندما يكون دليل الخلل واضحًا فيها، يمكن أن يستمر الجمود المؤسسي.
أكد في هذا السياق فرانسيس فوكوياما أن البشر يضفون قيمة جوهرية على القواعد التي يسنّونها ويتبعونها، وخاصة في المؤسسات المجتمعية الأكبر التي تخلق النظام والاستقرار. وعلى الرغم من التغيير الاجتماعي السريع والمشاكل المؤسسية المتزايدة، فإن القيمة الممنوحة للمؤسسة وقواعدها يمكن أن تخفي مدى جودة عمل المؤسسة وكذلك كيفية تحسين تلك المؤسسة.
ويلعب الجمود المعرفي دورًا في فقدان تدفق الأفكار خلال جلسات العصف الذهني الجماعي. فغالبًا ما يتبع أفراد المجموعة مسارًا فكريًا، حيث يواصلون التركيز على الأفكار بناءً على أول فكرة تُطرح في جلسة العصف الذهني. هذا المسار الفكري يعيق ابتكار أفكار جديدة تُشكل جوهر تكوين المجموعة الأولي.
أمثلة سياسية على العطالة الاستعرافية:
تمسك الاتحاد السوفيتي بالاقتصاد المركزي الصارم: فحتى مع ظهور مؤشرات فشل اقتصادي داخلي منذ الستينيات والسبعينيات، استمرت القيادة السوفيتية في تفسير الأزمات من منظور “المؤامرة الغربية” بدلًا من إعادة التفكير في الأسس الاقتصادية نفسها.
أمثلة اجتماعية على العطالة الاستعرافية:
أ. مقاومة بعض المجتمعات لتعليم المرأة: فحتى مع تزايد الأدلة على فوائد تعليم النساء اقتصاديًا واجتماعيًا، لا تزال بعض المجتمعات تُفسر هذه المسألة من زاوية “تهديد للتركيبة الأسرية”، وهو شكل من أشكال القصور الذاتي المعرفي في معالجة المعلومات الجديدة.
ب. وصمة الأمراض النفسية:
رغم التقدم العلمي الكبير الذي يُظهر أن الأمراض النفسية كالاكتئاب أو القلق لها أسباب بيولوجية ونفسية معقّدة، لا تزال بعض الفئات تفسرها كـ”ضعف في الشخصية” أو “ لأسباب عقائدية”.
أمثلة (معرفية) على العطالة الاستعرافية:
أ. التمسك بنظريات علمية متهالكة:
فلفترة طويلة، استمرت الأوساط العلمية بالتمسك بتصورات فيزياء نيوتن الكلاسيكية حتى ظهور ميكانيك الكم والنسبية، حيث واجه الكثيرون صعوبة في استيعاب المعلومات الجديدة خارج القالب الكلاسيكي القديم.
ب. جدلية مركزية الأرض:
حتى بعد اكتشاف كوبرنيكوس وغاليليو، استمر الكثيرون في تفسير حركة الكواكب ضمن نموذج “مركزية الأرض” بسبب الجمود المعرفي المتجذّر في الثقافة الدينية المسيحية والفكرية السائدة آنذاك.
ج. الخطاب الإعلامي التقليدي:
لا تزال بعض المؤسسات الإعلامية تُفسر الظواهر السياسية والاجتماعية بأطر تعود للعقود الماضية، رغم التغيرات العميقة في طبيعة المجتمعات ووسائل التواصل، ما يُعد شكلاً من العطالة الإستعرافية.
أمثلة فلسفية على العطالة الاستعرافية:
أ. نقد كانط للعقل الخالص:
أوضح كانط كيف أن الأطرالمفاهيمية للفهم قد تُقيّد قدرة الإنسان على استقبال المعطيات الجديدة، مما يُمكن فهمه كعطالة استدلالية في إطارنا المعرفي الأساسي.
ب. غاستون باشلار:
تحدّث باشلار عن “عقبات إبستمولوجية”، على رأسها المعرفة الشائعة حيث يُعيق التكوين الذهني القديم أو الفكرة السائد والمعرفة المسبقة، استقبال المعلومات الجديدة، وهو تفسير فلسفي دقيق للعطالة الإستعرافية. وهي تسير في الزمن الأفقي أي من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل وتتم القطيعة الإبستيمولوجية معها بثلاثة أشكال: قطع كامل قطع بالاحتواء وقطع بالتضايف.
الفرق عن المثابرة أو التصلب في المُعتقد: تتعلق الأخيرة بالتمسك بالمعتقد رغم المعلومات المتناقضة، لكن المشكلة هنا في الإرادة أو العناد المعرفي، بينما في العطالة الاستعرافية المشكلة في آلية التفكير ذاتها.
******************
ملاحظة: المقالة من فصول كتابنا الجديد قيد الأعداد، وعنوانه “مشكلات العقل: العقل المأزوم”.



