معنى الماحي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم
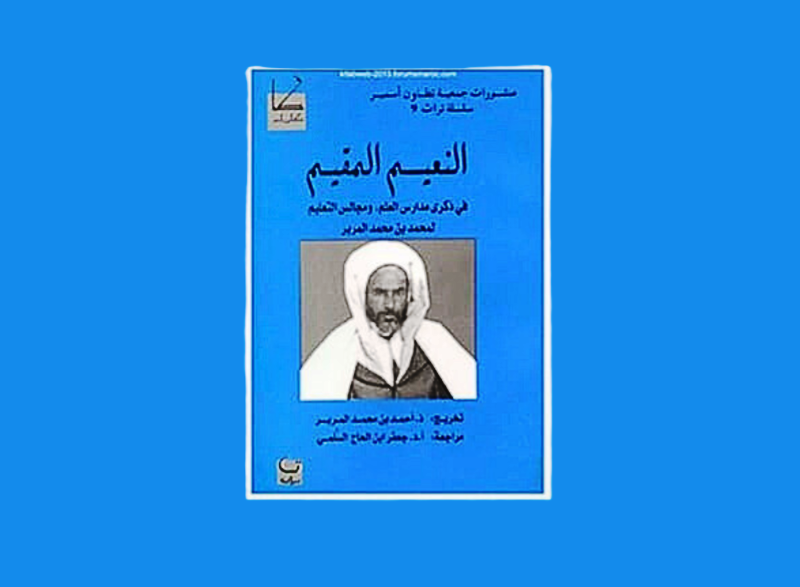
متابعة: د. منتصر الخطيب/ تطوان
فسَّر القاضي في الشفاء في أحد الاحتمالات اسم النبي صلى الله عليه وسلم، “الماحي” فقال: (أو يكون المَحو عامًّا بمعنى؛ الظهور والغلبة، كما قال تعالى: (ليظهره على الدين كله)هـ.
قال الشهاب الخفاجي: إثر كلام القاضي: (فالمراد بالمحو؛ عُلوّ الدِّين وغلبتُه لغيره من الأديان، بنَسْخها وبيان ما غُيِّر وبُدِّل منها، وعُلوّ أهلِه على جميع من عدَاهم، بتسليطهم عليهم وقهرهم وإيقاع الرعب في قلوبهم، كما هو مشاهد).
ثم كرَّر الاستدلال بالآية، ثم قال: (ويُوضِّحه أن المحو لغة؛ إِذْهَاب الأَثر. وهو قد يكون مع بقاء العين، وإن ما لا أَثر له كالعَدَم. ولذا عبَّر بالماحي دون المزيل)هـ./نسيم الرياض،ج/2-416.
وقد جاء بهذا المعنى مبسوطا، صاحب “المواهب” فقال: (وأما الماحي؛ ففُسِّر في الحديث بمَحْو الكُفر، ولم يُمْحَ الكفرُ بأحدٍ من الخَلق، ما مُحي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بُعث وأهل الأرض كلُّهم كفار؛ ما بين عباد أوثان، ويهود ونصارى ضالين، وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار، وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها، فمَحَاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أظهر دينَه على كل دِين، وبلغ دينُه ما بلغ الليل والنهار، وصارت دعوتُه مسير الشمس في الأقطار، ولما كانت البحار هي الماحية للأدران، كان اسمُه عليه الصلاة والسلام فيها الماحي)/المواهب،ج/1-187.
وعلى وجه الإجمال حسبما قدَّمْنَاه، إن الآية الكريمة مُحكَمة، صادق معناها على أوائل الأمة المحمدية وأواخرها، لِمَا صحَّ في ذلك من الأحاديث والآثار، وشهد له مشاهدة الأسماع والأبصار، وأنه صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الناس عامَّةً، وإلى سائر أقطار وأمصار الدنيا من المغارب والمشارق، وأنَّها باقيةٌ ما لاحَ طالع، وذرَّ شارق، وبه صرَّح الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما.
وقد كرَّر البخاري روايته فرواه في كتاب “التيمم” وفي كتاب “المساجد”، قال الحافظ في “الفتح” في حديث “باب التيمم”: (وأما قولُه: (وبُعثتُ إلى الناس عامَّة)، فوقع في رواية مسلم: (وبُعثت إلى كل أحمر وأسود)؛ فقيل: المراد بأحمر؛ العجم، وبالأسود؛ العرب.
وقيل: الأحمر؛ الإنس، والأسود؛ الجن. وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه مرسل إلى الجميع، وأصرح الروايات في ذلك وأشملها، رواية أبي هريرة عند مسلم: (وأُرسلتُ إلى الخلق كافة)هـ/ج-1-300.
ــــــــــــ
(النعيم المقيم، محمد المرير، ج/7-11)



