تقديم كتاب “لماذا نحن هنا؟ تساؤلات الشباب حول الوجود والشر والعلم والتطور” للدكتور إسماعيل عرفة
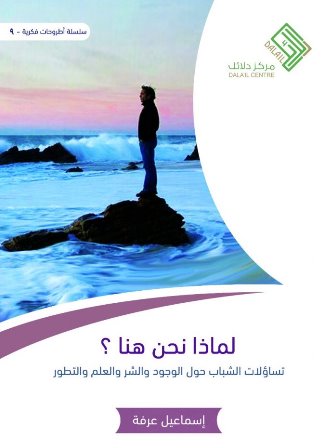
إعداد وتقديم: ذ.محمد جناي
صدر عن دار وقف دلائل للنشر العدد :9(1438 هجرية)،ضمن سلسلة أطروحات فكرية، وجاء بعنوان « لماذا نحن هنا ؟ تساؤلات الشباب حول الوجود والشر والعلم والتطور »، تأليف الدكتور إسماعيل أحمد عرفة.
ورد الكتاب في (259) صفحة من القطع المتوسطة، وحوى:
مقدمة؛
الفصل الأول : لماذا نحن هنا ؟؛
الفصل الثاني : سؤال الشر ؛
الإسلام والعلموية ؛
خاتمة ؛
قائمة المراجع ؛
مقدمة المؤلف
أشار المؤلف أنه في سياق الانفتاح الشديد لوسائل التواصل الاجتماعي،صار التعرف على أفكار أي مجموعة من الأشخاص في العالم عبر صفحات الإنترنت أمرا غاية في السهولة ، فدقائق قليلة على مواقع التواصل تحملك من الأفكار التاريخية الشرقية لكونفشيوس في الصين، وبوذا في الهند ، وزرادشت عند الفرس ، إلى الطواطم والطقوس والعادات الأفريقية، إلى المذاهب الإنسانية والوجودية والديانات الوضعية ،إلى الإمبريقية والرواقية والسوفسطائية اليونانية، إلى نيتشه وفرويد وهيجل وماركس ، إلى ديكارت وهولباخ وهيدجر وهيوم وكانط، إلى العدد المهول من التجارب والأفكار البشرية ،كل ذلك في دقائق معدودة.
وأضاف في مقدمته أنه أصبح من لوازم الحياة اليومية أن يحتك الشاب المعاصر بالعديد من التساؤلات الوجودية والأمور المنافية لعقيدته جهارا نهارا، من أخبار وأفلام وقضايا اجتماعية، والكارثة الحقيقية أن هذه التساؤلات تتوالى بشكل شبه يومي على الشاب دون أن تتوفر الإجابات عليها ، وبالتالي يصبح الشاب محملا بكم كبير جدا من التساؤلات المخزنة داخل عقله ، والتي تنتظر لحظة الانفجار ، لتتبين مدى خطورتها ، وهناك عامل رئيسي يزيد الوضع سوءا وهو غياب الدراسة العقدية بين أبناء المسلمين ، وانتشار الجهل والتقليد بشكل لم يعهده المسلمون من قبل ، فأغلب الشباب والفتيات اليوم – بكل أسف – هم مسلمون بالوراثة، وأبسط مسائل التوحيد غابت عن أفهام المسلمين ، ولم يعد يهتم أحد بدراسة العقيدة الإسلامية وأصول الدين ونحو ذلك من دراسات شرعية ، فالشاب أو الفتاة لا يهتم إلا بتحصيل الشواهد والدبلومات، وتضييع الأوقات، واللهو والمرح مع الأصحاب، أما الآباء والأمهات فلا يشغلهم سوى المطعم والمأكل والملبس، وتوفير لقمة العيش ، مع ضمان أكبر قدر من المال وأفضل سكن للأبناء،وكل ما دون ذلك فهو هامشي، لا يولي الأهلون اهتماما يذكر له ، والنتيجة : هي غياب أية أرضية شرعية صلبة للشاب المسلم يستطيع الوقوف عليها عند تعرضه لشبهة من الشبهات، مما يؤدي إلى اهتزاز قناعات الشاب المسلم عند تعرضه لأدنى شبهة حول دينه .
وقام المؤلف بتقسيم كتابه على الشكل التالي:
الفصل الأول بعنوان : ( لماذا نحن هنا ؟ )
وتناول فيه أسئلة البداية المتعلقة بوجودنا كمخلوقات وكبشر قادرين على التفكير والتعقل والتجاوز، وماهية الإنسان وبداية وعلة وغاية وجوده، ووجود الله الخالق المدبر وخلقه للخلق وللنسق الكوني وغايته وموضعنا كبشر فيه، كما استعرض بعض النظريات العلمية التي تحاول البحث في نشأة الكون ، ونشأة الحياة بين المعطيات العلمية المعاصرة والتصور التوحيدي الإسلامي.
أما الفصل الثاني فبعنوان: ( سؤال الشر)
وهو من أخطر الأسئلة التي قد تمر على الإنسان طيلة حياته ، وهو السؤال المتعلق بقسوة الحياة نتيجة للكوارث الطبيعية والحروب والأوبئة والمجاعات والآلام والمعاناة الإنسانية، ولماذا خلق الله النار ولماذا خلقنا كي يعذبنا… إلى آخر هذه الأسئلة ، وقد وقع في هذا السؤال الكثير من اللغط والمغالطات التي أودت بتفكير الكثيرين إلى الهاوية ، سواء في التاريخ الغربي ، أو في واقعنا المعاصر، ولذا فضل المؤلف التفريق بين الأسئلة الوجودية جلها ، وبين سؤال الشر، فخصص له فصلا وحده، وأكد على حسم هذه المسألة بشكل ميسر .
والفصل الثالث والأخير بعنوان : (الإسلام والعلموية)
الذي استعرض فيه مؤلف الكتاب فيه سيرورة العلم الطبيعي بشكل موجز ، ثم تحدث عن فلسفة العلم الطبيعي المعاصر النزعة العلموية في مقابل التصور الإسلامي للوجود والحياة والعلم، ثم ختمه بالحديث حول نظرية التطور الداروينيةوموقف الإسلام منها.
وبعد مقدمته المتصلة، تناول المؤلف مجموعة من القضايا المهمة في فصله الأول وهي على الشكل الآتي :
المسلمة الأولى: أن ثمة معارف إنسانية تسمى بالبدهيات، وهي المقدمات العقلية التأسيسية ، مثل : أن الجزء أصغر من الكل ، أو أن اجتماع الشيء ونقيضه مستحيل ، أو أن لكل معلول علة ، إلى آخر المسلمات البدهية التي لا يشك فيها عاقل ، سواء كانت هذه البدهيات مكتسبة عبر الإدراك الحسي وعملية التعقل منذ ولادة الإنسان وخلال طفولته، أو هي مبادئ فطرية مركوزة في العقل الإنساني بفطرة الله ، ومن أهم الضرورات والبدهيات العقلية التي نقصدها قانون السببية، وقانون السببية معناه:” أنه لاشيء يحدث بلا علة ، أو على الأقل بلا سبب محدد…” ، وهذا القانون تأسيسي وضروري لقيام أية معرفة إنسانية أصلا ، فالعلم بأن كل محدث لا بد له من محدث تساوي علم فطري ضروري.
والمؤلف يتساءل لما تطرح هذه المسلمات من الأساس مادامت في غاية البدهية، فأجاب أنه أحيانا ينحرف العقل البشري ، فيصل إلى مرحلة يكذب فيها هذه البدهيات من الأساس ، فلا يعود يؤمن بأي مبادئ بدهية وأضاف أن الإمام أبو حامد الغزالي وقع في حالة من السفسطة، وظل يشك في كل شيء حتى وصل شكه إلى أبسط قواعد التفكير المنطقي، حتى هداه الله ، وعاد ليؤكد تأسيسية العقل الإنساني على البدهيات، فالمشكل أن العقل الإنساني عندما يصل إلى مرحلة إنكار البدهيات فإنه لا سبيل لإمكان بناء أي معرفة إنسانية على الإطلاق.
المسلمة الثانية: هي أننا هنا بالفعل ، بمعنى أننا إذا كنا نتساءل ( لماذا نحن هنا ؟ ) فإننا نقرر أمرا مسبقا أننا ( هنا ) بالفعل ، أي إن وجودنا هو وجود حقيقي مدرك ، وعلى ما في هذا الأمر من بداهة، إلا أن الانحراف عن الوحي وعن النور الإلهي يؤدي بالعقل الإنساني إلى العجائب ،وعليه فإننا يمكننا القول بأن صلة الموجودات بالمعرفة والإدراك البشري يكون على ثلاث مستويات :
الأول : موجودات يمكن تحصيل المعرفة بها عن طريق الحس المباشر.
الثاني : موجودات غير واقعة تحت الحس المباشر ، مع إمكان العلم بها عن طريق آثارها فيكون للعقل تعلق بإدراكها، ويكون تحصيل العلم بها مركبا من الحس والعقل .
الثالث : موجودات غير واقعة تحت الحس المباشر ، وليس للعقل مدخل في معرفتها لا عن طريق أثر تلك الموجودات ولا بقياسها على موجود آخر ، فهذه الموجودات إن لم يردنا من جهة الخبر الصادق ما يكشف عن وجودها ، فليس ثمة سبيل إلى إدراك هذا الوجود أو العلم به.
وقد اصطلح على تسمية المرتبة الأولى بالمحسوسات، والثانية بالمعقولات، والثالثة بالسمعيات.
وإذا تأملنا حالنا ومعرفتنا بخالقنا تعالى ، فإن ما يتصل بإدراكه قد يكون عائدا إلى المرتبة الثانية أو الثالثة ، فإثبات وجود الله تعالى وأصول كمالاته سبحانه مدركة بالعقل( أي من المعقولات ) ، وله سبحانه وتعالى من الكمالات التي يقف عاجزة عن إدراكها، ولا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الوحي أي من السمعيات.
المسلمة الثالثة والأخيرة : هي أن أخص خصائص الإنسان على الإطلاق ليست في قدرته على حفظ المعلومات ، أو تراكمها، وإنما في قدرته على التجاوز ، أي إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يهتم بالتساؤل عن ( لماذا ؟) ، ولا يكتفي ب ( كيف ؟) ، وهو ما أطلق عليه الفيلسوف الألماني مارتن هيدجر: ” العامل الخالد الأزلي المحدد للوجود الإنساني”.
وبعدها قام المؤلف وبالاستناد إلى هذه المسلمات الثلاث في البدء في طرح التساؤلات والإجابات : لماذا نحن هنا ؟! هل لوجودنا قيمة ؟!
وبعد استعراض فكرة أزلية الكون والنظريات المعاصرة التي حاولت مقاربة ذات الفكرة القديمة بمصطلحات جديدة، وبما أن الاتفاق المعاصر يدور في فلك أن الكون له بداية في الزمان والمكان :” هذه بعض النظريات التي تحاول تفسير تاريخ الكون من منطلق علمي ، وقد رأينا بالتحقيق أن منطلقات هذه النظريات في حقيقتها فلسفية وميتافيزقية لا علمية تجريبية، ولعل الناظر إلى كثرة هذه النظريات يلحظ مدى لا عقلانيتها، يجد أن ثمة شبهتين مشتركتين بين جميع النظريات التي تفسر تاريخ الكون دون الحاجة إلى إله خالق الكون ، وهاتان الشبهتان كما يوردهما الشيخ نديم الجسر هما : ( الأولى : عجز العقول على تصور كنه هذا الإله العظيم الذي ليس كمثله شيء، والثانية : أن عقول الماديين لا يمكن أن تتصور حدوث شيء من لا شيء، أي خلق المادة من العدم )، وما ذلك إلا بسبب تخبط عقول وقلوب الماديين المتشربين للنزعة العلموية التي تعتبر أن التجريب هو المصدر الوحيد للمعرفة وكل ما دون التجريب فلا وجود له ، مما يحيل الملاحدة إلى إنكار الغيب بالكلية ، أو إلى قياس كل ما هو خارج عن الطبيعة بقوانين الطبيعة نفسها، فتضل الأفهام وتكثر الأوهام ، وفي ذلك في إطار نقد الفلسفة المادية لدى أصحاب هذه النزعة العلموية .
وهذه المسألة خصيصا هي ماتجعل كثير من العلماء يؤمنون بوجود خالق للكون رغم عدم علمهم لا بصفات هذا الإله ، ولا حتى بالأديان، كما يقول آلان سانديج(Allan Sandage) أحد رواد علم الفلك :” لا بد أن يكون هناك مبدأ منظم ، الإله بالنسبة لي هو لغز ، ولكن هذا هو التفسير لمعجزة الوجود ، أي لماذا هناك شيء بدلا من لا شيء “.
والقول المنطقي الممكن الوحيد لنشوء الكون ، ويمكننا تلخيص الأمر ببساطة كما لخصه أنتوني فلو ، الملحد المشهور الذي كان رائدا للملاحدة ثم تراجع عن إلحاده في كتابه(( لماذا هناك إله))، كالآتي:
– الكون يحوي موجودات محددة متغيرة.
– هذه الموجودات لا بد لها من موجد.
-لا يمكن التسلسل مع الموجودات التي تحتاج إلى موجد إلى ما لا نهاية ، لذلك ينبغي الإقرار بموجد أول لهذه الموجودات.
هذا الموجد الأول ينبغي أن يكون واحدا ، أزليا ، واجب الوجود ، أي أن وجوده متعين عقلا ، وافتراض عدم وجوده موقع في التناقض، ومن ثم الرأي القائل بنشوء الكون من العدم المطلق نظرا لحدوث مرجح رجحه على العدم هو القول الوحيد المقبول عقلا ، وهذا المحدث ينبغي عقلا أن يكون مفارقا للمادة مما يمكنه من خلق الكون من عدم ، غير مقيد بقوانينها ولا بأبعادها الزمكانية، متعاليا على الكون والمادة.
وفي فصله الثاني : سؤال الشر ، وهو السؤال الأشهر لدى الملاحدة ،والشك الأعظم الذي يتسرب إلى قلوب الشباب المعاصرين ، وهو من أخطر التساؤلات – إن لم يكن أخطرها وأشدها – شيوعا بين الناس، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، ” ومن المحتمل أن يكون سؤال الشر هو أقوى دليل يمكن أن يستحضره الملحد ضد المعتقد الألوهي”، والسؤال ببساطة يطرح عندما يلاحظ الإنسان مدى المعاناة البشرية والكوارث والمصائب التي تعصف بالحياة الإنسانية يوما وراء يوم ، فيبدأ في التساؤل حول هذا الكم المروع من الآلام والأوجاع ومدى علاقة الإله به .
وتتميز حسب الكاتب مشكلة الشر عن جميع أسئلة الإلحاد بأنها : ” لا تطيب نفسا بجواب واحد سريع ، فالتفصيل فيها واجب ، والتأني في العرض والنقد حتم ، خاصة أنها قائمة في الغالب على القرائن لا على الدلائل المباشرة “.
إذ إن الإسلام يقدم طرحا متسقا ومنسجما مع العقل الصريح والنقل الصحيح ، وعرض إجابات المسألة بين ثنايا نصوص الشريعة بكل موضوعية واتساق، ملخصها : إن أفعال الله كلها خير ، وإنه – تعالى- لا يفعل شيئا إلا لحكمة ، والشر الطبيعي(غير الناتج عن الفعل الإنساني) له حكمة غائية لا يستقيم وجود الإنسان إلا بوجودها، سواء علم الإنسان هذه الحكمة أم لا ، أما الشر الإنساني( الناتج عن الفعل الإنساني) فالسبب فيه هو الإنسان ، ولا يمكن إزالة الشر الإنساني لأن زواله يعني زوال الإرادة الإنسانية بالكلية، ومن ثم لم يجد علماء أهل السنة حاجة للالتفاف والاختراع والابتداع، بل كانت المؤلفات في هذا الموضوع شديدة الندرة في التاريخ الإسلامي عند أهل السنة خصوصا ، نظرا لغياب المشكلة أصلا.
وإن الشر الموجود في العالم ينقسم إلى نوعين :
الأول : شر طبيعي خارج عن الإمكان الإنساني ، فلا مجال للإنسان فيه ، كالزلازل والبراكين والأوبئة والعواصف ونحو ذلك.
الثاني : الشر الناتج عن التدخل الإنساني وفعله الأخلاقي ، وعلى رأسه الحروب والمجاعات والفقر ونحوه.
والجواب على الإشكال يمكن إجماله في ثلاث نقط :
الأول : الشر الطبيعي والشر الإنساني : ما معيار الشر؟!
ثمة سؤال يجب أن نطرحه أولا ، وهو : من يحدد أن هذه الأمور هي شر من الأساس ؟! بمعنى أنه ليس هناك مقياس محدد لقياس وحدة الشر ، فالشر وصف وليس (وجود) قائم بذاته ، ومن ثم فإن مفهوم الشر نفسه مفهوم نسبي يختلف من إنسان لآخر ، فما يراه إنسان شرا يعتبره آخر خيرا ، وما يراه إنسان خيرا قد يعتبره آخر شرا.
وعلى هذا الأساس تظهر المشكلة الكبرى : فمن يخوض في سؤال الشر دون الرجوع إلى الإله ومعيارية الوحي معتبرا أن الإنسان هو مركز الكون ، فإنه لا محالة سيقع في حالة نسبية وسيولة دائمة لن يستطيع من خلالها أن يجزم أبدا بوصف الشر ( أو الخير ) لأي موجود من الموجودات حتى في تلك الأمور التي يظن الناس أنه لا اختلاف عليها، فالأوصاف والأحكام القيمية تتباين بتباين وجهات النظر ، والإشكال الأكبر لدى الملحد هو افتقاره لمرجعية نهائية مطلقة يمكن الرجوع إليها حال الاختلاف في وجهات النظر القيمية، ومفهوم النسبية وفقا للملحد { يعد – من ناحية منطقية – متماسكا لا سبيل إلى دحضه}.
وأما الفصل الثالث والأخير : الإسلام والعلموية
ونقصد بالعلموية Scientism أي الاتجاه إلى حصر مصادر المعرفة وطرائق الاستدلال في المشاهدة والملاحظة والإدراك الحسي والتجربة فحسب ، فيصبح التجريب هو باب المعرفة الوحيد والمقدس الذي يتعالى على كافة الآراء بما في ذلك الوحي ذاته ! وهذه النزعة العلموية ليست وليدة اليوم ، بل هي نتاج سردية كبرى منذ وضع أسسها فرنسيس بيكون في القرن السادس عشر ، فتطورت في السياق التاريخي حتى صارت هي المذهب الحاكم للأوساط العلمية في الغرب كونها الأصل الذي يتفرع منه جميع النظريات والآراء العلمية والصراعات المزعومة مع الدين.
إن أغلب المسلمين- وقل : البشر – يتخيلون أن العلم التجريبي الذي يقدمه الغرب هو قيمة مجردة سامية ( حيادية ) غير ممكن تحريفها أو تدليسها، لأنها تعتمد على التجارب والأبحاث العلمية ( المعتمدة ) النهائية، فكأن العلم الذي يأتي من الغرب قد أضيفت له هالة من القداسة تمنعه من المسائلة أو التشكك أو وضعه في محل النقد والنظر، فقط لأنه (علم ) ، ففي اللحظة التي يشكك فيها أحد في ماهية العلم ذاته، أو يقلل من قيمة فلسفته أو منهجيته ، حتى تنهال عليه فورا سيول الاتهامات والشتائم والأوصاف العجيبة من رجعية وجاهلية وظلامية… إلخ.
والحقيقة : إن العلم التجريبي الذي يتم تصديره لنا – وللعالم- على أنه قمة العقلانية والحيادية والتنوير، وذروة النزاهة والموضوعية، هو في حقيقته معرفة إنسانية – كغيرها من المعارف- يمكن استيعابها داخل الأنساق المعرفية الغربية ككل التي تقوم على فلسفة وضعية تنتج ما تنتج من معارف وقيم ونحو ذلك ، ويتأثر العلم في هذا النسق بالأهواء الشخصية ، والتقلبات النفسية ، والظروف السياسية ، والأحوال الاقتصادية، وبتحكم اللوبيهات في أعيانه ومخرجاته ومؤسساته، شأنه كشأن أي نشاط بشري تاريخي.
لذلك فإن أي تصور يضع العلم التجريبي الغربي بشكل مستقل خارج سياقه الظرفي من حيث أصول النشأة والتكوين والأهداف فهو تصور غلط تماما ، فنحن نستطيع أن نقسم الأطوار العلمية الغربية إلى ثلاثة مراحل :
* مرحلة ما قبل النهضة ( العصور اليونانية والكنيسة )
* مرحلة النهضة ( الفيزياء الكلاسيكية، الحتمية)
* المرحلة المعاصرة ( اللاحتمية)
وفي كل مرحلة فإننا سنجد أن العلم كمعرفة إنسانية يختلف تعريفه، وموضوعاته، وإسقاطاته الدينية والسياسية، وأهدافه، ومناهجه، في كل مرحلة على حدة.
وحول عدم إطلاقية أو حيادية العلم الغربي وارتكازه بشكل أساس على الأهواء المتقلبة دعما للفلسفة المادية وهيمنتها، فإن أحد أبرز التوجهات التي يعمل كثير من الغربيين والملاحدة على التبشير بها هي نظرية التطور ، فما من علموي أو ملحد أو مبشر بالنظرية إلا ويصرح بكل ثقة أن قضية التطور ليست نظرية ، وإنما هي حقيقة واقعة لا تختلف عن القول بأن الواحد نصف الاثنين!
فخلاصة الأمر أن التطوريين لم يستطيعوا تقديم تفسير عقلاني واحد لنشوء الخلق ، وكذلك لم يقدموا تفسيرا واحدا مقبولا لظهور الحياة ، بل واعترف كثير منهم بأنه من غير الممكن الوصول علميا لنظرية تفسر هاتين النقطتين، ومع ذلك تمسك التطوريون بالفلسفة المادية وأسبقية المادة على كل شيء بما في ذلك الإنسان والحياة ، ثم قدم التطوريون- هكذا – افتراضا لا يرتقي لدرجة النظرية العلمية في كثير من الأحيان، وزوروا وكذبوا ودلسوا وقمعوا من أجل إثبات افتراضهم، وبعد ذلك يأتي أحدهم ليقول : إن العلم هو المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ! والمصيبة أنك تجد من المسلمين من يردد هذه المزاعم دون أدنى دراية منه لا بالدين الإسلامي ولا بنظرية التطور ، والأنكى من يحاول أن يلوي عنق النصوص الشرعية من أجل الانصياع لسلطة الثقافة الغالبة.
وختاما، نجد في هذا الكتاب استعراض أشهر الأسئلة الوجودية في حياة البشر، حيث يتجول بنا الكاتب بين أجوبة تلك الأسئلة لنصل في النهاية إلى السبب الحقيقي للوجود، متناولا في أطروحته الإجابة عن أسئلة الحكمة والقضاء والقدر ووجود الشر والابتلاء، وكذلك القول بتطور الكائنات الحية وتطور الإنسان، موضحا أسباب تفرد الدين الإسلامي عن باقي الأديان، تاركا الحكم النهائي للقارئ الكريم الذي يبحث عن الحق.



