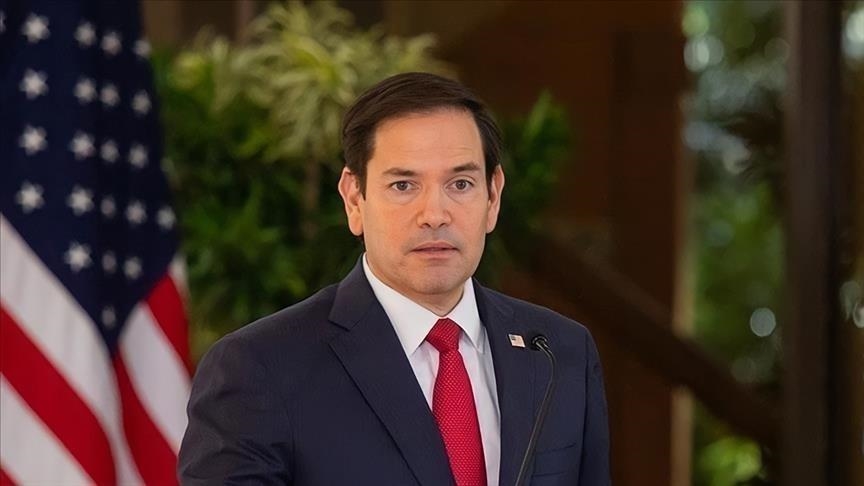الدين بين نور العقل وظلام الجهل: قراءة في أزمة الوعي الإسلامي المعاصر

الشيخ الصادق العثماني ـ أمين عام رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية
ليس الدين، في جوهره العميق، خطابًا للغياب، ولا دعوة إلى الانسحاب من الحياة، ولا مشروعًا لإطفاء نور العقل في الإنسان، بل هو في أصله نداء يقظة، ورسالة حياة، وجسر ممتد بين السماء والأرض، يربط القلب بالحكمة، والعقل بالمعنى، والوجود بالغاية.
لقد جاء الإيمان ليوقظ في الإنسان دهشته الأولى، وليفتح أمامه أبواب السؤال، وليمنحه القدرة على النظر إلى الكون لا بعين العادة، بل بعين التأمل، ولا بروح الخوف، بل بروح الثقة والبحث.
منذ اللحظة الأولى لنزول الوحي، كان النداء موجّهًا إلى القراءة، إلى المعرفة، إلى اكتشاف الأسرار المودعة في النفس والآفاق. لم يكن «اقرأ» أمرًا عابرًا، بل كان إعلانًا عن هوية هذا الدين: دين يتأسس على الوعي، ويتغذّى من الفهم، وينمو في فضاء التفكير. فالإيمان في الرؤية الإسلامية ليس قفزًا في المجهول، بل رحلة في المعنى، ولا هو استسلام أعمى، بل مشاركة واعية في سر الوجود.
غير أن مسار التاريخ، بما فيه من تحولات وتعقيدات، جعل هذا المعنى يتعرض أحيانًا للغبار، فتراكمت على جوهر الدين طبقات من العادة والتقليد، وغابت عنه في بعض الفترات روحه المتوثبة، فصار يُمارس أحيانًا بوصفه طقسًا لا رسالة، ومظهرًا لا تجربة، وصوتًا خارجيًا لا حوارًا داخليًا. وهنا بدأت المسافة تتسع بين الإيمان كما يُفترض أن يكون، والإيمان كما يُعاش في الواقع.
حين ينفصل الدين عن العقل، يفقد شيئًا من نوره، وحين يُعزل عن الحياة، يفقد شيئًا من دفئه، وحين يُختزل في قوالب جامدة، يفقد قدرته على التجدد. فالإيمان الذي لا يمر عبر الفهم يتحول إلى عادة، والذي لا يختبر في الواقع يتحول إلى شعار، والذي لا يرافقه سؤال يتحول إلى صمت داخلي طويل. وليس في هذا ما ينسجم مع روح الإسلام التي جعلت التفكر عبادة، والتدبر طريقًا، والتأمل جسرًا نحو اليقين.
لقد خاطب القرآن الإنسان بوصفه كائنًا عاقلًا، قادرًا على التمييز، مؤهلًا للاختيار، مسؤولًا عن مصيره. دعاه إلى النظر في النجوم، وفي تعاقب الفصول، وفي تقلب الأحوال، وفي مصائر الأمم، لا ليحفظ هذه المشاهد في ذاكرته، بل ليحوّلها إلى حكمة، وإلى وعي، وإلى بصيرة. فالدين في هذا المنظور ليس مجموعة أوامر ونواهٍ، بل مدرسة كبرى لتكوين الإنسان.
غير أن بعض صور التدين، عبر الزمن، مالت إلى السكون بدل الحركة، وإلى التكرار بدل الإبداع، وإلى الاكتفاء بالموروث بدل مساءلته. فصار كثيرون يكتفون بحفظ النصوص دون الغوص في معانيها، ويرددون الأقوال دون استحضار سياقاتها، ويتمسكون بالقوالب دون الالتفات إلى المقاصد. وهكذا ضعفت العلاقة الحية بين الإنسان والدين، وتحولت أحيانًا إلى علاقة شكلية، تقوم على العادة أكثر مما تقوم على الوعي.
وحين يغيب السؤال، يبهت المعنى، وحين يخفت الحوار، يضيق الأفق، وحين يُخشى الاختلاف، تتجمد الأفكار. فالإيمان الذي لا يحتمل التعدد في الفهم، ولا يفسح مجالًا للاجتهاد، يتحول إلى بناء هش، يخاف من الرياح بدل أن يتقوّى بها. وقد علّمنا تاريخ الفكر الإسلامي أن أعظم فتراته كانت تلك التي تجرأ فيها العقل على التفكير، وانفتح فيها القلب على الحكمة، والتقى فيها الوحي بالفلسفة، والفقه بالعلم، والروح بالمنطق.
لم يكن علماء الإسلام الكبار يرون في العقل خصمًا للنص، ولا في السؤال تهديدًا للإيمان، بل كانوا يعتبرون التفكير ضربًا من العبادة، والبحث طريقًا إلى الطمأنينة. كانوا يدركون أن الحقيقة لا تخاف من النور، وأن اليقين لا يرتجف أمام الأسئلة، وأن الإيمان الراسخ هو الذي يمر عبر التجربة والمعاناة والتأمل.
وفي المقابل، فإن التدين الذي يكتفي بالمظاهر، ويغفل الجوهر، يفرغ الروح من معناها، ويجعل العبادة عادة بلا حرارة، والدعاء كلمات بلا حضور، والالتزام قيدًا بلا محبة. فليس المقصود من الصلاة حركة الجسد، بل يقظة القلب، وليس المقصود من الصيام الجوع، بل تهذيب الرغبة، وليس المقصود من الأخلاق الانضباط الظاهري، بل الصفاء الداخلي.
إن جوهر الأزمة التي يعيشها الوعي الديني اليوم ليس في قلة النصوص، ولا في ضعف التراث، بل في ضعف القراءة، وغياب المصاحبة العميقة للمعنى. نقرأ كثيرًا، لكننا نتأمل قليلًا، نسمع كثيرًا، لكننا نصغي نادرًا، نحفظ كثيرًا، لكننا نعيش قليلًا. ولذلك يبدو الدين أحيانًا بعيدًا عن أسئلة الإنسان المعاصر، لا لأنه عاجز عن الإجابة، بل لأننا لم نحسن الإصغاء إليه.
إن استعادة الإيمان لفاعليته الروحية والإنسانية تبدأ من إعادة الاعتبار للعقل بوصفه هبة إلهية، وللقلب بوصفه موطن النور، وللضمير بوصفه ميزان السلوك. تبدأ من تربية الإنسان على الصدق مع ذاته، وعلى الشجاعة في السؤال، وعلى التواضع في المعرفة، وعلى السعي الدائم إلى الفهم الأعمق.
كما تبدأ من تحويل التدين من ممارسة فردية منعزلة إلى تجربة أخلاقية شاملة، تنعكس في الصدق، والعدل، والرحمة، والإتقان، والجمال. فالدين لا يُقاس بكثرة الشعارات، بل بعمق الأثر، ولا يُعرف بضجيج الخطاب، بل بسكينة السلوك، ولا يُثبت بالجدل، بل بالقدوة.
في النهاية، يظل الإيمان رحلة مفتوحة، لا محطة نهائية، ومسارًا متجددًا، لا قالبًا ثابتًا. رحلة من الظاهر إلى الباطن، ومن الحرف إلى الروح، ومن التقليد إلى الوعي، ومن الخوف إلى المحبة. وحين يستعيد الدين صوته الداخلي، ويتصالح مع العقل، ويتجدد في ضمير الإنسان، يعود كما أراده الله: نورًا يهدي، لا ظلًا يُربك، وطمأنينة تبني، لا سكونًا يميت، ورسالة حياة، لا مجرد ذكرى في الذاكرة.