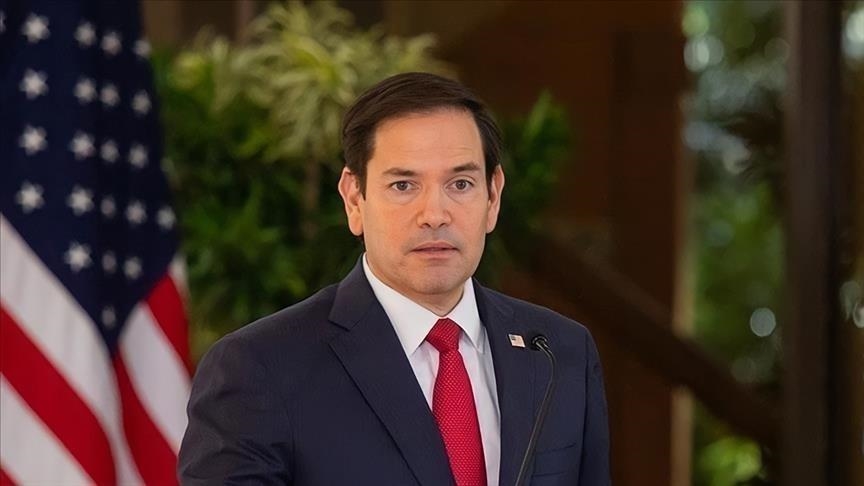البيعة المغربية: استثناء المسار وخصوصية النموذج

د حمزة مولخنيف
ليست البيعة في التجربة المغربية مجرّد إجراء سياسي أو طقس بروتوكولي يتكرّر مع تعاقب العصور، بل هي بنية رمزية كثيفة، ومؤسسة حضارية عميقة الجذور، تختزن في طبقاتها المتراكبة معنى الشرعية ووظيفة الاجتماع وذاكرة الدولة وأخلاق السلطة. إنها صيغة مخصوصة من التعاقد بين الحاكم والمحكوم، تستمد مادتها من الفقه وتغتني من التاريخ وتتشكّل عبر العرف، وتتحقق في الواقع بوصفها فعل استمرارية جماعية لا ينفصل فيه السياسي عن الديني ولا القانوني عن الرمزي.
فالبيعة المغربية ليست نسخة مستنسخة من نماذج المشرق، ولا استنساخا للثيوقراطيات الأوروبية، بل هي ثمرة تفاعل طويل بين المرجعية الإسلامية المالكية الأشعرية، والتقاليد السلطانية المغربية، والبنية الاجتماعية القائمة على الوساطة العلمية والقبلية والزوايا، مما جعلها نموذجا خاصا في مسار تشكّل الدولة الإسلامية الحديثة.
ومن هنا، فإن الحديث عن البيعة في المغرب لا يستقيم إلا بوضعها داخل أفق فلسفي تاريخي، يرى في السلطة تعبيرا عن حاجة الجماعة إلى الوحدة، وفي الشرعية تجلّيا لتوافق القيم، وفي إمارة المؤمنين صورة مركّبة لوظيفة التحكيم الرمزي بين الدين والدولة.
لقد نبّه ابن خلدون مبكرا إلى أن “الملك لا يقوم إلا بالعصبية”، غير أنه أضاف بوعي عميق بطبائع الاجتماع، أن العصبية وحدها لا تكفي ما لم تُصبغ بصبغة الشرع، لأن “الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية”. وهذه الملاحظة الخلدونية المفتاحية تجد ترجمتها التاريخية الأوضح في التجربة المغربية، حيث لم تُبن الدولة على السيف وحده، ولا على النسب وحده، بل على اجتماع البيعة الشرعية والنسب النبوي والقبول الاجتماعي والوساطة العلمية.
فالبيعة في المغرب لم تكن يوما إجراءً مفروضا من أعلى، بل كانت فعل رضى جماعي، يتم عبر العلماء والأعيان وأهل الحل والعقد، في لحظة تشاركية تتأسس على الاعتراف المتبادل بين الأمة وإمامها. يقول الماوردي في “الأحكام السلطانية”: “الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا”، وهو تعريف يختصر جوهر الوظيفة السياسية في الإسلام، لكنه لا يشرح كيف تتحقق هذه الخلافة في الواقع. أما المغرب فقد قدّم جوابا عمليا على هذا السؤال عبر مؤسسة البيعة.
إذا كان الفكر السياسي الإسلامي قد ظلّ في كثير من تجلياته النظرية حبيس التنظير المعياري، فإن المغرب اشتغل على تحويل هذا التنظير إلى ممارسة تاريخية مستمرة. فالبيعة هنا ليست مجرد مفهوم فقهي، بل مؤسسة حية، أعيد إنتاجها عبر القرون، وتكييفها مع تحولات الزمن دون أن تفقد جوهرها.
لقد كتب عبد الله العروي في سياق تحليله لبنية الدولة المغربية، أن “المغرب لم يعرف قطيعة جذرية مع تقاليده السياسية، بل عرف تراكبا بطيئا بين القديم والجديد”. وهذه الملاحظة الدقيقة تفسّر لنا كيف استطاعت البيعة أن تعبر من العصور الوسيطة إلى الدولة الحديثة، محافظة على معناها الرمزي، ومتكيفة مع مقتضيات الدستور والمؤسسات.
فالبيعة المغربية ليست لحظة ماضوية جامدة، بل هي دينامية تاريخية. إنها بتعبير بول ريكور، “ذاكرة فاعلة”، أي ذاكرة لا تُستعاد بوصفها أثرا، بل بوصفها قوة تنظيمية للحاضر. ولذلك ظلّ فعل البيعة يتجدّد، وتتجدد معه معاني الطاعة المشروطة، والولاء المؤسس على الحق، والسلطة المرتبطة بالمسؤولية.
وقد أجمع فقهاء المالكية منذ القاضي عياض إلى الونشريسي، على أن الإمامة عقد رضائي، لا يصح إلا برضا الأمة أو ممثليها. يقول القاضي عياض في “الشفا”: “انعقد الإجماع على وجوب نصب الإمام، وأن ذلك فرض كفاية على المسلمين”. لكنه يضيف في موضع آخر أن هذا النصب لا يكون إلا عبر أهل الحل والعقد، بما يجعل البيعة فعل مشاركة لا إذعان.
وفي المغرب، اضطلع العلماء بدور محوري في هذا المسار. فلم يكونوا مجرد موقّعين على البيعة، بل كانوا حراس مشروعيتها، ومراقبين أخلاقيين للسلطة. وقد سجّل المؤرخون كيف كانت البيعات تُقرأ في المساجد الكبرى وتُدوّن في ظهائر رسمية وتُبارك من الزوايا في مشهد جامع يجمع بين الشرع والعرف وبين النص والسياق.
ويكفي أن نستحضر بيعة المولى إدريس الأول، التي اعتبرها الناصري في “الاستقصا” لحظة تأسيسية للدولة المغربية، حيث التقت إرادة القبائل الأمازيغية مع الشرعية النبوية، في تركيب فريد أنتج أول دولة إسلامية مستقلة في الغرب الإسلامي. لقد كتب الناصري: “فبايعه أهل وليلي ومن حولها، وكانت تلك البيعة أصل الملك بالمغرب”.
ومنذ تلك اللحظة، ظل النسب الشريف عنصرا مركزيا في شرعية الحكم، ليس بوصفه امتيازا سلاليا، بل باعتباره رمزا لوحدة الأمة حول بيت النبوة. وقد عبّر ابن خلدون عن هذا المعنى حين قال: “الناس أسرع إلى الانقياد للبيت النبوي لما جعل الله في القلوب من محبته”.
غير أن هذا النسب لم يكن كافيا وحده، بل كان دائما مشروطا بالعدل وحفظ الدين ورعاية المصالح. ولذلك نجد في نصوص البيعة المغربية القديمة بنودا واضحة تذكّر السلطان بواجباته، إقامة الشرع وحماية الثغور وإنصاف المظلوم وصيانة الأمن ورعاية العلماء.
وهنا تتجلّى خصوصية النموذج المغربي، البيعة ليست تفويضا مطلقا، بل عقد أخلاقي. إنها بلغة الفلسفة السياسية الحديثة، صيغة مبكرة من “العقد الاجتماعي”، وإن كانت متجذرة في المرجعية الإسلامية. وقد لاحظ محمد عابد الجابري أن “البيعة في الفكر السياسي الإسلامي تقوم مقام الانتخاب في النظم الحديثة مع فارق السياق والأدوات”.
وإذا كانت أوروبا قد احتاجت إلى قرون من الصراع بين الكنيسة والملكية لإنتاج الدولة الحديثة، فإن المغرب اختار مسارا آخر، قوامه التوفيق بين السلطتين، تحت سقف إمارة المؤمنين. وهذا ما جعل الدولة المغربية تتفادى كثيرا من الانقسامات اللاهوتية والسياسية التي عرفها الغرب.
لقد كتب أرنولد توينبي أن الحضارات التي تنجح هي تلك التي تعرف كيف تستجيب لتحدياتها دون أن تفقد ذاتها. والمغرب في حفاظه على مؤسسة البيعة، قدّم مثالا نادرا على هذا التوازن بين الأصالة والتحديث. فالبيعة اليوم تُمارس في إطار دستوري، وتُقرأ بلغة الدولة الحديثة، لكنها تحتفظ بروحها الرمزية وتستبطن معنى القيادة الدينية الجامعة. وهي بهذا المعنى ليست بقايا ماضٍ، بل مورد استقرار.
ويكفي أن ننظر إلى محيط إقليمي مضطرب، لنفهم قيمة هذا الاستثناء المغربي. فحيث تفككت الدول، وتنازعت الشرعيات، ظل المغرب متماسكا حول مؤسسة إمارة المؤمنين، بوصفها نقطة ارتكاز للهوية الوطنية، وضامنا للسلم الأهلي.
وقد لخّص الملك الراحل الحسن الثاني هذه الفلسفة بقوله: “إمارة المؤمنين ليست تاجا على الرأس، بل مسؤولية في القلب”. وهي عبارة تختزل البعد الأخلاقي للسلطة في التصور المغربي.
إن البيعة المغربية ليست مجرد تقليد، بل صيغة حضارية لإدارة المقدس في المجال العام، وضبط العلاقة بين السلطة والشرعية، وبين الدولة والمجتمع. إنها ذاكرة سياسية حيّة ورافعة استقرار وأفق تأويلي مفتوح.
إننا حين نغوص في عمق تجربة البيعة المغربية، نكتشف أن ما يميزها ليس مجرد شكل الطقس السياسي أو النصوص القانونية، بل طبيعة العلاقة التي تقيمها بين الحاكم والمحكوم، وهي علاقة تحمل في طياتها حساسية أخلاقية ورمزية، وتجسّد محاولة متفردة لمزج السياسة بالدين، والاستمرارية بالتغيير، والتقاليد بالحداثة. إن هذه الدينامية تجعل من المغرب نموذجا فريدا في العالم الإسلامي، نموذجا يجمع بين الشرعية الدينية والقبول الاجتماعي واستجابة التاريخ للتحديات المعاصرة.
لقد شدد ابن خلدون على أن الدولة تقوم على العصبية والشرعية، ولكنه أشار بعمق إلى أن الشرعية وحدها لا تكفي إذا غاب عنها الاعتراف الاجتماعي والمصلحة الجماعية. المغرب في مؤسسته للبيعة، قد أدرك هذه الحقيقة منذ البداية. فالإمام أو السلطان في المغرب ليس مجرد حامل للسلطة، بل هو ضامن للمعايير الأخلاقية، ومرجعية للهوية المشتركة، وشاهد على التوافق بين النص والواقع، بين المشروع الديني والضرورة السياسية. يقول الماوردي: “الإمامة موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا”، لكن المغرب أضاف لهذه النظرية بعدا عمليا تجسّد في المشاركة المجتمعية، وفي إشراك العلماء والأعيان في نصاب التمثيل الشرعي.
إن القراءة الفلسفية للبيعة المغربية تتطلب فهمها بوصفها عقدا رمزيا، وليس مجرد إجراء شكلي. فهي تمثل التزاما أخلاقيا متبادلا، يلتزم الحاكم بالعدل وحماية الدين وتحقيق المصلحة العامة، ويلتزم المحكوم بالولاء المشروط بالحق والعدل. وهذا ما يفسر استمرارية هذه المؤسسة عبر قرون، رغم التحديات الداخلية والخارجية، ورغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ورغم المد السياسي الحداثي والتدخلات الاستعمارية.
فالبيعة ليست مجرد إرث تاريخي، بل أفق تأويلي مفتوح، يتيح إعادة قراءة الشرعية والسيادة، ويؤسس لنموذج سياسي قابل للتكيف، دون أن يفقد جوهره. وقد لاحظ محمد عابد الجابري أن “البيعة في المغرب تجسّد العقل العملي للتاريخ، لا مجرد النقل النمطي للموروث الشرعي”. وهذا يضع المغرب في موقع استثنائي بين التجارب الإسلامية، إذ استطاع أن يحافظ على أصالته، مع إدراك مقتضيات العصر الحديث.
إن الاستثناء المغربي يتجلى أيضا في أن البيعة لم تُنقل إلى مرحلة الدولة الحديثة بوصفها مجرد طقس احتفالي، بل أُدرجت في نصوص دستورية، وحافظت على روحها الرمزية، فتظل صلة وصل بين التاريخ والحاضر. وفي هذا الصدد، كتب عبد الله العروي: “المغرب لا يعرف قطيعة جذرية مع الماضي، لكنه يعرف كيفية إدماج القديم في الجديد بطريقة تحافظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي”.
إن هذا الجمع بين الأصالة والتحديث يجعل البيعة المغربية قابلة للتأويل، وتستوعب مطالب الإصلاح، وتتيح للحاكم أن يتجدد في وعيه، وللمجتمع أن يشارك في ضبط العلاقة بين السلطة والحق، وبين الدولة والمجتمع المدني. وهنا نلمس البعد الأخلاقي والرمزي، فالبيعة ليست تفويضا مطلقا، بل ميثاق استمرارية والتزام جماعي، يحمي الأمة من الفوضى ويؤسس لوحدة متماسكة.
ومن زاوية فلسفية، يمكننا أن نربط هذا النموذج بمفهوم العقد الاجتماعي الحديث، كما طرحه روسو أو هوبز، لكن مع فارق جوهري، فالمغرب لا ينفصل العقد عن الدين، ولا السياسة عن الشرعية، بل يدمجها ضمن أفق الفضيلة العملية، الذي يجعل السلطة مسؤولة أمام قيم العدالة والحق، والمجتمع ملتزما بالولاء المؤسس على الاعتراف بالشرعية الحقيقية، لا على القوة وحدها.
رغم النقد الموجه أحيانا، تحمل “البيعة المغربية” بعدا إصلاحيا، إذ تؤسس علاقة متبادلة بين السلطة والحق، وتمكّن المجتمع من التأثير على ممارسة الحكم عبر القيم والممارسات الشرعية. وهذا ما يفسر قدرة المغرب على الصمود أمام موجات الفوضى السياسية التي اجتاحت محيطه الإقليمي، واستمرار المركزية السلطوية مع تقيدها بالمرجعية الدينية والاجتماعية.
إذا أمعنا النظر في التاريخ المغربي، نجد أن كل مرحلة انتقالية في السلطة كانت ترافقها مراسم بيعة دقيقة، يشترك فيها العلماء والأعيان وأهل الحل والعقد، ويعلن فيها سلطان جديد عن التزامه بالعدل وحماية الدين ورعاية الأمة. وهذا ليس مجرد تقليد، بل آلية لضبط العلاقة بين القوة والحق، وبين الإرادة الفردية والإرادة الجماعية.
لقد عبّر المؤرخون كالناصري والمشرفي والضعيف الرباطي وغيرهم عن هذا المعنى بوضوح، مشيرين إلى أن البيعة كانت دائما شرط استمرار الدولة، وأن الشرعية الدينية لم تكن منفصلة عن الاعتراف الاجتماعي، وأن النسب الشريف مهما كان رمزيا، لا يضمن الاستمرارية إلا إذا اقترن بالعدل والوفاء بالواجبات.
من زاوية تحليلية أخرى، يمكن أن نرى أن البيعة المغربية تمثل نمطا من التوازن الرمزي بين السلطات، إذ تجعل من الحاكم ليس مجرد منفذ للقوانين، بل حاملاً لمشروع اجتماعي وأخلاقي. وهنا يلتقي الفكر الإسلامي التقليدي مع الفلسفة السياسية المعاصرة، فكما لاحظ هابرماس، أن الشرعية السياسية تتطلب توافقا بين النظام والقيم الاجتماعية، وبين المؤسسات والوعي الأخلاقي للمجتمع، والمغرب قد طبق هذا المعنى منذ قرون عبر مؤسسته للبيعة.
وإذا نظرنا إلى المقارنة الإقليمية، نجد أن المغرب استثناء حقيقي. ففي كثير من الدول الإسلامية، أدى غياب إشراك العلماء والأعيان في عملية الاعتراف بالسلطة إلى انقسامات وفقدان الشرعية، وإلى صراعات طويلة حول الخلافة أو الإمامة. أما المغرب، فقد حافظ على وحدة رمزية، وجعل من البيعة ضمانا للاستقرار، ومن إمارة المؤمنين أفقا مشتركا يلتقي فيه التاريخ بالدين، والسياسة بالقيم.
إن البيعة المغربية هي تعلم تاريخي مستمر، إذ تمنح الحاكم فرصة لإدراك التحديات الأخلاقية والسياسية، وللمجتمع فرصة لتفعيل دوره في الرقابة الرمزية على السلطة. فهي ليست مجرد صكّ شرعي، بل أداة لإنتاج الدولة الواعية بنفسها، دولة تستند إلى المرجعية، ولكنها متفتحة على التغيير والتحديث.
كما أن الاستثناء المغربي يظهر في أن البيعة لم تغلق الباب أمام الإصلاحات، بل كانت مرنة، تستوعب التغييرات السياسية والاجتماعية، دون أن تفقد جوهرها. وهو ما يجعلها مؤسسة دينامية قادرة على الاستمرار، ورافعة للشرعية في ظل التحولات الكبرى.
وفي ضوء هذا كله، فإننا نستطيع أن نفهم البيعة المغربية بوصفها قيمة مركّبة: قيمة دينية، وقيمة سياسية، وقيمة رمزية، وقيمة أخلاقية، تجمع بين الماضي والحاضر، وبين النص والواقع، وبين المجتمع والحاكم، وتؤسس لنموذج فريد، لا يقلل من أهمية التاريخ، ولا يتجاهل مقتضيات العصر.
البيعة المغربية ليست مجرد طقس شكلي للدولة، ولا نصا فقهيا جامدا، بل تجربة حضارية فريدة، تمثل امتدادا تاريخيا طويلا لمؤسسة إمارة المؤمنين. وهي تكشف قدرة المغرب على الجمع بين الأصالة والمرونة وبين الشرعية الدينية والاعتراف الاجتماعي، وبين التقاليد والثيمات المتجددة للحكم والمجتمع.
إنها عقد أخلاقي وميثاق رمزي، وأداة تاريخية للاستقرار، ونموذج سياسي قائم على الاعتراف المتبادل، ووعي جماعي بالمسؤولية. فالبيعة المغربية كما بين ابن خلدون والماوردي والقاضي عياض هي أساس الشرعية ووسيلة لتكريس العدالة، وتأكيد دور العلماء والأعيان في ضبط ممارسة السلطة، وضمان التوازن بين القوة والحق.
وهي كذلك درس حضاري عميق: يعلّم أن الشرعية السياسية لا تُبنى على القوة وحدها، ولا على النسب وحده، بل على التوافق بين السلطة والقيم وبين الحاكم والمحكوم وبين الدين والسياسة. وأن التاريخ حين يُستثمر بحكمة، يمكن أن يصبح أداة للتماسك، ورافعة للاستقرار، وأفقا لإعادة إنتاج النموذج السياسي بطريقة تراعي الأصالة، لكنها متفتحة على المستقبل.
وفي عصرنا الراهن، حين تتعرض التجارب السياسية للاهتزاز، ويبحث العالم عن طرق للتوازن بين السلطة والحق والشرعية والديمقراطية، فإن التجربة المغربية تقدم مثالا حيا على كيفية الاستمرار دون الانقطاع، والتجديد دون فقدان الجوهر. إنها بيعة تحمل معنى الإنسانية المشتركة، ومضمون المسؤولية الجماعية، ورمز الاستثناء التاريخي، استثناء يجمع بين الروح والممارسة وبين الدين والسياسة وبين القيم والتاريخ.
وبذلك يمكن اعتبار البيعة المغربية حافظة للذاكرة، ومستودعا للأخلاق، ومنارة للتجربة السياسية التي لم تعد مجرد إرث، بل أداة حيّة لفهم السلطة، وضمان استمرارية الدولة، ومصدراً لإعادة قراءة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين الشرعية والتاريخ، وبين القانون والرمزية. إنها فعل وعي جماعي، وعقد حضاري متجدد، وتجربة إنسانية متفردة في سياق العالم الإسلامي.