أعمال كانط من منظور المفاتيح القرآنية
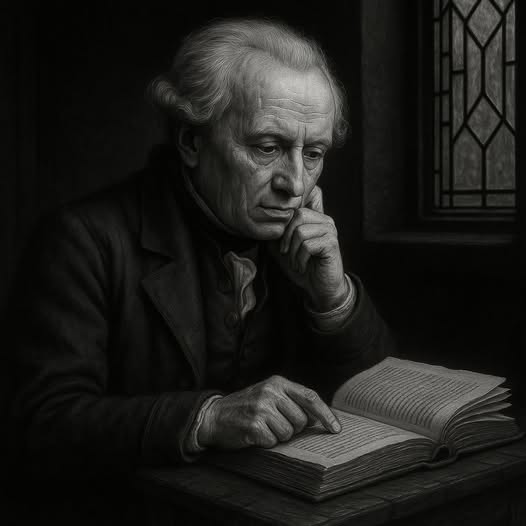
طارق هنيش
نقرأ أعمال كانط لا على جهة الاستقلال النظريّ الصرف، بل مندمجًا في سبكٍ تأويليٍّ تتداخل فيه أنوارُ الوحي بظلالِ الفكر النقدي، إذ نستعين في تفهّم مذهبه بناموس المثنوية القرآنية المنبثقة من قسمةِ النفس إلى مزكّاة ومدسّاة، ونردّ مفهوماته إلى مراتب الوجود وتغايرات النفس ومقاماتها، متوسّلين بما بين المخيّلة والنفس من نَسَبٍ وجوديٍّ وثيق، حيث إنّ الاتصال بينهما ليس عرضًا طارئًا، بل مظهر من مظاهر التجاذب الأنطولوجي بين قوى الإدراك السفليّ وقوى الانفعال العلويّ، وهو ما له أدقّ التعلّق بالمقولات التي تُتلقى، بحسب تعبير كانط، في هيئة “إسكيما”، والتي نؤولها نحن بأنها فيض صادرٌ عن النفس إذا ما استنارت بجذوة العقل الفعّال، وارتقت من رتبة التعيّن الحسي إلى مرتبة المعنى الكلّي.
ولأجل هذا التماس، نستعين بمفهوم ἀντίληψις الأفلوطيني {الآنتيلبسيس}، الذي اخترنا له تسمية “النَسَمة”، وبهذا نكون قد تابعنا إشارات الإمام الدهلوي، حيث استظهر أن لتلك “النسمة” جهتين، أو “نجدين” بتعبير القرآن الكريم، أحدهما نجدُ التزكية، وهو الجانب العقلانيّ الروحانيّ الذي يحتوي بالقوة على ما يقابل الإسكيما، فإذا ما فاض عليه نور المدد الإلهي من عالم الأمر، انتقلت من القوة إلى الفعل، وبهذا تخرج المقولات من طور الجمود الصوري إلى طور الفعليّة البيانية، فتغدو لا مجرد أدوات عقلية صمّاء، بل قوالبَ منطقيةً لتكثيف المعنى وتحرير المحتوى الكونيّ من كمونه، إذ الحقّ أن الكائنات، بحسب اصطلاح العارف ابن عجيبة، “أوانٍ حاملةٌ للمعاني”، لا ذواتٌ مكتفية بظواهرها.
ومن هذا الوجه، يُفهم لنا ما فتحه هارتمان من أفقٍ أنطولوجيٍّ كان محجوبًا عنا، حين أقام مدارج الوجود على مراتبَ متداخلةٍ، نعيد نحن تأويلها وسبكها وفق نظام الحكمة المتعالية الشيرازية، حيث لا تكون المقولات حشوا عقليًا جامدًا، بل مراتبَ حيويةً تتكيّف في أعيانها وتترقّى، على مقتضى سنن التشخص والفيض، فالإسكيما إذًا ليست إلا وظيفةً تنظيريةً بالقوة، تُفصَّل بها التعيينات وتضبط بها المفاهيم، وهي تتخلّق في برزخٍ إدراكيٍّ تتجاذبه جهتان: جهة التلقي المعرفي، وجهة التجلّي الكشفي، بحيث لا تُنسب على جهة الحصر إلى العقل المحض، ولا تُدرج بمجردها في التصور المجرد، بل تُرقّى إلى رتبة المتوسّط البرزخي، أو ما أسماه فلاسفة اليونان بالمِتَاكْسِي {μεταξύ}، وهو حدٌّ ليس قاطعًا، بل رابطًا، إذ الجمع في هذا الموضع أولى من الفصل، والحدّ هنا سبيل وصْلٍ لا فصل.
وإذا ما تمّ تنوير “الإسكيما” بذلك المدد، فإن المقولات، التي نأخذ منها على نحو ما فعله شوبنهاور، الزمان الذي لا يفهم بعد ذلك على أنه مجرّد إطارٍ حدسيٍّ، بل يصير “آنًا أبديا” يندكّ فيه التمييز بين الفاني والباقي، حيث الوجود يتوحد على نحو جمعيّ، وتغدو مقولة المكان لا إطارًا صوريًا، بل تمظهرًا للوجود في جوهريّته، أي ما به قوامه الذاتيّ، وبهذا يعاد تأويل مفهوم القيوميّة الإلهية على طريقة المتكلّمين، بحيث تصير العلّة القائمة بذات الحقّ، لا متوسّطة، بل قائمة على جهة الإبداع والتوليد بلا افتقار إلى علّة أسبق، حتى إنّ مفهوم العليّة الأرسطيّ ذاته ينهار وينتفي، في مقابل ما أبقاه شوبنهاور من بقايا السببيّة، وهو ما لا نُقرّه، لأن العقل المحض لا يُفي بعلل الكشف.
فالإسكيما، إذًا، متى استضاءتْ بأنوارِ الفيض العلويّ، وأخذتْ مواقعَها في بنيةِ النفسِ الكونية، استحالَ الفهمُ تصوّرًا لا لفعلٍ ذهنيٍّ محض، بل لتحقّقٍ علويٍّ لمعنى الوجود، وغدت المقولات تبعًا لذلك علاماتٍ على الطبقاتِ النورانية لا على الصور الحسّية، فإذا كمل لها التنوّر، غدا الوجودُ في كلّيته “مفهومًا” {der Begriff} لا بوصفه جمعًا تعريفيًّا، بل بوصفه “صيرورةً مفهوميةً” تتجاوز الثنائيةَ بين Schein {التَّجلِّي البادي} و Erscheinung {التَّجلِّي المُحتَجِبِ}، فُتدكُّ الفوارقُ بين الظاهر والمظهر، ويغدو الوجودُ كله إظهارًا واحدًا، هو عين تجلّي الواحد الأحد، وتغدو الفكرةُ الهيغيلية نُسغًا ساريًا في أوصالِ الواقع، فلا يعود هذا الأخيرُ ترتيبًا عابرًا للأشياء، بل يغدو “واقعا” {Wirklichkeit}—حيث يتأصّلُ في الوَقعِ والتأثيرِ {Wirkung}، لا في الجمودِ والتشيؤِ كما يوحي بذلك المصطلحُ اللاتينيّ “realitas”، المتحدِّرُ من “res”، أي “الشيءِ”. ذلك الذي سيجعلُ من المفهوم والفكرة يَرتقيانِ عن كونهما محضَ مبادئَ تركيبيةٍ، لا تعدو كونها مَفاهيمَ قَبليّةً، أو تَمثيلاتٍ ذهنيةً جامدةً، كما هو الشأنُ في المنطقِ الصوريّ؛ بل يُحلِّق بهما إلى مقامِ الجولانِ الرُّوحيِّ، حيثُ الفكرةُ ليست مَحضَ انفعالٍ للعقلِ، بل وَجْدٌ يخفقُ به القلبُ في تجلِّياتِ الحقِّ، أو كما عبَّر عنها السكندريُّ: “سيرُ القلبِ في ميادينِ الأغيارِ” {الحِكَمُ العطائيةُ، ص ١٥٠، الحِكمةُ رقم ٢٦٢}، حيثُ لا يكون الفكرُ فِكرًا حتى يَسْبَحَ في لججِ العِشقِ الإلهيّ، مُنخلِعًا عن حدودهِ الضيِّقةِ، منطلقًا في فضاءِ الإشراقِ الأزليّ.
وعند ذلك، تنقلب النسبةُ بين الفاعل والمفعول، ويَبين أن ما نعدّه ذاتًا فاعلةً ما هو إلا طورٌ من أطوار المفعولية العليا، التي لا تستقلُّ بذاتها، بل تستديم وجودها بقيوميةِ الحقّ جلّ وعلا، فيغدو الجوهرُ ليس ذاتًا قائمةً، بل مقامًا قابلاً، يستمد قيامه من نَفَسٍ أزليٍّ لا يفتر، هو العلةُ التي لا تعلّ بها، والواهبُ الذي لا تُدركه الموهوبية، فتنكشف مراتب الوجود عن تجلّياتٍ متراكبةٍ، كلُّ مرتبةٍ منها ظلٌّ لنورٍ أعلى، حتى يُفضي الأمرُ إلى الواحدِ الذي به كانت الأشياءُ ولم يكن هو بشيءٍ منها. فحينئذٍ يُعلم أن الكوجيتو كان حجابًا، لا نورًا، وأن الفكرَ في انغلاقه على ذاته، لم يكن إلا دورانًا في باطنِ الظلمة، ما لم تُشقَّ عنه سُدَفُها بشعاعِ الفيضِ، فتصير الذات مفهوما لا من حيث التحديد، بل من حيثُ الاحتواءُ النوري، فتنتقل من مقامِ “أنا أفكر” {الكوجيتو} إلى مقام “هو يُفكّر بي” {الكوجيتور}، بل “هو يُظهرني لأفكر”، فتستحيل المعرفةُ عبادة، والعقلُ مظهراً للقيومية.
وهكذا، إذا ارتقيت بتأملك من مرتبة التجريد إلى مقام الاعتبار البيانيّ، رأيتَ أن تصورنا لا يُتلَقّى على جهة المعارضة الساذجة أو النقض التقريريّ لمقولات الفكر الكانطي، بل يُفهم بوصفه انبثاقًا استبطانيًّا من لبّ هذا الفكر، إذ تُستثمر مقولاته لا على وجه التخطئة، بل على جهة الترقية، فيغدو كلّ مفهوم ترانسندنتاليّ لا حدًّا مقفلاً، بل مفتاحًا يُفضي إلى سرّ أنطولوجيٍّ أعمق، وتتحوّل كلّ شرطيةٍ معرفيةٍ إلى آيةٍ على مرتبةٍ من مراتب التكوُّن الوجوديّ، ويُستبان من كل تركيبٍ عقليٍّ مجرّد صورةٌ لأصلٍ أعلى في عالم الأمر، لا يُدرَك إلا بمقام ἀντίληψις، الذي نؤولُه تأويلاً إشاريًّا بوصفه تهيّؤًا نفسانيًّا لقبول الفيض، لا مجردَ تصوّرٍ ذهنيٍّ مُحايد، ذلك أن الإدراك، في هذا السياق، لا يكون تجريدًا قطعيًّا، بل استعدادًا للكشف، ولا الحقيقة حاصلةً من جملة الحدوس بل شروقًا من جهة العلوّ، كما عبّر المتكلمون عن مقام الظهور بالحقّ لا في الذهن، بل في “وجه الأمر”، إذ هو مظهرُ التجلّي الأول.
وعلى هذا، فإن استئنافنا لمشروع هارتمان لا يُحسب من جهة الاستبدال أو التهشيم، بل هو تجاوزٌ تعمّقيٌّ يتّخذ سبيل التأويل مسلكًا، والتضمين لا الحذف طريقًا، والانخراط في الغيب العقلي، لا الحصر في الحسّ الظاهري، إذ ليس مرادنا الوقوف عند الحدِّ بل العبور به إلى معنى الحدِّ، على نحو ما قرره ابن فورك في تفسير الحدود العقلية بأنها “دلائلٌ على مقاماتٍ لا تُحاط باللفظ”، وهو معنى لا يُستوفى إلا بمقامٍ إلهاميٍّ متعالي، يشبه ما وصفه الفارابي بـ”الفيض الأول” عن العقل الفعّال {νοῦς ποιητικός}، ذاك الذي لا يُحسّ إلا في الوسائط، ولا يُفهم إلا من وراء حجابٍ، كما في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ}.
وإني لم أبتغِ الخوض في ما هو تقنيٌّ صِرف، فإنّ المقام لا يسع التفصيل، ولا يحتمل الاستغراق في دقائق الاصطلاح، وإنما أردت الإيماء إلى جهة المعنى، والتلويح بما وراء المبنى، طلبًا لفتح أفق التأمل لا استيفاء مسألةٍ بعينها.
رابط صفحة الكاتب على فيسبوك: https://web.facebook.com/tarik.hnich.3



