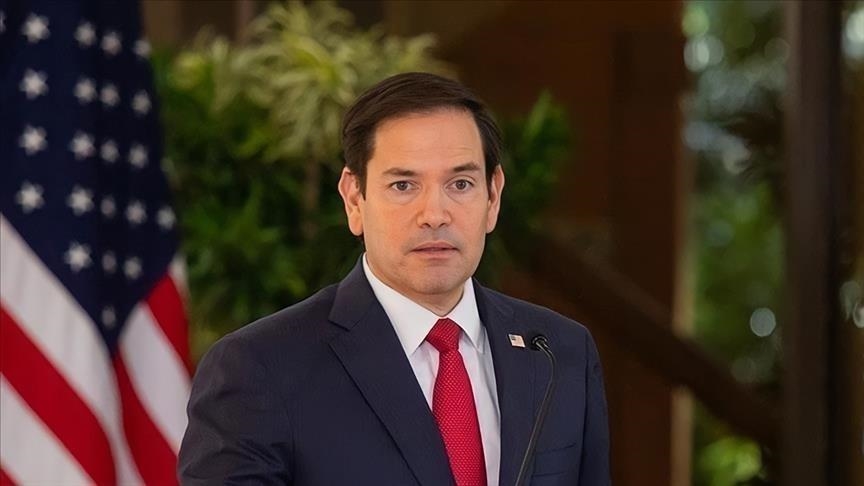على تراب المغرب… هناك ما يستحق أن يُروى للعالم

محمد خياري
حين اجتمع العالم على أرض المملكة لمتابعة كأس إفريقيا 2025، لم يكن الأمر مجرد مباريات كرةٍ تُركَل على العشب، ولا مجرد أهداف تُسجَّل في شباك المنافسين، بل كان حدثاً يتجاوز الرياضة ليصبح لحظة حضارية كبرى، واكتشافاً متجدداً للذات. لقد رأى المغاربة وطنهم بعيون أخرى، وكأن البطولة لم تكن سوى مرآة تعكس صورة المغرب للعالم، وتُعيد للمغاربة وعيهم بجمال أرضهم، وعمق حضارتهم، وصدق روحهم.
إن الفرح الذي عمَّ البلاد لم يكن شعوراً عابراً، بل كان فرحاً أصيلاً ينبع من وجدان الروح الجماعية؛ فرحاً بالقدرة على استقبال العالم بحفاوة، وبالجمع الخلّاق بين الأصالة والمعاصرة، وبين الحكمة والاحترافية. لقد سرت في أوصال البلاد ذبذبات من الحماس المهيب، وزلزال من العاطفة الصادقة هزَّ وجدان شرفاء هذا البلد وأحراره؛ فترى الأمير الوقور يحمل أحلام المغاربة كجمرٍ متقد، وتتوحد النظرات نحو أفق واحد، وتخنقه عبرة الفخر حين يرتفع النشيد الوطني ليزلزل أركان الملاعب. كان الحماس يتفجر في الصدور كأنه صلاة جماعية، تنبعث منها طاقة غريبة تُشعر كل من وطئ هذه الأرض بأن ثمة روحاً إلهية تحرس هذا البلد. حتى أولئك الذين يعيشون في المنافي بعيداً عن تراب الوطن، لم يستطيعوا مقاومة سطوة العاطفة، فكتب أحد المعارضين الشرسين في المهجر على صفحته: “أنا مع المغرب قلباً وقالباً”، وكأن كرة القدم وحدها قادرة على إذابة الخلافات، وتوحيد الصفوف، وإعادة الإنسان إلى جذوره الأولى.
وحتى حين واجهت السلطات رعونة بعض الجماهير الجزائرية والسنغالية، كان الرد ممعناً في الحكمة والاحترافية؛ ولم يكن ذلك ضعفاً، بل قوة روحية باذخة، لأن القوة الحقيقية لا تكمن في رد الإساءة بمثلها، بل في القدرة على تحويل الموقف إلى درس في الرقي، وفي سعة الصدر لاستيعاب الآخر مهما كان. لقد حيّر هذا السلوك الشرق والغرب، لأنه كشف أن المغرب لا يملك فقط الملاعب والبنية التحتية، بل يملك روحاً قادرة على إدارة الاختلاف وتحويله إلى فرصة للتلاقي.
لقد بدا المغرب جسراً بين القارات، يربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين الشرق والغرب، وكأنه قلب ينبض في جسد العالم. وتحولت كرة القدم إلى رمز للوجود الجماعي، ومسرح تتجلى فيه قيم التعاون والصبر والإبداع؛ فبدت الراية المغربية كقصيدة، كل خيط فيها يروي حكاية، وكل لون يحمل معنى. أما المدن المغربية فتألقت كأيقونات تاريخية: مراكش “الحمراء” التي تحفظ أسرار التاريخ، وطنجة بوابة الأساطير، وفاس منارة العلم، والرباط قلب الدولة النابض. والمغربي في كل ذلك بدا إنساناً كونياً، قادراً على المزاوجة بين الروحانية والحداثة.
لكن المغاربة أدركوا أيضاً أن للارتقاء ثمناً، وأن النجاح لا يخلو من مناوئين. ففي مناخ المنافسة العالمية، وحيث تتصارع المصالح واللوبيات، يصبح النجاح في حد ذاته تحدياً. غير أن الهزيمة ليست نهاية المطاف، بل هي جزء من مسار التطور، والمغرب في طريقه نحو الارتقاء الحضاري يحتاج إلى أن يتنفس بعمق، وأن يتوقف لبرهة حتى تمر العاصفة، ليستخلص الدروس ويُبدع طرقاً جديدة للنهوض بما يتوفر له من إمكانيات مادية وبشرية؛ فالحضارة ليست سباقاً قصيراً، بل هي مسيرة طويلة تتطلب الصبر والرؤية والإيمان.
هذا هو المغرب، من أكادير إلى مراكش، ومن الرباط إلى طنجة، ومن الدار البيضاء إلى إفران والداخلة؛ سيبقى ممتداً كلوحة فسيفسائية تجمع بين الشمس والثلوج، وبين الصحراء والخضرة، وبين البحر والجبل. وهذا التنوع ليس مجرد جغرافيا، بل هو رسالة راقية تقول للعالم إن الجمال الحقيقي يكمن في التعدد، وفي القدرة على احتضان المختلف، وفي الانسجام المدهش بين المتناقضات. وفي أزقة الأحياء القديمة، حيث يهمس التاريخ من خلف الجدران، لا ينبغي أن تسمع إلا كلمة واحدة: “مرحباً بك.. مرحباً وألف مرحبا”. وهي ليست مجرد تحية عابرة، بل فلسفة وجودية وتعبير عن روح الضيافة التي جعلت المغرب عبر القرون محطة للتجار والعلماء والمتصوفة القادمين من شتى بقاع الأرض.
في نهاية المطاف، لا ينتصر إلا المنطق، ولا يثبت إلا الجد، ولا يخلد إلا الأخلاق، ولا يضيء إلا صفاء الروح. هذه هي القيم التي تجعل المغرب قادراً على مواجهة التحديات، وعلى تحويل كل تجربة إلى فرصة للنمو. والمهم دائماً ألا نفقد البوصلة أو تضيع منا الأولويات؛ فالمغرب ليس مجرد بلد يبحث عن مكان في خريطة العالم، بل هو كيان يحمل رسالة حضارية، تؤكد أن الجمال يمكن أن يكون طريقاً للسلام، وأن الثقافة جسراً للتواصل، وأن الأخلاق هي الأساس المتين لكل تقدم.