العلاقة بين الإسلام والسياسة في كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق
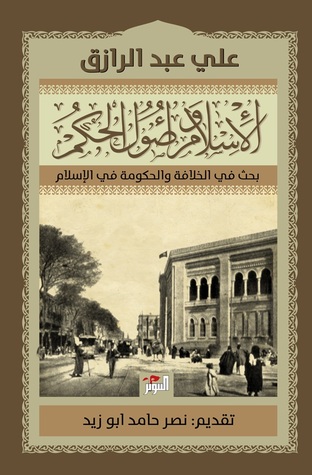
تحرير: يسار عارف
في عام 1925، أصدر الشيخ الأزهري علي عبد الرازق كتابه الشهير “الإسلام وأصول الحكم”، وهو الكتاب الذي فجّر جدلًا واسعًا لا يزال صداه يتردد إلى يومنا هذا. في زمن كانت فيه الأمة الإسلامية تصحو على وقع انهيار الخلافة العثمانية، وينقسم أبناؤها بين من يرى وجوب إقامة الخلافة بأي ثمن، ومن يتساءل إن كانت تلك الخلافة أصلًا من أصول الدين، جاء هذا الكتاب ليقلب الموازين، ويقترح طرحًا مغايرًا لما استقر عليه الفقهاء عبر قرون.
لم يكن علي عبد الرازق ثائرًا على الدين، كما حاول خصومه تصويره، بل كان رجل دين تلقى علومه في الأزهر، واعتلى منصة القضاء الشرعي، قبل أن يقرر أن يواجه ما رآه خلطًا بين الدين والسياسة، ويكشف عن أن الخلافة، كما ظهرت في التاريخ الإسلامي، لم تكن في جوهرها ضرورة دينية، بل كانت نظامًا سياسيًا بشريًا، قام به الصحابة اجتهادًا، وليس تنفيذًا لنص ديني ملزم. وقد اعتبر أن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، لم يؤسس دولة سياسية كما يدّعي البعض، بل كانت ولايته روحية وتبليغية، ولم يُكلَّف بإرساء نظام حكم يُحتذى به من بعده.
بهذا المنظور، أسّس علي عبد الرازق فكرته المركزية، وهي أن الإسلام دين، لا دولة، وأن الشريعة لم تأتِ بنظام حكم محدد، وإنما تركت للناس أن يختاروا ما يناسبهم من صور الحكم، وفق مصالحهم وظروفهم. وهو في هذا يقدّم قراءة مغايرة للقراءة التقليدية التي ربطت بين الإسلام والخلافة، وجعلت من الإمامة أصلًا من أصول الدين، وواجبًا شرعيًا لا يستقيم أمر المسلمين إلا به.
لم يكن هدف المؤلف هدم التراث أو الانتقاص من دور الإسلام في توجيه المجتمعات، وإنما أراد أن يضع حدودًا فاصلة بين الدين بوصفه منظومة قيم وأخلاق، والسياسة بوصفها ممارسة بشرية، تحتمل الصواب والخطأ، وتحكمها المصالح والموازنات. وقد حذّر في كتابه من استخدام الدين لتبرير الاستبداد، مستعرضًا نماذج من التاريخ الإسلامي، حيث تحولت الخلافة في كثير من مراحلها إلى أداة للهيمنة، وألبست ثوب القداسة، مما حال دون محاسبة الحكام أو نقدهم.
إلا أن هذا الطرح الجريء لم يمر دون ثمن، فقد قوبل الكتاب بهجوم شديد من المؤسسة الدينية، وقُدّم عبد الرازق للمحاكمة التأديبية في الأزهر، وتم فصله من القضاء وسحب شهادة “العالِمية” منه، وهو ما شكّل في حينه ضربة قاسية له، لكنها لم تمنع من انتشار أفكاره لاحقًا، بل جعلته رمزًا للتيار الذي يدعو إلى تجديد الفكر الإسلامي، وفصل الدين عن مؤسسات الدولة.
وقد أعاد هذا الكتاب تشكيل الوعي الحديث بالسؤال السياسي في الإسلام. فبعد أن كانت الخلافة تُقدَّم كضرورة شرعية، أصبح بالإمكان النظر إليها كنموذج تاريخي، لا أكثر، بل وأصبح من المشروع أن نتساءل: هل من الضروري أن نحكم باسم الدين؟ أم أن ما نحتاجه هو حكم عادل، أياً كانت مرجعيته، ما دام يحقق كرامة الإنسان وحريته؟ إن ما فعله علي عبد الرازق، في جوهره، هو إعادة الاعتبار للعقل والاجتهاد، وتأكيد أن النصوص الدينية لا تقدم دائمًا إجابات تفصيلية على أسئلة السياسة، بل تفتح المجال للاجتهاد الإنساني.
واليوم، وبعد مرور نحو قرن على صدور الكتاب، لا يزال الجدل قائمًا حول العلاقة بين الإسلام والسياسة، ولا يزال صوت علي عبد الرازق حاضرًا، ليس لأن الناس أجمعت على صواب أطروحته، ولكن لأنه تجرأ على طرح السؤال الذي تحاشاه كثيرون: هل كان من الضروري أن تكون لنا خلافة؟ أم أننا توهّمنا وجوبها فعبدنا صورة من التاريخ، ونسينا جوهر الرسالة؟ لقد كتب علي عبد الرازق ليحرر الدين من السياسة، ويمنح السياسة مساحة من الحرية، لعلها تسهم في بناء أوطان عادلة، لا تستمد شرعيتها من نصوص مؤولة، بل من رضا الناس ومصلحة المجتمع.
ربما لم يكن كتاب “الإسلام وأصول الحكم” كتابًا كاملًا في كل تفاصيله، وربما جانب الصواب في بعض استنتاجاته، لكنه كان، دون شك، علامة فارقة في تاريخ الفكر الإسلامي، ودعوة إلى التفكير، لا إلى الاتباع، وإلى التجديد، لا إلى الجمود. كتاب لا يُقرأ لمجرد الاتفاق أو الرفض، بل لأنه يوقظ فينا السؤال، ويحرّض العقل، ويترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من الحوار.



