علمانية عبد الله العروي
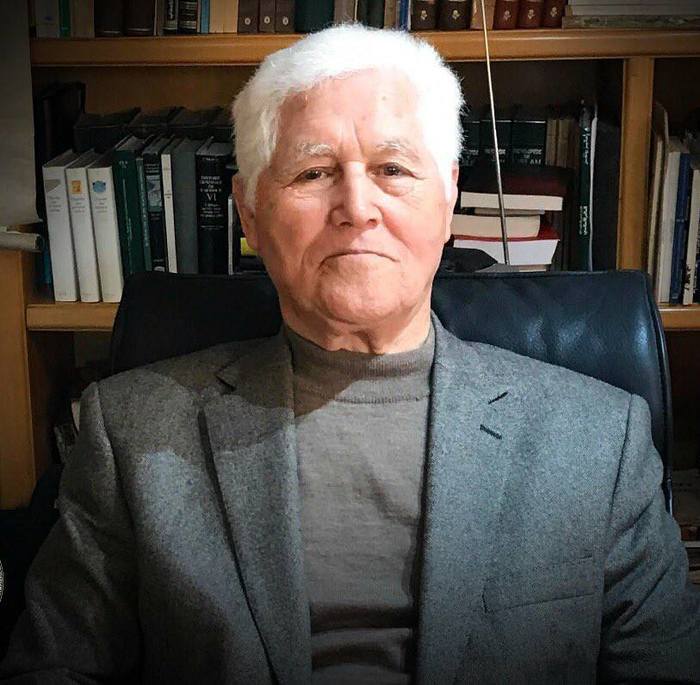
محمد زاوي
قد يتجرأ اليوم بعض خصوم عبد الله العروي على تصنيفه ضمن “حداثويين” يدعون إلى فصل الديني عن السياسي حالا وقسرا وخارج شروط التاريخ، ويصطنعون العجلة في فصل التشريع عن الدين؛ هناك من يضع العروي في هذه الخانة، مكتفيا بدعوته العامة والجدلية إلى “القطيعة مع التراث”.
إلا أن موقف عبد الله العروي من العلمانية غير هذا تماما، ما يثبت -مجددا- خروجه من دائرة المعتاد والمتداول على ألسنة خصومه وأنصاره معا. هذه محاولة للتعريف بموقف عبد الله العروي من العلمانية، وهذه عناصرها:
1 ـ الالتباس الذي أنتجته ترجمة laïque إلى علماني في سياق اتسم بالمناظرة بين “كاتب متشبع بالفكر الغربي الحديث” (نموذج فرح أنطون) و”كاتب صاحب تكوين أزهري” (نموذج محمد عبده)..
في هذا السياق بالذات، أُنتِج التقابل علماني/ إيماني، وعدل المعرّب عن تعريب laïque بكلمة “دنيوي” (مشغول بالدنيا) التي لو استعملت بدل “علماني” لـ”ما حصل التباس” لفئات واسعة من المثقفين والمفكرين العرب (عبد الله العروي، نقد المفاهيم، المركز الثقافي للكتاب، الطبعة الأولى، 2018، ص 91-92-93).
2 ـ لم يسبق لأي مجتمع من المجتمعات، إسلامية وغير إسلامية، أن تحققت فيه وحدة السلطة بين الروحي والزمني؛ فحيثما وجدت سلطة الدين وسلطة السياسة إلا وحل بينهما نزاع عرفته المجتمعات المسيحية ما قبل الحديثة، كما تعرفه المجتمعات الإسلامية إلى اليوم.
فحتى “عندما أصبحت المسيحية دين الدولة (في عهد قسطنطين) وحاولت أن تفرض قانونها الداخلي على الجميع وأن تجعل من المجتمع ديرا”، “لم تنجح بعد مواجهة دامية استغرقت قرونا”، فـ”استظهرت بوثيقة مزورة تقول إن الإمبراطور قسطنطين عند اعتناقه المسيحية تخلى عن كل سلطة لفائدة البابا رئيس الكنيسة.. عندها رد أنصار الإمبراطور بالنص المشهور: أعطوا لقيصر ما لقيصر”. وإلى اليوم، لم تقبل الكنيسة بهذا الواقع فـ”تحاول كلما سنحت الفرصة أن تستعيد ما ضاع منها” (نفس المرجع، ص 94).
3 ـ ولم تعرف التجربة الإسلامية وحدة بين السلطتين الروحية والزمنية عبر تاريخها؛ في كل دولة إمام يرشد وأمير يجاهد، في دولة الخلافة يفوض الخليفة السلطة التنفيذية إلى أمير يحفظ الأمن والحدود، في كل دعوة لإحياء السنة اعتراف بالبدعة التي تفرضها السلطة الزمنية، في كل فترة من التاريخ الإسلامي توتر بين الفقهاء والمتصوفة، في نظام الاستعمار اكتفى الأمير المسلم بتدبير شؤون الدين فيما اختص نظام الاستعمار (الحاكم غير المسلم) بتدبير شؤون الدنيا.. هذه مسائل “يتحاشاها خاصك العلمانية على أهميتها، فيعيش في ظلال ثنائية التشريع، يستفيد منها، يعلم أنه لا يستطيع إلغاءها، ورغم ذلك لا يتعرض لها أبدا بكيفية صريحة”. (نفس المرجع، ص 96-97-98)
4 ـ الخلاف بين الحداثيين والأصوليين في مجتمعاتنا لا يشمل ما ألغي، بل تقوم قائمته كلما مسّ التشريع المعتمد بمقاس أو تعديل يخص قواعد قانونية دينية المصدر.
كلا الطرفين لا ينطلق من واقع الدولة ومتطلباتها وحاجتها، بل يعتبرها مجرد أداة لتنفيذ غرضه: تلبية رغبات الفرد مواطن المجتمع الدولي عند الحداثي، أو “خدمة الأمة المجسدة في الغالب، وهذا غريب، في دولة وطنية أجنبية” عند الأصولي..
أمر آخر لا يعيانه في خضم الخلاف بينهما، وهو أن التشريع الديني عندما يلج مؤسسات الدولة يصبح قانونا لها، “لا فرق بينه وبين قانون الطيران سوى أنه محاط بهالة تقديس في عين الأفراد”. (نفس المرجع، ص 102-103)
5 ـ أما خلاصة العروي فجد مهمة إذ يقول: “إذا نظرنا إلى العلمانية نظرة سوسيولوجية وقلنا إنها حالة قائمة في كل الظروف، مهما كانت الأصول، تسير حسب قواعد في مستواها ولا تنفي إضفاء القدسية على أي إجراء يتخذ في إطارها، نكون قد اعترفنا لكل ذي حق بحقه، الدولة، المجتمع، الفرد” (نفس المرجع، ص 107).
ففي مجتمع كالمغرب، عندما تطرح قضية من قضايا التشريع، يجب أن يعلم الجميع أننا في نقاش علماني متعلق بمصلحة المجتمع لا غير، قد تتحقق بحفظ أو تأويل أو تعديل؛ وذلك مهما أضفت عليها بعض الأطراف قداسة خاصة بها، ومهما نزعت عنها أطراف أخرى هذه القداسة.
ماذا يستفيد مجتمع كالمغرب من هذا الطرح لعبد الله العروي؟ المستفاد هنا عدة مسائل:
ـ أن للمجتمع المغربي علمانية خاصة كما هي العلمانيات في كل المجتمعات؛ إنها علمانية قديمة ليست وليدة اليوم وليست وليدة فترة الحماية.. علمانية قديمة هناك من يخفيها بحديثه عن “استصدار الفتاوى” دون أن يطرح سؤال: كيف تم هذا الاستصدار؟ ولا كيف تم التشريع والقضاء زمن المرابطين؟ ولا كيف رسخ العمل الديني ودُبر العمل السياسي زمن الموحدين؟
ـ وأن “الحداثي” بدفاعه عن مصلحة الفرد في المجتمع الدولة، كذا الأصولي بدفاعه عن مصلحة الأمة الكبرى؛ لا يعبران عن الإشكالية المغربية.. فهذه يهمها قضاياها ومشاكلها وتحدياتها الخاصة، فتنزع إلى استثمار كل خطاب وفق هذا الغرض، بما في ذلك خطاب “الحداثيين” و”الأصوليين”.
ـ أن المجتمع ينتج بدائله التشريعية عندما تنضج شروطها وحاجته إليها، أما عندما تنعدم هذه الشروط وهذه الحاجة فتبقى البدائل حبيسة الشروط والحاجات القائمة.. فلا يأتي الفعل الحداثي/ التقدمي أكله إلا بنضج شروط دعوته، وقبل تحققها (أي الشروط) قد يخدم الحداثي غير غايته، أما الأصولي ففي غير غايته يعيش مزهوا بمعارك متخيلة، لكنها قد تكون ضرورية لغايات لا تخطر للأصولي على بال. إنها قدامة تجلب الحداثة، وعند الحداثي حداثة تساهم في حفظ قدامة ضرورية.
ـ ما يقدمه العروي في موقفه من العلمانية تعبير عن حالين، أفق في المستقبل (دين مدني كما توصل إليه هوبز وروسو/ ودنيا تدبّر بمنطق “الواقع الملموس”)، وأفق في الحاضر من خلال التنبيه إلى علمانية الحاضر والماضي التي لا يراها “الحداثيون” و”الأصوليون” معا، لأنهم غير متعلقين من حيث الوعي بـ”إشكالية الدولة” التي ينتمون إليها، بل بنماذح متخيلة في الغرب أو الشرق.



