الدراسات القرآنية المعاصرة: ثنائية الحداثة والتحديث
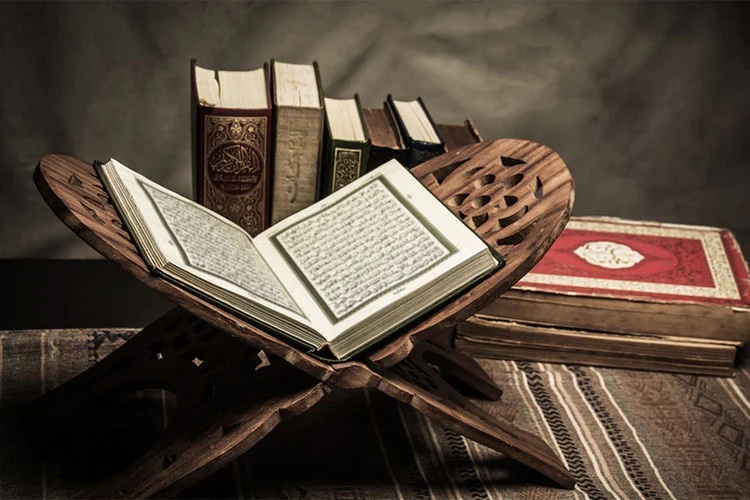
محمد أومليل
موضوع “الدراسات القرآنية الحديثة” الذي نحن بصدد الاشتغال عليه في هذا الفصل الخامس؛ رهين بما بعد القرن العاشر الهجري، كون تلك العشرية خصصناها للدراسات القرآنية القديمة والجديدة ضمن الفصول السابقة، الموافق للقرن السادس عشر الميلادي وما بعده إلى أواخر القرن العشرين.
في تلك المرحلة التاريخية، التي امتدت ما يزيد عن أربعة قرون، برزت فيها “الحداثة” بدءا في أوروبا ثم ما لبثت أن انتشرت في أنحاء العالم قاطبة مع الاختلاف في درجة التفاعل والتأثير من بلد لآخر.
قد يحير الباحث في تحديد “مفهوم الحداثة” بسبب الاختلاف الواسع والمتباين حول التعاريف والتقييمات؛ مرد ذلك إلى اللبوس الأيديولوجي لتلك المواقف.
التعصب الأيديولوجي مانع لمعرفة الحقائق الموضوعية.
الأهم، في نظري، بالنسبة لنا نحن العرب الذين ما زلنا نعاني من التخلف المكعب؛ هو الجانب التاريخي المعرفي البرغماتي (البرغماتية بالمعنى الإيجابي الذي يقصده تشارلز ساندرز بيرس؛ رصد النتائج العملية) في تعاملنا مع “الحداثة” ضمن ما يساعدنا على التخلص من الاستبداد والاستعمار وما يتنجانه من جهل وتخلف وما سواهما.
أما الجانب السلبي من “الحداثة”؛ هو أمر طبيعي كون تلازم الإيجابي مع السلبي قانونا كونيا وبتلك الازدواجية تستمر الحياة تفاعلا؛ “السالب والمجب”.
نحن لا ننتظر من “الحداثة” أن تربطنا بالله وتمنحنا معنى الحياة وتجيب لنا عن الأسئلة الوجودية وتحدثنا عن الجنة والنار؛ كما يرغب في ذلك “دعاة أسلمة الحداثة”، ذلك رهين بما هو شخصي يبحث عنه في مصادره الخاصة بالروحانيات مثل كتب الدين والفلسفة والتنمية البشرية والرياضة الروحية والزوايا الصوفية والتجارب البوذية.
فإن كانت “الحداثة” قد أهملت الجانب الروحي (الروحي باالمعنى الديني) مرد ذلك الإهمال إلى ما عانته أوروبا من جبروت رجال الدين وتسلط الكنيسة، وفي المقابل هناك اهتمام بالقيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية واحترام القانون والمساواة والاهتمام بالفكر والفن والأدب؛ هذه العناصر الثلاثة مما يندرج ضمن المجال الروحي في نظر منظري “الحداثة”، كون المجال الروحي لا يقتصر على الغيبيات فقط، بل يشمل كل أنواع التأمل والفن ومجالات الإبداع المتنوعة.
“الحداثة” مرحلة تاريخية ضمن مراحل التطور لدى الغرب؛ القرون الوسطى، النهضة، الحداثة، الأنوار، ما بعد الحداثة؛ هذا التحقيب هو المتداول أكاديميا من الناحية المنهجية والإبستمولوجية، أما من حيث الواقع الموضوعي والسوسيولوجي؛ فهناك تداخل تلك المراحل الخمس بنسب متفاوتة من بلد لآخر.
“مفهوم الحداثة”، نظريا، اختلف حوله أهل الفكر العرب والعجم على السواء لا سيما المتأخرون، مرد ذلك الاختلاف إلى ميولات أيديولوجية بين من يتبناها بالمطلق بخيرها وشرها، مقابل من يرفضها جملة وتفصيلا؛ من ضمن مساوئ الأيديولوجيا؛ أنها تحول بين المتعصب وبين رؤية الحقائق الموضوعية كما هي في واقع “الحداثة”؛ ما لها وما عليها وفقا لقانون التلازم بحيث لا يخلو خير من أعراض جانبية للشر، ولا يخلو شر من أعراض جانبية للخير.
عموما “الحداثة” نتاج قانون التطور بلغة العصر، وبلغة القرآن؛ قانون التدافع والتداول والاستبدال؛ سنن ربانية ناظمة للآفاق والأنفس.
وعليه، ف “الحداثة” مرحلة تاريخية بلغتها مجتمعات إنسانية بحكم تراكم جهود بشرية في مجالات متعددة ضمن مناحي الحياة من خلال عصور متتالية وحضارات متتابعة.
“الحداثة” في كلمتين؛ مجهود بشري.
غير أنها برزت بشكل جلي في أوروبا نتاج جهود فلاسفة منذ القرن الثاني عشر الميلادي، بداية “عصر النهضة”، من ضمنهم: بيتر أبيلارد، أدلارد الباثي، أنسلم الكانتربري، برنارد دي شارتر..
ثم جاء بعدهم في القرن الخامس عشر وما بعده بقليل: ليوراندو دافينتشي، ميكيلا نجلو، نيكولو مكيافيلي، جوردانر برونو، ليوراندو بروني، نيكولاس، كوبرنيوكس، مارتن لوثر، جون كالفن، فرانسيس بيكون، إسحاق نيوتن..
هؤلاء منهم فلاسفة وعلماء فلك وفيزياء ورياضيات وأهل الأدب والفن ولاهوتيون ومصلحون دينيون؛ كلهم ناضلوا نضالا مريرا وتعرضوا للسجن والقتل والحرق..، إلى غير ذلك من وسائل التعذيب والاضطهاد.
لكن، مما ساهم في بروز “الحداثة” آلة الطباعة التي تم اكتشافها من قبل الألماني (يوهان جوتنبرغ) في منتصف القرن الخامس عشر؛ من خلالها تم نشر العلم والمعرفة في أوروبا على وجه الخصوص وفي العالم بشكل عام بنسب متفاوتة من بلد لآخر.
ثم تلا ذلك الجيل “جيل النهضة والحداثة” “جيل الأنوار”: فولتير، جان جاك روسو، ديدرو، كانط..
ثم “جيل ما بعد الحداثة”: جان فرانسوا ليوتار، ميشيل فوكو، جان بودريار، جاك دريدا، جيل دولوز..
على أكتاف هؤلاء تتراكم المعارف والعلوم ويقام العمران وتبنى الحضارات.
ما يهمنا مما تقدم ذكره هو “الحداثة الغربية” ومدى تأثيرها في أنحاء العالم بما في ذلك العالم الإسلامي، بالإضافة إلى سيرورتها التاريخية وعدم وقوفها في تاريخ معين أو لدى جيل حصريا، بل هي قابلة للتعميم والانتشار إن توفرت القابلية الذاتية والشروط الموضوعية.
” يرى (آلان تورين) أن الحداثة هي عملية مستمرة من التفاعل بين العقل والذات، وبين الفرد والمجتمع، وأنها ليست مجرد تيار فكري أو اجتماعي، بل هي طريقة حياة تتطلب الانفتاح على التغيير والتحول “.
ذلك ما نعنيه ب “التحديث” كونه ملازما ل “الحداثة”؛ الأول يقوم بتفعيل الثاني من خلال الممارسة والسلوك نقدا وابتكارا وإبداعا وإعمالا للعقل.
كون من ضمن أدوات “الحداثة” المعتمدة بالدرجة الأولى: إعمال العقل وممارسة النقد والتخلص من قيود التقليد والتكرار والاجترار.
يتم تحديث الحداثة من خلال تلك الأدوات الذاتية ويشمل جميع مناحي الحياة في قيمها المادية وقيمها المعنوية، بما في ذلك ما نحن بصدده؛ “الدراسات القرآنية الحديثة” بحكم التجاسر والتنافس المعرفيين، لا سيما في عالم، أصبح بمثابة قرية صغيرة، قرب فيه البعيد وسهل فيه الصعب وكثر فيه العلم وانتشرت فيه الأخبار في سرعة قياسية.
المجتمعات المتخلفة في أمس الحاجة إلى “تحديث الحداثة” للتخلص من الجهل والتخلف والاستبداد المتسلط والاستعمار الحديدي والناعم في آن معا.
عملية “تحديث الحداثة” رهينة بتوفر قابلية التحرر مما تقدم ذكره والتزود بما استجد من علم ومعرفة ومناهج ومفاهيم وقيم تساهم في عملية النهضة والتقدم إلى ما هو أحسن في جميع مناحي الحياة.



