الفرق بين منهج ابن رشد ومنهج ابن تيمية، في باب تخريج الأحكام
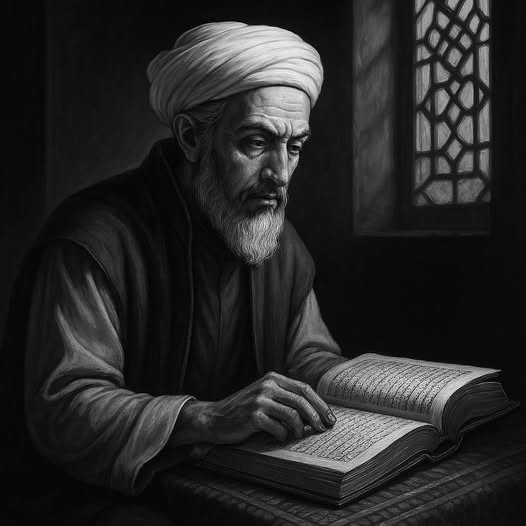
طارق هنيش
الفرق بين منهج ابن رشد ومنهج ابن تيمية، في باب تخريج مناطات الأحكام، مما لا يتأتى الوقوف عليه إلا لمن أحكم النظر في أصول الطرد والعكس، ودفع الدور والنقض، وقاعدة الاطراد والانفكاك التقديري، ومقدمات العلية الشرعية، ودقائق القوادح المعتبرة في القياس الصحيح. وبيان ذلك أن ابن تيمية، لما التزم في مسالك العلل دفع احتمال العكس دفعًا استقصائيًا، لم يرض بالمناسبة الظاهرة، ولا بالملاءمة الذهنية التي يلوح فيها وجه المصلحة، بل اشترط في العلة أن تكون مقتضيةً للحكم اقتضاءً ضروريًا، بحيث يلزم من وجودها وجود الحكم، ومن عدمها عدمه، لزوما لا تطرق إليه تقديرٌ مفسد، ولا احتمال انفكاك معقول، ولا نقض شرطي معتبر، بل يدور الحكم مع علته وجودًا وعدمًا، على قاعدة الطرد والعكس كما هو مقرر عند محققي المناطقة.
كان يتفقد، العلة تفقدًا دقيقًا، فإن وجدها تنفك عن الحكم بانضمام وصف آخر، أو باحتمال مانع مقدر، أو بنقض شرعي معتبر، ردها، ولم يلتفت إلى قوة الظن الظاهر فيها، بناءً على أن العلل لا تصح بمحض المناسبة، بل بصحة الاقتضاء مع الاطراد وعدم القوادح. فهذا، في مذهبه، من شروط الصحة اللازمة، لا مما يتسامح فيه بدعوى الظن الغالب أو المناسبة الظاهرة. وأما ابن رشد، لم يعتن في تخريج مناطات الأحكام بتحقيق قاعدة الطرد والعكس على النحو الذي يسلكه الأصوليون المحققون، بل كان يغلب عليه اعتبار العلل الاستصلاحية، التي تستند إلى حسن المناسبة العقلية، دون استقصاء لاحتمال القوادح الظنية، ودون دفع للعكس والانتقاض دفعًا تحقيقيا.
ولهذا ترى علله كثيرًا ما تكون منقوضة باعتبار العوارض، أو محتملة للانفكاك الشرطي، أو قابلة للتقدير باعتبارات خارجة عن مناط الحكم، فلا يلزم من وجود العلة وجود الحكم لزوما عقليا ضروريا، بل يلزم غالبًا أو بحسب الظاهر، وهذا قادح في صحة العلة عند الأصولي المحقق. وبيانه أن مناط العلية عند المحققين لا يكفي فيه مجرد اقتران الحكم بوصف على وجه الاستحسان العقلي، بل لا بد أن يكون الحكم دائرًا مع العلة وجودًا وعدمًا، بحيث يكون العدم مستفادًا من العدم، والوجود مستفادًا من الوجود، على وجه لا يقبل الانفكاك إلا تقديرًا فاسدًا أو احتمالًا غير معتبر. فإذا تأملت علل ابن رشد، وجدت أن أكثرها معلق على أوصاف ظنية أو مصالح استصلاحية، لا يأمن معها احتمال العكس والانفكاك، ولا يدفع عنها النقض دفعًا قاطعًا، بل يبقى في العلة قدر من الضعف الاعتباري، مما يصير معه القياس المنبني عليها غير سالم عن القوادح.
بل قد يقال: إن استمداد ابن رشد في تخريجه للعلة من القضايا الفلسفية المجردة، أوقعه في الغفلة عن دقائق القوادح الأصولية، إذ كانت غايته تقرير المعقول المجرد لا إحكام مناط الأحكام الشرعية بما يدفع النقض ويدفع العكس ويحقق الطرد التام. واعترض عليه من وجوه: أحدها: أن الاعتماد على المناسبات الظاهرة من غير دفع قوادح العكس والنقض تهاون في شرط الاطراد، وهو شرط أصل في صحة العلل كما نص عليه المحققون.
الثاني: أن تعلق العلل بالمعاني الاستصلاحية المجردة يجعل الحكم تابعًا لمصالح مظنونة، لا لعلل مضبوطة، فيتطرق إلى القياس احتمال الفساد بطريق تقدير المناط، مما يبطل الثقة بملازمته.
الثالث: أن الاعتماد على حكمة التشريع الظاهرة مع إمكان انفكاكها عن الحكم بعوارض خفية، قد يورث ضربًا من التناقض الخفي، فيكون الحكم جاريا على مناط ظني لا يطرد في موارده، وهو نقص في القياس.
الرابع: أن مجرد الاستحسان العقلي لا يغني عن التحقيق الأصولي الذي يوجب دفع كل عكس محتمل ونقض مقدر، وعلى هذا، فمما يتقرر بالاستقراء والنظر الدقيق، أن ابن تيمية أرسخ قدمًا، وأدق تقعيدًا، وأبعد عن القوادح في باب تخريج المناطات، من ابن رشد، الذي غلب عليه جانب النظر الفلسفي المجرد، فأغفله ذلك عن شروط التحقيق الأصولي التي بها يميز الصحيح من الفاسد من الأقيسة الشرعية.
فالفرق بين ابن تيمية وابن رشد، فيما يرجع إلى تنزيل الأحكام على مناطاتها، ليس فرقًا في درجات الاستنباط، بل هو تباين في أصول النظر ومسالك الاعتبار؛ إذ كان ابن تيمية، في تفقده لمناط التحريم، ينظر بعين الاستقصاء الكامل إلى استجماع شروط الطرد والعكس، وسبر مدارك العلة بسبر شامل يدفع النقض والمانع، ويحقق مناط الاطراد والانعكاس تحقيقًا لا يترك لمعارض شبهة اعتراض. وبيان ذلك أن القوم لو عرضت عليهم مسألة تحريم الحشيشة على سبيل المثال، لاشتد الفرق بين نظر التيمي ونظر الرشدي.
فأما ابن رشد، وقد غلب عليه المسلك المناسباتي المستند إلى ظواهر المصلحة، فكان يقيس الحشيشة على الخمر بقياس مستبطن للمناسبة الظاهرة، وهي الإخلال بالعقل، إذ جعل العلة في تحريم الخمر مطلق تغطية العقل، والحشيشة في زعمه تساويها في هذا الوصف، فاقتضى عنده مساواتها في الحكم، من غير أن يستفرغ الوسع في دفع احتمال المانع، أو يستقصي صور الانفكاك، أو يتحقق من طرد العلة وانعكاسها، بل اكتفى بالمشابهة الإجمالية بين الأصل والفرع، مسلكًا طريق الظن الغالب، دون تحقيق مناط الطرد والعكس. وأما ابن تيمية، فقد كان منهجه، كما هو شأن المحققين من أهل الأصول، قائمًا على وجوب دفع العكس والنقض لا دفعًا جدليًّا صوريا، بل دفعًا تحقيقيا برهانيا، فكان إذا أراد تخريج مناط التحريم، لم يكتف بملاحظة الظاهر، بل استقصى حال الحشيشة: هل تساوي الخمر من جميع جهاتها؟ وهل الإخلال بالعقل فيها جارٍ مجرى الإسكار في الخمر، أو أن بينهما فرقًا مؤثرًا؟ وهل يطرد الحكم مع وجود العلة، وينعكس مع عدمها؟ وهل تقتضي العلة الحكم باطراد من غير شبهة مخصص أو مانع؟ فوجد أن الحشيشة، مع أنها تضعف العقل وتغشيه، إلا أنها لا تورث نشوة الخمر وسكرها، بل تورث فساد العقل مع تثبيط الإرادة وخمود النفس، وإفساد الدين والفطرة، فكانت مفسدتها مركبة، لا مقصورة على جهة واحدة كالخمر، بل أعظم أثرًا وأفسد مادة. فجعل مناط التحريم ليس مجرد الإخلال بالعقل، بل مجموع فساد العقل والدين معًا، وهو مناط أدق وأرسخ في بابه، وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة في حفظ الضروريات، ومنع المفاسد الجامعة. هذا منه تخريج مناط بطريق استقراء العلل وسبرها، لا بمجرد المناسبة الظاهرة، بل بتحقيق تحقق الشرطين: الطرد والعكس، ودفع احتمال الانفكاك بين العلة والحكم، مما يدل على رسوخ قدمه في أصول النظر والتحقيق.
شتان بين من يقيس بقياس الظن الغالب مع إمكان الانفكاك، وبين من لا يرضى إلا بقياس محقق المطرد المنعكس، قد دفع عنه كل وارد ناقض، واستوثق من تحقق الشرط والمانع والسبب والمقتضي، على وجه يطابق قوانين العلية والانضباط العقلي تحقيقًا لا ظنًّا، وبرهانًا لا تخمينًا.
رابط صفحة الكاتب على فيسبوك:



