وضعنا العربي ومعضلة عالم التشابك المعقد
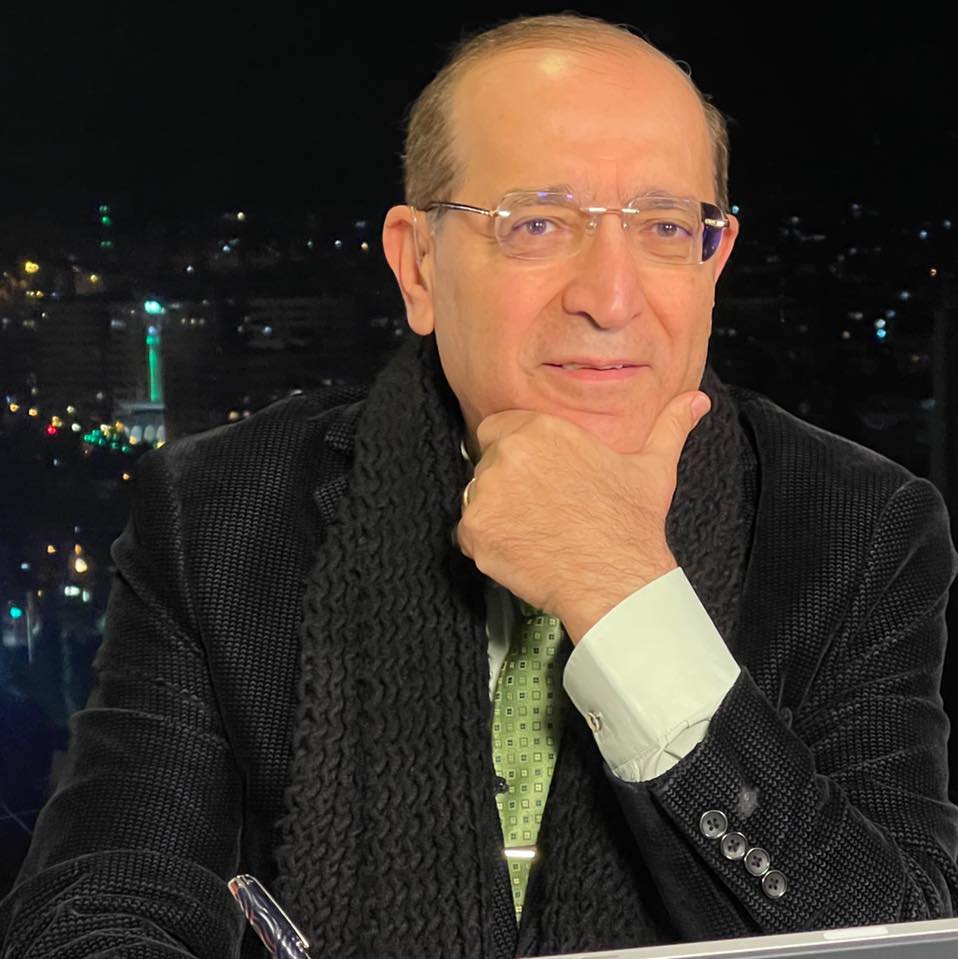
عماد فوزي شعيبي. مفكر سوري
كثيرًا ما تُصادفنا في الحياة وقائع نوعية، يُطلب منّا أن نحللها أو أن نفسرها، لكن التداخل في هذه الوقائع مع بعضها ومع عوامل أخرى، يجعل التحليل أو التفسير أقرب إلى “خرافة التحليل”! وأقرب إلى المغامرة أو إلى الادعاء!
والواقع أن ما يحدث فعلياً في الوجود أن تلك الوقائع يفسرها مصطلح (Complexity) وهو من أكثر المصطلحات ثراءً وتشعباً، لأنه لا يقتصر على معنى واحد بل هو شبكة مفاهيمية تمتد من الرياضيات والفيزياء إلى الفلسفة والاجتماع والسياسة وحتى علم النفس، بل و إلى الوجود نفسه!
- التعريف العلمي والمعرفي:
مفردة Complexity تعني حرفياً إذا أردنا ترجمتها بشكل دقيق: التشابك في التعقيد، لكنها في العلوم لا تعني مجرد “الصعوبة” بل تشير إلى: حالة أو نظام يحتوي على عدد كبير من العناصر المترابطة، بحيث يكون سلوك الكل مختلفاً وغير قابل للاختزال إلى سلوك الأجزاء منفردة.
وهنا بالذات لا يكون الكل هو حاصل مجموع أجزائه! أي أن العناصر + التفاعلات + التغذية الراجعة تولّد أنماطاً وسلوكيات لا يمكن التنبؤ بها بسهولة، وهذا ما يجعلها ظاهرة منبثقة أي من خارج السياق. ويمكن أن نراها في عدة حقول معرفية:
في العلم:
- في الرياضيات ونظرية الأنظمة المعقدة، وتعني نظامًا يحتوي على عناصر متعددة متفاعلة (مثل شبكة الإنترنت، أو المناخ)، حيث يصعب التنبؤ بمخرجاته بدقة.
- في الفيزياء: يظهر التشابك في التعقيد في الأنظمة غير الخطية، والواقع أن اغلب الأنظمة غير خطية، حيث أن تغيّرًا صغيرًا في المدخلات يؤدي إلى تغيّر كبير في المخرجات وهذا ما ندعوه أثر الفراشة (butterfly effect) والذي نراه في نظرية العماه(chaos theory)؛ حيث تكون البنى غير مُنظمة وغير قابلة للتنظيم أصلاً.
- في علوم الحاسوب: نرى ظاهرة التشابك المعقد الكمبيوتري عندما نسعى إلى قياس حجم الموارد المطلوبة (وقت/الذاكرة) لحل مشكلة ما.
- المعنى الفلسفي: يتقاطع مع هذا المفهوم الكثير من وجهات النظر الفلسفية حيث يرى الفيلسوف إدغار موران أن التعقيد ليس فقط في كثرة الأجزاء، بل بالتشابك بين الأجزاء مع عدم إمكانية عزلها لفهم الكل. وهو أبلغ تعبير عن التشابك المعقد.
هنا التعقيد يتحدى النظرة الاختزالية التي تسند تفسير أي ظاهرة أو نتيجة إلى سبب وحيد وهو ندعوه الرد، الأمر الذي يحتاج إلى مقاربة شمولية كلّية. وهنا بالذات في الفلسفة، التعقيد يرتبط بفكرة اللايقين المعرفي، لأن الأنظمة المعقدة لا تُعطي إجابات نهائية أو خطية. والواقع أن كل الوجود فيه تلك الأنظمة المتشابكة التعقيد والتي لا تفسح في المجال أمام الوصول إلى يقين ثابت بخصوصها، والامر لا يعد كما قلنا أكثر من زعم المعرفة اليقينية!
- أمثلة اجتماعية
- مفهوم الهوية الثقافية وهو مزيج من الدين، و اللغة، والعادات، والتاريخ، والسياسة… وهنا لا يمكن فهمها عبر عنصر واحد فقط. وهذا ما تسقط به الكثير من التحليلات الأيديولوجية التي تعكس إلى حد كبير الانحياز العقلي وعلى الأغلب يكتنفها إنحياز التأكيد.
- وسائل التواصل الاجتماعي:
تخلق تلك الوسائل بيئة تتشابك فيها العوامل النفسية والاجتماعية والتقنية، مما يخلق ديناميكيات غير متوقعة (مثل الحملات الخلافية والغرائزية).
- أمثلة نفسية
- الشخصية الإنسانية هي مزيج من العوامل البيولوجية، الوراثية، التربوية، البيئية، والتجارب الشخصية. ويظهر أكثر ما يظهر فيها اختلاف الطبعة المخية، التي تختلف من شخص إلى آخر، وأحياناً تكون بعض الشخصيات من النوع (البارادوكسي paradox) الذي يتسم بشخصيتين متناقضتين و متعاكستين في آنٍ الأمر الذي يجعل من إمكانية تعيين تصور واضح عنها شبه مستحيل.
- العلاقات العاطفية: تتأثر بها عوامل مختلفة قد لا تموت بشكل مباشر إلى الشعور، كالمصالح، والقيم، والثقافة وأحيانا المصالح، والماضي الشخصي للطرفين، وأحياناً أحداث خارجية…
- أمثلة سياسية
- في الشرق الأوسط بشكل خاص، يحدث تشابك بين الدين، والنفط، والتحالفات الدولية، والموقع الجغرافي والتاريخ القديم والاستعماري، والصراعات القومية، البنى الاجتماعية.
- الحرب الباردة: لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل مزيج من الاقتصاد، الأيديولوجيا، سباق التسلح، والدبلوماسية والأعمال الاستخباراتية…3. المفاوضات الدولية: كل طرف يتعامل مع اعتبارات داخلية وخارجية، وضغوط جماهيرية، وتحالفات متشابكة، وإعتبارات نفسية وأحيانا شخصية…
- أمثلة تاريخية
- سقوط الإمبراطورية الرومانية لم يكن بسبب عامل واحد، بل نتيجة اقتصاد منهك، فساد داخلي، ضغوط خارجية، وانقسام ثقافي، وعوامل تتصلب متغيرات ميزان القوة ذات السيولة الكبيرة أنذاك… واعتبارات من الصعب تعيينها، كذلك سقوط الأنظمة عقب الثورات.
- الثورة الصناعية: تتشابك أسباب الظهور والنشوء بين الاكتشافات العلمية، والتحولات الاجتماعية، والهجرة، والسياسات الاقتصادية.
- الاضطرابات الناجمة عن الثورات هي مزيج من الاحتقان السياسي، الفقر، التكنولوجيا، والعوامل الإقليمية والدولية، الاعتبارات الشخصية للبعض سواء الأفراد أو المجموعات، وبعض الاعتبارات الأيديولوجية والدينية…
- أمثلة أخرى:
الوعي: يتداخل فيه البيولوجي (طبيعة المخ )، والعامل النفسي، والاجتماعي، والفلسفي وطبيعة الثقافة السائدة إضافة إلى نقطة الإستشراف لكل شخص على حدى!
التاريخ كظاهرة كما نقول في منهجنا الكوانتي: التاريخ ليس خطياً، بل مليء بالتشابكات والتأثيرات المتبادلة التي لا يمكن فصلها.
- ربطًا مع منهجنا الكوانتي
التشابك في التعقيد يمكن النظر إليه كـ:
- حالة احتمالية (مثل ميكانيكا الكم) حيث التفاعل بين عناصر كثيرة يولد نتائج لا يمكن حسمها مسبقاً. أي الاحتمالات في النتائج كبيرة وقد تكون لانهائية.
- كذلك أي حدث في نظام معقد قد يكون نقطة انهيار كمومية، حيث الاحتمالات تتحول فجأة إلى واقع.
- كل نظام معقد لديه حساسية مفرطة للظروف الأولية وأيضا لمن تم ذكره من أثر الفراشة، ما يجعل التنبؤ الطويل المدى شبه مستحيل.



