محاولات التحرر من العقل الغربي
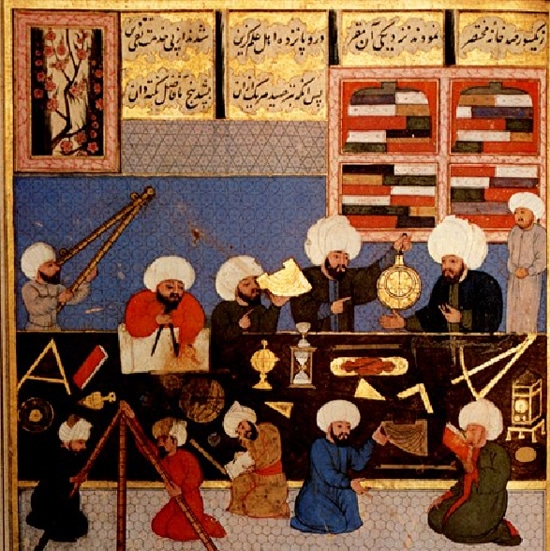
حسين بوبيدي
حين ظهرت مدرسة دراسات التابع [Subaltern Studies] في الهند مع بداية الثمانينيات بقيادة المؤرخ “راناجيت غوها” وزملائه، لم تكن مجرد محاولة لإضافة أصوات المهمشين إلى النص التاريخي، بل كانت مشروعا إبستمولوجيا جذريا لإعادة كتابة التاريخ من خارج مركزية العقل الغربي، وقد استند هذا المشروع إلى نقد مزدوج، أولا: للرواية الكولونيالية البريطانية التي أعادت تشكيل التاريخ الهندي وفق منطق الهيمنة، وثانيا: للتاريخ الوطني الهندي نفسه الذي ورث كثيرا من آليات الاستبعاد الغربية في تمثيل “التابع” بمختلف تمظهراته: أي الفلاح، المرأة، الطبقات الدنيا، وسكان الهامش بوصفهم مجرد مادة خام لتاريخ النخبة.
إن العقل الغربي الذي واجهته دراسات التابع لم يكن عقلا محايدا أو كونيا كما يدعي، بل كان عقلا انتقائيا ينتج المعرفة في صورة متحيزة تخدم موقعه المهيمن، والانتقائية هنا لم تكن مجرد اختيار من بين بدائل، بل آلية متكاملة للهيمنة، فقد ركز التاريخ الاستعماري للهند -على سبيل المثال- على تصوير المجتمع الهندي في القرن 18 ككيان متفكك وممزق، فاقد للقدرة على إنتاج الدولة الحديثة، كما في السرديات التي هيمنت على أعمال المؤرخين البريطانيين، مما قدم الاستعمار البريطاني بوصفه عملية إنقاذ حضاري. لكن راناجيت غوها بين في أبحاثه أن هذه السردية تجاهلت تماما أنماط الحكم المحلي وشبكات المقاومة الشعبية التي لم تكن تنضوي تحت مشروع النخبة، بل كانت قائمة على أشكال من السلطة الاجتماعية المستقلة عن المركز الاستعماري.
كما مارست المعرفة الغربية انتقائية منهجية حين فرضت مناهجها ومفاهيمها التحليلية بوصفها معايير كونية، بينما هي في حقيقتها مشروطة بتاريخ أوروبي خاص، وفي هذا السياق دمجت دراسات التابع بين مقاربات مستمدة من الماركسية والتحليل الخطابي ما بعد البنيوي، مع استدعاء مفاهيم من السياق الهندي، كما فعل بارثا تشاترجي حين أوضح كيف أن الفكر القومي الهندي لم يستطع الإفلات من قوالب التفكير الاستعماري، بل أعاد إنتاجها داخل مشروعه التحرري، ما أبقى “التابع” خارج دائرة الفعل السياسي الفعلي.
ولم تتوقف الانتقائية عند المنهج، بل امتدت إلى اللغة والرمز، حيث أعادت المعرفة الكولونيالية صياغة المفاهيم الهندية بلغتها الخاصة، مجردة إياها من سياقاتها الأصلية. غاياتري سبيفاك في مقالها الشهير: هل يحق للتابع أن يتكلم؟ نبهت إلى أن خطاب النخبة سواء كان استعماريا أو وطنيا، تعامل مع التابع ككائن صامت، حتى في القضايا التي تخصه مباشرة، مثل قضية الأرامل اللواتي كن يُحرقن مع جثث أزواجهن في طقس “الساتي”، حيث انشغل الخطابان -الاستعماري والوطني- في الجدل حول المعنى والمشروعية، بينما تم تغييب صوت النساء المعنيات أنفسهن!!
إن القيمة الكبرى لهذا المشروع تكمن في أنه كشف أن العقل الغربي لا يهيمن فقط عبر الجيوش والاقتصاد، بل أيضا عبر ما يمكن تسميته بـ “احتكار المعنى”، فالغرب لا يكتفي بإنتاج معرفة عن الآخر، بل ينتج معرفة بدلا عن الآخر، ويُسكت صوته، ولذلك تعد كتابة تاريخ التابع ممارسة مقاومة، لأن إعادة امتلاك السردية التاريخية تعني نزع شرعية ادعاء الغرب بالحياد والكونية.
لقد نجحت دراسات التابع في الهند في فتح نقاش عالمي حول حدود العقل الغربي، وأثرت في دوائر أكاديمية من أميركا اللاتينية إلى إفريقيا، ملهمة مقاربات تسعى إلى تحطيم الميتافيزيقا الكولونيالية التي ترى العالم من نافذة واحدة، ومن خلال هذا الإلهام أمكن لمدارس أخرى أن تدرك أن مواجهة الاستعمار المعرفي لا تكون بملء الفراغات في نص الغرب، بل بكتابة نص آخر ينطلق من خبرة محلية وسياق تاريخي خاص، ويرفض أن يكون الغرب هو الحكم الأخير على صدق المعرفة.
إن انتقائية العقل الغربي ليست خللا عرضيا في بنيته، بل هي شرط وجوده، إنه عقل صُمم ليبقى في المركز، وليعيد صياغة العالم على صورته، ويحول الآخرين إلى هوامش في كتابه الكبير، ودراسات التابع في الهند كانت إعلانا بأن الهامش قادر على الكتابة بنفسه، وأنه لا يحتاج إلى إذن من المركز ليفعل ذلك، فهل ستدفعنا غزة لنقدم نموذجنا ونتحرر من وصاية العقل الغربي على طريقة تفكيرنا في ذواتنا؟
المصدر: صفحة الكاتب على منصة فيسبوك.



