كتاب جماعي حول مفهوم الدولة عند جماعة الإخوان المسلمين
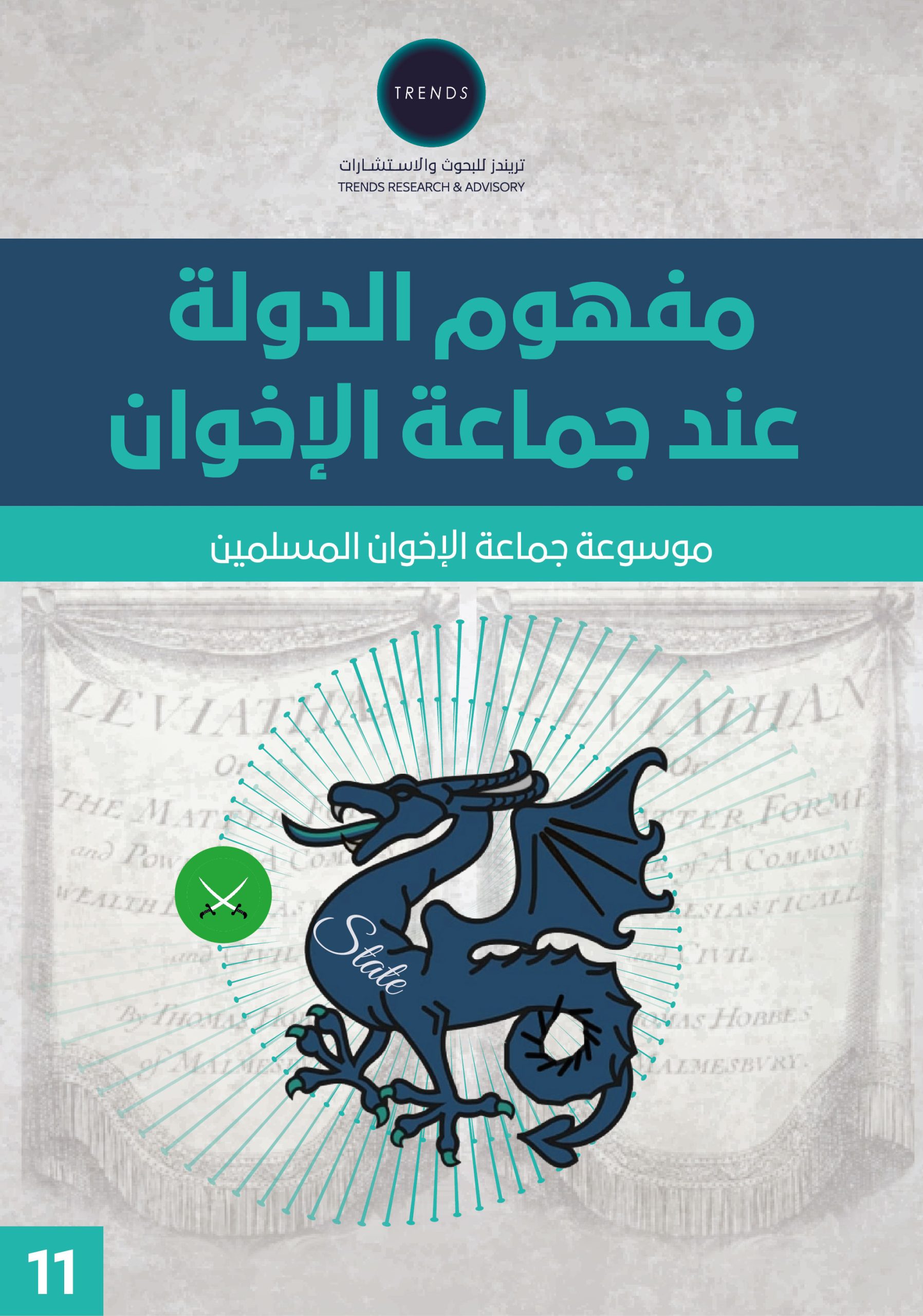
ثريا ذاكر
ضمن سلسلة “موسوعة الإخوان” صدر الكتاب الحادي عشر بعنوان مفهوم الدولة عند جماعة الإخوان المسلمين، وأشرف على تحريره الدكاترة محمد عبد الله العلي، وائل صالح ونورة الحبسي.
جاء الكتاب الصادر عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، متضمنا تقديما حرره الدكتور توفيق أكليمندوس، ويليه استهلال حرره الدكتور عمرو الشوبكي، ثم مقدمة بقلم الدكتور محمد عبد الله العلي، وخمسة فصول وخاتمة حررها الدكتور وائل صالح.
من أهم الخلاصات التي توصل إليها المشاركون في هذا الكتاب الجماعي، هو أن تبعات ما بعد أحداث 2011 تقتضي أن نتعامل بنسبية مع مراجعات بعض مُنَظَري الإخوان، والمتعارضة بطبيعتها مع الأسس الفلسفية لمفهوم المواطنة، والتي قد تبدو في ظاهرها مفارقة للأفكار المؤسسة للجماعة. ولعل تصريحات الجماعة وممارساتها مع بعض الفرقاء يصب في هذا السياق، حيث تظهر أن تلك المراجعات لا محل لها من الإعراب في سلوك الجماعة في المعترك السياسي.
إن مفهوم الدولة عند جماعة الإخوان المسلمين، الذي تم تفصيله وتحليله وتفكيكيه ونقده في هذا الكتاب، وكشف انعكاسه في سلوكيات الجماعة، يمثل تحديا للمجتمع وللدولة وللدين ذاته، والسبب في ذلك حسب المشاركين في الكتاب، أنه يعيد تعريف الإسلام ليستخدم تلك النسخة الجديدة من الدين باعتباره وسيلة. لتحقيق الغايات التي تحقق مصالح الجماعة، كما أن مشروع الدولة الإخوانية، سواء. من جهة كونه فكرة، أو من جهة كونه اختبارا وتحديا – يُشَكل تحديا أيضا على أمن الدولة الوطنية الحديثة في بُعده الشامل، وبخاصة البُعد الفكري. وتتعدد وجوه تحدي المشروع الإخواني للدولة الوطنية، إذ تشمل الأبعاد المعرفية والقيمية والأخلاقية.
تقوم الدولة الإخوانية على مفاهيم وقيم وتصورات بمناهضة لتلك التي تتأسس عليها الدولة الوطنية، ومن ثم تمثل عائقا يحول دون استكمال قواعد بنائها لتكون دولة المواطنة، بما يجعلها تستقطب لدى الفرد مشاعر الانتماء والولاء. وقد أظهرت التجارب التاريخية تهافُت تواضع أداء هذا المشروع، إذ إنه لم يخفق فحسب في الاستجابة لتطلعات الجماهير في التنمية والرخاء، بل إنه كشف أيضا عن الازدواجية في ممارستها، وما تنطوي عليه من مغالطة وخداع في موقف هذا المشروع من الدولة الحديثة.
لقد أدى فهم الجماعة للسياسة ونظام الحكم إلى عملية تشويه شديدة للمنظومة المعرفية التي تتبناها هذه الحركات، فأصبحت رؤيتها للعمل السياسي – أو لنظام الحكم – تقوم على معادلة، هي في جوهرها خليط من مفاهيم تدعي أنها الإسلام، مع مفاهيم غربية معاصرة لكنها مشوهة. كما أنتجت هذه المعادلة واحدة من أسوأ صور الممارسة السياسية في التاريخ الإسلامي، إذ إن إيمان هذه الحركات بأن السياسة هي القوة أو السلطة أو النفوذ أو علم إدارة الدولة، واعتمادها على مصادر المشروعية الإسلامية، كل ذلك أدى بها إلى الوصول إلى مرحلة من السعَار الشديد للوصول إلى الهيمنة على مفاصل الدولة، وإلى درجة مُعَقدَة من الاستبداد، خصوصا الاستبداد الفكري الذي يقوم على افتراض امتلاك الحقيقة، ومن ثم نزع المشروعية عن المخالفين، ونفيهم خارج المجتمع، أو خارج الوجود نفسه في بعض الحالات.



