كتاب تدعيم المنطق لسعيد فودة: قراءة نقدية
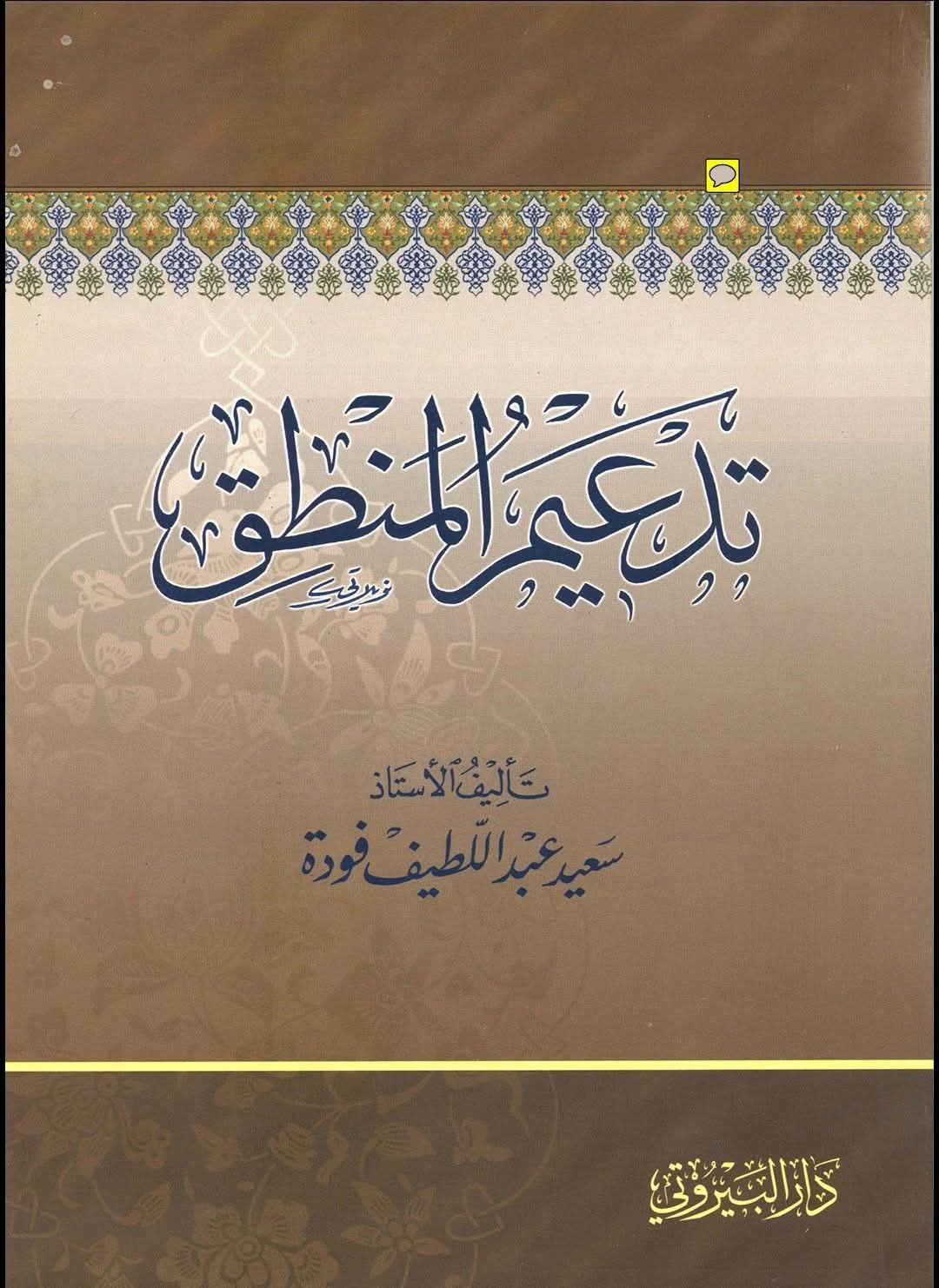
طارق هنيش
إنّ من نظر في رسالة سعيد فودة المعنونة بـ”تدعيم المنطق” علم أنّها محاولة مسترخية على سطح القول، متهافتة على تقليد المتكلمين تقليدًا لا روح فيه، إذ هي مبنية على تمثيلٍ مشوش للمعقول الأول، ومعاندةٍ مضطربة لمسالك الفهم التيمي، ففودة لم يلحظ أنّ نقد ابن تيمية للمنطق لم يكن على جهة الإنكار للآلة من حيث هي آلة، بل من جهة ما تضمّنه المنطق—بهيئته الأرسطية—من دعوى إحاطةٍ للموجود تحت سلطان الحدّ والمقالة، وما هو في التحقيق إلا تصوّر لمفهومٍ يدّعي التعيين لما لا ينحصر تحت الكليات، فيغدو الحدّ عندئذ تقنينًا لما لا يُقَنَّن، وإحاطةً لما لا يُحتاط.
إن ابن تيمية لم يقف في تعقيبه على صرح المنطق عند مجرد التماس الإشكال في مبادئه الإجرائية، كالتصور والتصديق، ولا عند مساءلة أقيسة الشكل الأول والثاني من جهة الإنتاج وعدمه، بل جاوز تلك المطارح الظاهرة إلى تقويض المبنى الغائيّ للنسق المنطقي برمّته، فانتهى بنقده إلى مقام يتعالى عن الخلافات المدرسية، ليفتح باب المساءلة عن «العلة القصدية» المستكنّة في صلب هذا النسق، لا من حيث ما يُدَّعى له من صلاحية آلةٍ فحسب، بل من حيث هو ضربٌ مخصوصٌ من التمثل المفهومي للوجود، مشبعٌ بإرادة تسلطية خفيّة، تُلبِس نفسها لباس البرهان، وتخفي بنيتها القهرية تحت غلالة الحياد المعرفي.
لقد أدرك ابن تيمية، وهو في مقام الفحص المفهومي، أن المنطق بما هو، ليس آلة محايدة لاستنباط الحق، بل هو جهاز تصنيفيّ ميتافيزيقيّ، يعمل على تصيير الوجود لا كما هو، بل كما يُتصوَّر وفق مقولات العقل وتقديراته القبلية، إذ يُفرَض الحدّ بوصفه ممثلًا لـ”ماهية” الكائن، لا وصفًا لظهوره، ولا تقريبًا لمعناه من حيث هو موضوعٌ متعيّن في الواقع، بل من حيث هو محلٌّ لصورة مفهومية صُكّت ابتداءً في الذهن، ثم أُلحقت بالموجود إلحاقًا قياسيًا، يشبه ما يسميه المناطقة بـ”القياس الكليّ المركب”، حيث يُجعل الحدّ الأوسط موضعًا لتعيين العلاقة بين حدّين لا يلتقيان إلا في الذهن، لا في الخارج. وبذلك، يصير الحدّ، في تصوره، لا مجرد أداة تعريفية، بل هو تمظهر لعقل تجريديّ يبتغي تثبيت الانسياب الكونيّ داخل قوالب لغوية متخشبة، فتغدو الموجودات، تحت قهر هذا النظام، مرآةً للمفاهيم، لا أن تكون المفاهيم صورًا ناظرة إليها. وهذا انقلاب على جهة الدلالة، وانتحال لمقام المعلوم بالذات في موضع المعلوم بالغير، حيث يُنزَّل “الماهويّ الذهنيّ” منزلة “التحققيّ العينيّ”، ويُجعل الخارج تاليًا للذهن، لا سابقًا له، وهو عين ما يؤدي إليه ترتيب الحدّ المنطقي في نسقه الأرسطيّ. فالقياس إذًا، وقد بُني على حدٍّ مسبوقٍ بتقديرٍ مفهوميّ، لا يُستخرج منه حكمٌ يتبع الوجود، بل يُستخرج منه حكمٌ يتبع مفروضات العقل، فتصير النتيجة لا كشفًا عن الواقع، بل تقريرًا لسلطة المفهوم عليه، وهذا هو الوجه الذي به يصير المنطق – في تمثّله الأرسطيّ – آلة لممارسة الهيمنة المفهومية، إذ يُجعل فيه العقل قاضيًا على الخارج لا شاهِدًا عليه، وناطِقًا باسم الحق لا متلقِّيًا له، وهذا المعنى هو عين ما يغيب عن من لم يتبحّر في مناط النقد، ولم يترقّ في مدارج الفهم الكلامي-الوجودي، كما هو الحال مع فودة ومن شاكله، ممن يحسب أن ردّ ابن تيمية هو مجرد نقض لمادة أو صيغة، لا زعزعة لمناطٍ وتبديلٌ لجهةٍ في فهم العلاقة بين الفكر والعالم. فالنقد التيميّ إذًا لا يقف عند مقام الاعتراض على نتائج الأقيسة، بل يُعيد النظر في المسألة من أصلها، ويُسائل الأفق المفهوميّ الذي أُقيم عليه بناء البرهان المنطقيّ، فيكشف أن صورة الحدّ، وإن بدت مرتبة اصطلاحيًا، فإنها تنطوي على دعوى القبض على الكائن من جهة ما هو هو، لا من جهة ما يظهر ويجري، وهذه دعوى ميتافيزيقية خطرة، تُقحم العقل في موضع الربّ، وتنصب من اللغة محكمةً على الموجود، بدل أن تكون خادمة له في مقام البيان والتعيين. فهذه الرؤية، بما فيها من تعقيد فلسفي ونقد إبستمولوجي، هي التي لم يفقهها فودة، ولا دنَا من ساحتها، فانشغل بترديد اصطلاحات الصناعة، وظن أن الدفاع عن المنطق يكون بتقديس آلته، لا بتمحيص غاياته، فكان ممن قرأ الحواشي وغابت عنه المقاصد، وأخذ بالألفاظ وترك المعاني، ولبِسَ لَبوس المتكلمين وما تشبّه بهم في شيء. والحدّ، في هذا المنظور التيميّ النقديّ، ليس مجرد تعيينٍ تعريفيّ أو تركيبٍ تلقيحيّ بين جنس وفصل، بل هو في جوهره رتوشٌ صورية، تنبثق من عقلٍ غلبت عليه النزعة التقديرية، واستحوذت عليه غريزة التجريد، فاستحالَ الناظر في الموجودات لا إلى متلقٍّ لأنماطها المتعينة، بل إلى مفوِّضٍ لها أن تنصاع لصورةٍ سابقةٍ مرسومةٍ في الذهن، وكأن الحدّ هنا ليس غايةً توضيحية، بل أداة قهرية، تُرغِم الموجود على الامتثال لسلطة المعقول، وتُلبِس الكائن لُبوس المفهوم قبل أن يُدركه على نحو شهوديّ.
وههنا يظهر أن آلة المنطق ليست سوى الوسيلة الإجرائية لترسيخ هذه العلاقة المعكوسة بين الصورة والواقع، فبدل أن تكون الصورة تاليةً للانكشاف، صارت سابقةً على التعيّن، وبدل أن تكون المعرفة ناظرةً إلى الخارج على وجه التبعيّة، أضحت حاكمةً عليه بقوانينها المصطنعة. إذ يُبتدَأ بالتقعيد الكليّ، ثم يُسلّط على الجزئيّ، لا ليفسره، بل ليُحاكمه ويُعيد تشكيله ليتماهى مع المبدأ، وهذا انقلاب معرفيّ يُفضي إلى أن تستوي التصديقات على نحوٍ مُفرغٍ من الماهية التجريبية، فلا يُعتنى فيه بمادة القضايا، بل يُكتفى بصورة النسبة، ما دام الانتظام الشكليّ محفوظًا، والتقابل بين الحدود قائمًا.
ذلك أن الكليات، في منطقهم، تُنَزَّلُ منزلة المقدَّمات القبلية التي منها تُستخرج سائر المعارف، فهي الأصل والمرجع، بينما الجزئيات لا تُستحضَر إلا من باب التمثيل، لا من باب التأصيل، فصارت الحسيات أشبه بمُلحقٍ لتزيين البرهان، لا بمصدرٍ لإنتاجه. وهنا يتبدى سلطان القياس، بوصفه ليس مجرد ترتيبٍ منطقيٍّ بين مقدمتين يستتبع نتيجة، بل بنيةً قهريةً تُفرَض من خلال حدٍّ أوسطٍ، لا بوصفه نقطة تلاقٍ بين تصورين، بل بوصفه واسطة سلطوية تُحاكم من خلاله النتيجة لا بحسب تطابقها مع الخارج، بل بحسب اندراجها في منظومة الحدّ نفسه.
إذا استوت المقدّمات على صورة كليّات تجريدية، وتحوّل الحدّ الأوسط إلى نواة معيارية، فالقضايا المتفرعة عنها لا تخرج عن كونها تقارير تعكس المبدأ لا الواقع، وتستنسخ الصورة لا الكائن، وهذا عين ما ينتقده ابن تيمية من كون القياس الأرسطي – كما هو في جوهر صناعته – لا يستنطق الوجود، بل يُعيد إنتاجه وفق تراتبية عقلية لا تحتكم إلى المشاهدة، بل إلى الترتيب الذهني المسبق، الذي يغدو فيه كل استدلال استنساخًا لصورة ذهنية، لا تحقيقًا لكشف حقيقيّ. فهذه الهندسة المنطقية التي تُقَدِّم الحدّ الأوسط لا كجسر بل كمرآة للذهن، لا تلبث أن تُحوِّل العقل من كاشفٍ إلى حاكم، ومن متلقٍّ إلى مشرّع، ومن ناظرٍ في الخارج إلى منشئٍ له، فيغدو البرهان خاضعًا لمعيارية الانسجام الداخليّ، لا للمطابقة مع الخارج، وهو ما يجعل المنطق، في نسخته الأرسطية، أداة لتثبيت الاعتقاد الذهنيّ المعلَّب، لا لاختبار الصدق الوجوديّ. وهذا هو المأزق المعرفيّ الذي لم يتبيّنه من لا يحسن التمييز بين التصور الحاكم والتصور الكاشف، فتوهم أنّ حدّ “الإنسان حيوان ناطق” بيانٌ لحقيقة الإنسان، بينما هو في أصله تصييرٌ له إلى صورة ذهنية تُفرَض عليه من علٍ، وهو ما لا يُدرَك إلا بعد الغوص في أصول النظر، لا بمجرد التحصين اللفظيّ لمباحث الصناعة، كما هو دأب من اغترّ بالأقيسة، وغفل عن عللها الغائية. فالمعركة إذًا، ليست مع مادة القياس، بل مع وجهته وغايته، ولا مع الحدّ من حيث هو تعريف، بل من حيث هو تجريدٌ قهريٌّ يُراد به تسويغ السيادة العقلية على واقع لا يُطاوِع هذا التجريد إلا بالتكلف، وهي معركة لم يخضها من ظن أنّ الدفاع عن المنطق يكون بتمجيد رسمه، لا بنقد سلطته، ومن لم يعِ هذا، لا يُعتدّ بردّه، ولو حشد الأسفار، وأطنب في تصحيح صغرى وكبرى.
ففودة إذًا، وقد توهّم أنه ينصر المنطق، لم يُدرك أنّه يذب عن صورةٍ معرفيةٍ مغشوشة، تموّه نفسها تحت دعوى البرهان، وتستبطن إرادة تسلط مفهوميّ على الوجود، فانقلبت رسالته—من حيث لا يدري—إلى تقريرٍ لما كان ينبغي نقده، وتأصيلٍ لما كان ينبغي تفكيكه، فكأنّه استعمل قول المناطقة من غير تحقق بموضوعات الأقيسة، ولا تروٍّ في جهات الاستعمال، فجاء نصّه أقرب إلى الشغب المنطقيّ منه إلى التحرير الكلامي، وأشبه بنسخ ممسوخة لقول الحكماء، منه إلى مسلك المتكلمين المتمكنين من مناط الفهم والتحقيق. بل يشتدُّ الانكشاف، ويزداد النسق المنطقي افتضاحًا عند التماس الحدّ الماهوي بوظيفة اللغة، فإنّك تجد آلة الحدّ وقد تغوّلت على نظام البيان، فانقلبت اللغة من كونها ديوان المعاني، ومسرى الإشارة، ومهبط التعدد الدلاليّ، إلى محض أداة تصنيفية مفرغة من مقاصدها البلاغية، ومنزوعةٍ من سياقاتها التخاطبية، ومختزلةٍ إلى ترسيمٍ اصطلاحيّ موقوفٍ على مطابقةٍ ذهنيةٍ بين لفظٍ ومفهومٍ في قيد الماهية التقديرية، لا في فيض الوجود المتعيّن. وهكذا، يَغتَالُ هذا الصنيع المنطقيّ حيوية اللغة، إذ يُجردها من خواصها الانسيابية، ويُحمّلها بما ليس من طباعها: أن تكون آلةَ اختزال، لا مرآةَ إشراق، وأن تُقيد في نطاق الحدود، لا أن تنبسط على مدارات الإحالة والقرائن. فاللغة، في هذا السياق المنطقيّ المقولب، لا تُعدّ موصلةً إلى الحقيقة كما هي، بل موصولةً بالحقيقة كما قُدّرت في الذهن الصوريّ، فصارت إشاراتها لا تُحيل على الخارج بوصفه متعينًا متنوّع الاعتبار، بل تُحيل على مجموعات مفهومية مغلقة، تُصنّف الموجودات وفق قوالب الحدّ الأرسطيّ، حيث لا يُعترف للشيء بوجوده حتى يُدرَج في جنس، ويُلحَق بنوع، ويُركَّب من فصل، وتُبنى عليه قضيةٌ تُفرَّع عن مقدمة، وتُسلسل في قياسٍ يُربَط فيه الحدّ الأصغر بالأكبر عبر الأوسط، فيغدو الكائن أسيرَ هذه الشبكة الاصطلاحية، لا ناطقًا بوجوده، بل ناطقًا بما أُريد له أن ينطق به ضمن الترتيب الحدّيّ القهريّ. ومن هنا، فقولهم “الإنسان حيوان ناطق” ليس تبيينًا لحقيقةٍ تجريبية، ولا كشفًا عن واقعٍ معيش، بل تسويغٌ لحبس الكائن في قوالبَ مسبقةٍ من الفصل والجنس، يُراد بها اختزال التجربة الإنسانية إلى ماهية عقلية، تُفرض عليه قسرًا باسم التعريف، وكأنّ الإنسان لا يكون إلا إذا استوفى شروط الحدّ، ولا يُعترف له بالوجود إلا متى انسجم مع الصورة الذهنية المنتظمة في سلّم المقولات. فالماهية ههنا لا تُستنبط من الكائن، بل تُفرض عليه، والكلمة لا تُستخدم للكشف، بل للتقنين، فتُنتزع اللغة من طابعها البيانيّ الحيّ، وتُلبَس لباس المعادلة المفهومية، ويُجرَّد اللفظ من الإيحاء، ليصير مجرد حامل لمفهوم، لا حاملًا للمعنى.
وهكذا، تنقلب الوظيفة البيانية إلى وظيفة قياسية، ويصير الكلام آلة لإنتاج الماهيات، لا وسيلة للتعبير عن الواقع، وهذا هو عين التبديل الذي تنبّه إليه ابن تيمية، إذ رأى أنّ اللغة، حين تُستخدم على هذا الوجه، تفقد طابعها الطبيعي، وتتحول من وسيلة تعبير حيّ عن الموجودات إلى أداة تركيب صناعيّ يُعِدُّ الموجودات للانخراط في قضايا قياسية، حيث لا قيمة للتفرد، ولا اعتبار للجزئيّ، ما دام المطلوب هو مطابقة الصورة الكلية. وهنا يتبدّى الفرق الجوهري بين النظر التيميّ ومنزلق هذا المنطق المرسوم، فإنّ الأول يرى اللغة تجلٍّ للحضور المعنويّ المتعيّن، منفتحة على تعدّد السياقات، وملتحمة بالنظر في الخارج، بينما الثاني يقلبها إلى معبر قسريّ يفضي إلى الماهية المحدَّدة ذهنيًا، حيث لا يُلتفت إلى تعقيد التجربة ولا إلى تراكم التأويل، بل إلى انتظام الحدّ، وتحقيقه لشرائط الجنس والفصل، وصلاحيته للدخول في بنية القياس الصوريّ. ولنا أن نشك – بل نُقِيم الظن مقام اليقين – في أنّ سعيد فودة، في تمثّله لهذا المنظور التيميّ، لم يُدرِك هذه المزالق ولا تنبّه لهذه الإشكالات، إذ لم يكن اشتغاله إلا على ظاهر المسائل، يخلط بين الردّ والنقد، ويحسب حراسة الاصطلاحات بيانًا لمقاصدها، ويُطيل في حشد النقول دون فحص عللها الغائية أو تحليل أُطرها الكلّية، فما كان منه إلا أن حاكم ابن تيمية بمبادئ المنطق الذي هو موضع النزاع، فصار كالذي يُصادر على المطلوب، ويُثبت بالحدّ ما يُطلب نفيه، ويُعلّق الاعتراض على مشجب التجريح، لا على تحليل التركيب.
لا جرم أن من لا يُفرّق بين النقد بوصفه كشفًا لغائية النسق، والردّ بوصفه تفنيدًا لجزئيّة أو تخطئة لعبارة، لا يُرجى منه فهم عمق التأسيس التيميّ، الذي لا يقف عند تخطئة قضية، بل يُقوّض الجهاز كلّه، بوصفه آليةً مفروضةً لتحكيم العقل الكلّيّ على الوجود، وإخضاع الكائنات لصورة مسبوقة، لا مسبوقة بالكائن. وههنا يظهر فساد هذا المسلك عند من أنعم النظر، فإن هذه الصيغة التعريفية، وإن بدت منطقيّة من حيث الترتيب، فهي في الحقيقة مصادرة على المعنى قبل تمثّله، إذ تُنَصِّب العقل مقياسًا قبليًا على الموجود، وتُقحم اللغة في ميدان ضبط لا تعرفه، فتصير الألفاظ قيودًا مفهومية، لا علامات وجودية، ويغدو البيان آلة تنميط لا وسيلة تبيين، فيُفقَد التلقّي المشهدي، ويُستبدل به التأطير الحدّي، فالكلمة لا تدلّ إلا إذا خضعت لشرط الحدّ الجامع المانع، ولا تُحسَب معرفة إلا إذا جاءت في صورة تعريف مانع للغلط، جامع للحق، بحسب تصورهم. وهذا بعينه ما رفضه ابن تيمية، فإن اللغة عنده تابعة للاستعمال، وموصولة بالمقام، لا تتقوّم إلا بالعرف التداوليّ، لا بالحدّ الماهوي، فكل محاولة لجعلها آلةً لتعريف الماهيات إنما هي من جنس تطويع البيان لما لا يطيقه، وتكليف اللفظ بما لا يدلّ عليه في الأصل، فكان القياس المنطقيّ إذًا مقرونًا بجناية ثانية: تهشيم الدلالة البيانية، وسلب اللغة طبيعتها الحركية، وتحويلها إلى بنية جامدة لا تنطق عن الحياة، بل تصف المعقول كما تريده صورة العقل، لا كما يقتضيه الخارج. وبهذا، فإن سعيد فودة لم يكتفِ بخطأ في فهم الموقف التيمي من المنطق، بل سقط في جملة من الغفلات: أولها الغفلة عن غائية المنطق بوصفه نظامًا مفاهيميًا تسلطيًا، وثانيها التغافل عن تحوّل اللغة في هذا النسق إلى مجرد آلية تصنيف اصطلاحيّ فاقد للسياق، وثالثها وهمُ أنّ النصرة للمنطق لا تقتضي النظر في عواقب اشتغاله على البيان والمعرفة. فكانت رسالته تقريرًا لصورةٍ مغشوشةٍ للمعرفة، تنتحل اسم البرهان، وتحجب عن العقل بصره باسم البصيرة، وهو في ذلك أقرب إلى متكلّم مصطنَعٍ في ألفاظ المناطقة، منه إلى متكلّمٍ محقِّقٍ في مناطاتهم. ولعلّ أظهر ما يضاعف الريبة، ويزيد في فداحة الخلل، هو أننا لا نكاد نطمئن إلى أنّ سعيد فودة قد ألمّ أصلًا بهذه الرؤية النقدية التيميّة، بل لا نستبعد أن تكون قد فاتته جملةً وتفصيلًا، لا عن عناد، بل عن قصورٍ في التكوين، وضعفٍ في التأسيس الفلسفيّ والنقديّ، إذ هو لا يميز—في الأغلب الأعم—بين المراجعة البنيوية لمقدمات التصور المنطقي، وبين مجرّد الردّ الجدليّ الذي يجري على الظاهر من القول، ولا يخترق حجب المعنى إلى طبقات المقصد وغائية النسق. فالرجل، كما يبدو لمن اطّلع على مجمل تقاريره، يعامل القول النقدي كما يُعامَل الردّ الحواري، لا يتوسّل إليه بالأدوات الفلسفية التي تفكك البنية، بل يلجأ إلى التخطئة والاستدلال بما هو دون مرتبة الكشف عن أصول الموقف ومرامي الخطاب. فكأنه يتعامل مع الموقف التيمي لا باعتباره احتجاجًا على النسق من جهة سلطته الميتافيزيقية، بل باعتباره اعتراضًا لفظيًا على قواعد الصناعة، وهو فرقٌ من لم يُدرِكه، لم يُدرِك الموقف، بل أضاعه، وخانه حيث أراد نصرته
ولهذا، فإننا نرى أن ما سُمِّي بـ”تدعيم المنطق” لا يعدو أن يكون استئنافًا بائسًا لموقف لا يُدرَك إلا من داخل رؤيته الفلسفية، رؤيةٍ لا يحسن فودة مقاربتها إلا من خلال أدوات متهافتة، يُعوزها التمييز بين النقض المفهومي والنقاش القولي، فجهل أن النقد التيميّ هو تفكيك لنظام الاستدلال بوصفه تجريدًا قهريًّا، لا ردًّا سطحيًا على اصطلاح أو قاعدة. فبان بذلك أن فودة ليس من أهل هذا الشأن بالتحقيق، وإن ادّعى الانتساب، فإن المنطق عنده آلة ينبغي حراستها، لا خطابًا ينبغي مساءلته، واللغة عنده تابعة لحدود المفهوم، لا سابحة في فضاء البيان، والرد عنده يغني عن الفهم، والنقض عنده لا يحتاج إلى تأنٍ ولا تحصيل. فكان ما كتبه شبيهًا بقول من ظن أنه نصر، وهو في ذاته لم يفقه موضع النزاع.
رابط صفحة الكاتب على فيسبوك:
https://www.facebook.com/share/12K1LMeTT7t/



