قراءة نقدية في كتاب أبي يعرب المرزوقي “فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي”
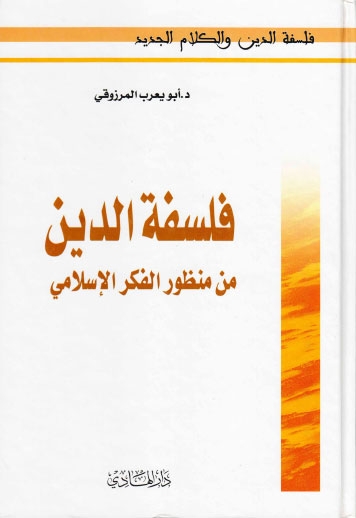
عز الدين جباري
فلسفة الدين أم فوضى القول؟ قراءة نقدية في كتاب أبي يعرب المرزوقي: “فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي”
مدخل تمهيدي
قراءة تحليلية متأنية لكتاب “فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي” تكشف أن سبب تعثّر تلقي مشروع أبي يعرب المرزوقي لا يكمن في إهمال متعمّد، بل في عيوب بنيوية في طريقة بسطه للمفاهيم، وضعف في هندسة خطابه، مما جعل فكره، رغم طموحه الفلسفي، غير قابل للنفاذ الفعال إلى المتلقي الباحث عن الفلسفة بمعناها الدقيق.
يأتي هذا المقال ليُبيّن بالأمثلة الملموسة كيف أن مشروع المرزوقي كما يتجلى في هذا الكتاب، ينهار عند أول امتحان نقدي، ليس بسبب ما يحويه من معانٍ وأفكار، وإنما بسبب طريقة عرضه لها. وهو ما سنبرزه من خلال قسمين رئيسيين: ملاحظات شكلية تتعلق بالتأليف والأسلوب، وملاحظات مضمونية تتعلق بالبنية الفكرية العميقة. وسنبدأ بالملاحظات المتعلقة بالمقدمة التي سماها “فاتحة” (ص: 5–11).
أولًا: الملاحظات الشكلية
1. ضعف الإبانة وتشتت الأسلوب
تفتقر فاتحة الكتاب إلى الحد الأدنى من مهارات التبويب والوضوح الأسلوبي، إذ لا يميز المرزوقي بين المقوِّم الأصلي والوجوه المتفرعة، رغم إعلانه أنه بصدد عرض “المقوّمين الجوهريين في كل وجود إنساني”، فلا نجد نقطة فاصلة، ولا فصلًا مفهوميًّا واضحًا بينهما، مما يستدعي من القارئ جهدًا تأويليًّا مضاعفًا. يقول:
[يبين بحث فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي أن فلسفة الحضارة الإسلامية ليست مقصورة على أحد وجوهها بل هي تشمل كل أبعادها كما تتعين في مقومي كل وجود إنساني: المقوم الإنساني أو فلسفة الدين التي تتفرع عنها كل الوجوه ذات الدلالة في تحديد المصائر التاريخية للأمم ثم هذه الوجوه المتفرعة كلها بمقتضى مستويات الفعل الإنساني القابل للتحديد في ضوء ضروب القيم …] ثم يشرع في تعديد القيم والتمثيل لها. فأنت تلاحظ أن هذه الجملة الطويلة جدا، لا تتيح استرجاع النَّفَس بفاصلة أو نقطة، ثم هو بعد ذلك لا يفصل بين المقوم والوجوه، ويسترسل بجملة طويلة لم يُهيّئ القارئ منهجيا لمتابعتها.
2. الأسلوب الاستطرادي غير المنتج
يكتب المرزوقي بأسلوب استطرادي يذكّر بطريق ابن تيمية في الجدل، لكنه لا يملك كثافته ولا نَفَسَه الجدلي، بل يغرق في تعبير غائم تتداخل فيه المفاهيم دون إحكام، ويتكرر التراكم اللفظي دون وضوح في المقصد، مما يجعل النص مُربكًا أكثر مما هو مُلهم. مثلًا حين يقول:
“ذلك أن هذا المقوم هو الذي يمكننا من إدراك ما به تكون الفروع قابلة للإرجاع إليه في الخصوصيات التاريخية لكل حضارة دون أن يفقد عموميته الكونية التي تمثل جوهر الإنسانية المشتركة.” فهي جملة طويلة مثقلة بالمصطلحات، دون تقسيم داخلي يُيسّر الفهم.
3. التوليد المفهومي الاعتباطي
كثرة المترادفات، وغياب التعاريف المضبوطة، وتحويل كل فكرة إلى حقل لفظي متشعب، كل هذا يُسهم في ضياع القارئ بين الكلمات بدل أن يُوصله إلى المعنى. إنه توليد للمفاهيم بلا اقتصاد ولا تبويب، بل شطحات لفظية تجعل النص شبيهًا بـ”قصيدة دادائية رديئة”. مثال ذلك قوله:
“ذلك أن الفكرة المقصودة هي الإقرار بوجود جوهر واحد للنفس الإنسانية تمثله وحدة المقوم الأصلي في الفروع المختلفة، وهي التي تجعل هذه الفروع رغم تباينها قابلة لأن تمثل حوامل قيم قادرة على تحقيق التعارف الذي تحدده آيات سورة البقرة.”
4. غياب البناء التدرّجي المنهجي
الفكر الفلسفي الحق ينطلق من العام إلى الخاص، ويصوغ مقدماته أولًا، ثم يعرض فروعه. أما المرزوقي، فإنه يقفز من المفهوم إلى نقيضه، ومن المجرد إلى اللاهوتي، دون سلم واضح. وهذا ما سنراه بوضوح أكبر في القسم المضموني.
ثانيًا: الملاحظات المضمونية
1. خلط منهجي بين العام والخاص
ينتقل المرزوقي في موضع واحد من تحليل كوني لمحددات العمران الإنساني، إلى التسليم بجوهر الرسالة الإسلامية كموجِّه لهذا التحليل، دون تقديم جسر عقلاني يربط المقدمات بالنتيجة. فبدل أن يُفرّع الخاص من العام، إذا به يقيّد العام بالخاص، ويجعل الدين الإسلامي هو المفسِّر الشامل لكل كونية مفترضة. يقول:
“وقد حاولنا في كثير من الأعمال حصر المقوم الأصل ووجوهه المتفرعة بالنسبة إلى الحضارة الإسلامية خاصة وبالنسبة إلى كل حضارة عامة من منطلق كونية المحددات التاريخية لكل عمران بشري وكليتها كما يسلم بذلك كل من فهم جوهر الرسالة الإسلامية. فاستناد الإسلام إلى الفطرة (…) “.
2. الانتقال الفج من التأمل الفلسفي إلى التسليم اللاهوتي
ما يبدأ كمقالة فلسفية عن النفس والتعارف والكونية، ينتهي فجأة إلى تأكيدات عقدية مثل: “كما يسلم بذلك كل من فهم جوهر الرسالة الإسلامية”، وهو انتقال غير ممهد منطقيًّا، يُربك النسق الفلسفي للمعالجة.
3. طوباوية طهرانية في فهم الدين والصراع
يُقدّم المرزوقي الدين كوسيلة للقضاء على غريزة الصراع الحيواني، و”كنس ما هو ميت في الحضارة”، والارتقاء إلى مستوى الإخاء الإنساني. ثم يقول:
[… فإن جوهر الكنس هو التحرر من الكفر بالطاغوت تمهيدا للإيمان بالله الصادق أعني مصدر كل حياة مبدعة إذ القرآن يعتبره استمساكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها (…) ومن ثمة فهي صحوة روحية بالأساس …]
لكن هذا التصور يخالف الواقع منذ فجر الإسلام إلى يومه الراهن، كما يخالف القرآن نفسه، الذي يُقِرّ بأبدية الصراع بوصفه فتنةً وشرطًا للتمايز:
• ﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين﴾ [هود: 118]
• ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض﴾ [البقرة: 251]
• ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ [الفرقان: 20]
فالدين لا يكنس الصراع بأن يُلغيَه، بل يُوجهه أخلاقيًّا، وأما الطموح الطهراني إلى “قلع الصراع من جذوره” فليس إلا يوتوبيا أخلاقية رومانسية تُقوِّض إمكان التفاعل مع سنن التاريخ.
خاتمة: أين يكمن الإخفاق؟ وما البديل؟
لا يمكن القول إن أبا يعرب المرزوقي مُهمّش عن سوء نية. بل إن السبب الحقيقي لتعثّر مشروعه الفكري هو افتقاده إلى أدوات التبليغ الفلسفي الرصين، ووقوعه في الخلط بين اللاهوتي والفلسفي، والتداخل بين البلاغي والمفهومي، كما أن طموحه التأويلي لا يتناسب والقدرة التحليلية.
ومن منظور فلسفة الصيرورة الأصيلة، فإن ما ينقص مشروع المرزوقي – كما ينقص غيره من المشاريع العربية – هو النفاذ إلى البنية التكوينية للوجود، وتجاوز النزعة التوفيقية التلفيقية، نحو بناء مفاهيم دقيقة حية تنبثق من التوتر البنيوي للصيرورة.
بعض المفاهيم البديلة التي نقترحها:
• جوهر المسافة: وأعني به الفضاء الذي يُمكّن الكينونات من التمايز دون تصادم، ومن التفاعل دون ابتلاع. في هذا الجوهر تنشأ الحرية الأخلاقية، لا في الانطباق ولا في الانفصال التام.
o مثال ملموس: لا يتحقق معنى الكرامة إلا إذا احتفظ الغير بمسافة تكوينية عني، تمنعني من ابتلاعه أو التماهي به، وتحفظ له حق التفرد.
• التوتر الوجودي: هو اشتداد الكينونة بين نداء الأصل ومقاومة الفناء. التوتر ليس عرضًا بل قوام الوجود.
o مثال ملموس: موقف إبراهيم عليه السلام في لحظة الذبح؛ ليس فعلًا رمزيًّا، بل ذروة التوتر بين أمر الإله وصوت الأبوة، وهو ما يجعل الموقف حدثًا وجوديًّا لا تشريعيًّا.
• الصراع الأخلاقي: الصراع ليس شرًّا مطلقًا بل مجالًا للتكامل التكويني بين الذوات. الفارق بين الصراع العدمي والصراع الأخلاقي هو في البوصلة، لا في وجود التنازع.
o مثال ملموس: اختلاف الأنبياء مع أقوامهم لم يكن لإنهاء التعدد، بل لإعادة توجيه التنازع نحو وجهة كرامية، كما في حوار موسى وفرعون، أو نوح وابنه.
• الوجه: ليس مظهر الجسد، بل الحقل الذي يلتقي فيه الغيب بالمرئي، ويُكشَف فيه المعنى دون أن يُستَنفد. كل وجه يحمل نداء أصله.
o مثال ملموس: في قوله تعالى ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾، يظهر أن الوجه هو الأفق، لا الموضع، وأن التوجّه بالنية الحقة كافٍ ليحمل أثر الحضور الإلهي.
o أو طفل محروم من الحنان، في دار رعاية، يحتضنه زائر بحنان صادق، فينكمش الطفل أولًا، ثم يتفتّح وجهه تدريجيًا في لحظة من الدهشة المؤلمة: “أأنا مستحق لهذا العناق؟”
الوجه هنا يُجسّد دهشة الاعتراف، لحظة انكشاف الكرامة الغافلة عن ذاتها.
بهذه المفاهيم، نؤسس لنمط من التفكير لا يُعيد إنتاج الكلام القديم بصياغات محدثة، بل يحفر في البنية الوجودية للمعنى، ويستخرج منها شروط فعل التفكير ذاته. وبهذا فقط، ننتقل من إعادة الترتيب إلى إبداع البديل، ومن الجدل المنتكس إلى الرفع الحافظ (Aufhebung) الذي يُنتج فكرًا يرقى إلى شرائط الفلسفة الحقة.



