قراءة في كتاب الدين والمجتمع للباحث المغربي عبد الغني منديب
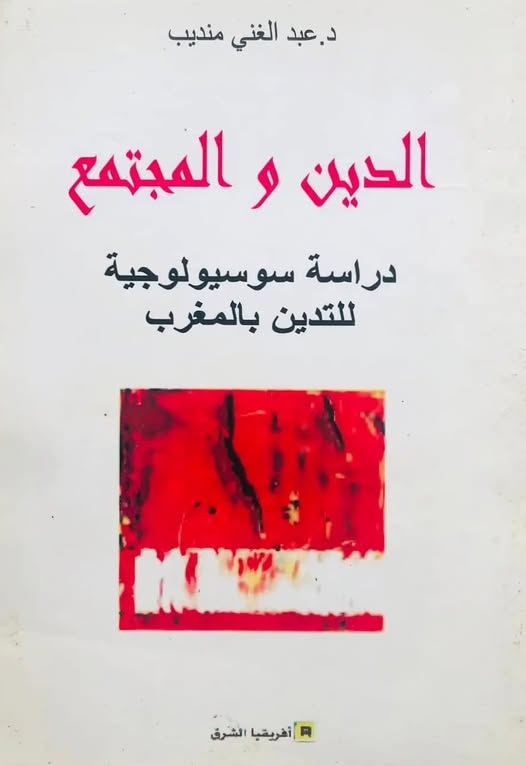
ماجدة الغروادي
هذه قراءة في كتاب “الدين والمجتمع، دراسة سُوسيولوجية للتدين بالمغرب” لصاحبها عبد الغني منديب، والصادر منذ سنوات عن دار النشر إفريقيا الشرق، تبلغ صفحاته 240 صفحة.
تبحث هذه الدراسة في موضوع التدين، وتحاول تحديد الدلالات والوظائف التي تؤديها الممارسات الدينية بالمجتمع الدكالي بوسط المغرب، يدرس الباحث التدين كممارسة وسلوك اعتيادي يومي، عرض في الفصل الأول ثلاث اتجاهات رئيسية عالجت موضوع المعتقدات والممارسات الدينية. الاتجاه الأول متمثل في أبحاث إدوارد فستر مارك (الدراسات الاستشراقية)، أما الاتجاه الثاني فهو متمثل في الدراسات الكولونيالية، في حين يتمثل الاتجاه الثالث في الدراسات الأنثروبولوجية والأنجلوساكسونية. والغاية من عرض هذه الدراسات، معرفة الخلاصات والاستنتاجات التي توصل إليها الباحثين في تلك الفترة من تاريخ المغرب. وما يجمع كل هذه الدراسات، تبنيها أطروحة البقايا الوثنية. وقد انتقد الباحث هذه الأطروحة، بدءً من لحظة فسترمارك حتى لحظة جاك بيرك.
اختار الباحث منطقة دكالة كعينة تمثيلية للمجتمع المغربي لظروف ذاتية وأخرى موضوعية، كون هذه المنطقة تمثل حياة القرويين البسيطة، طالما كانت عرضة للتأثيرات الداخلية والخارجية منذ فجر التاريخ، لم تكن معزولة أو منغلقة على ذاتها. وقد اختار من هذه المنطقة خمس دواوير من خمس جماعات قروية (دوار أولاد فقيرة من جماعة بوحمام، دوار أولاد هلال من جماعة الجابرية، ودوار الحياينة أولاد شعير من جماعة أولاد سبيطة، ودوار الرواحلة من جماعة سيدي عابد، ثم دوار سيدي موسى بن علي من جماعة أولاد غانم). حاول الباحث ما أمكنه أن يختار دواوير متباعدة فيما بينها لرصد أي تعدد وأي اختلاف مُحتمل على المستوى الطقوسي والممارساتي. وقد تمثلت عدة اشتغاله المنهجية في الملاحظة والملاحظة بالمشاركة والمقابلة المعمقة. وبلغ مجموع المقابلات مائة مقابلة، شملت ثمانين منها العينة الرئيسية التي تتراوح أعمارها بين 25 سنة و50 سنة، تم توزيعها بالتساوي بين الجنسين. وتم تخصيص العشرين المتبقية لمن تفوق أعمارهم الخمسين سنة، من الجنسين.
من أولى النتائج التي تم التوصل إليها، هي أن الاعتقاد الديني في هذه الدواوير مُوحد رغم بعض الاختلافات البسيطة. يتمثل المقدس في شيئين: المساجد والأضرحة، مجالين مقدسين يشكلان جوهر الاعتقاد الديني الدكالي.
ولكي يتوصل الباحث إلى مجمل المواقف والمرجعيات البديهية التي تنتظم بها الحياة اليومية عند الدكاليين، استلهم مفهوم “النظرة إلى الكون” الذي صاغه ماكس فيبر، وعمل باحثون آخرون على توضيحه وتأصيله داخل هذا المجال. وقد ميز منديب بين ثلاث مفاهيم أساسية داخل مجمل التصورات المكونة لنظرة الكون عند المبحوثين: (الله، الدنيا، الصلاح) تعد هذه المفاهيم الثلاث صياغة مشتركة لنظرة الدكاليين تجاه الكون، أي الكيفية التي يدركون بها واقعهم والمعنى الذي يضفونه على عالمهم.
النتيجة الثانية تكشف عن نمط تدين بالمجال الدكالي، الذي هو نموذج من نماذج التدين بالمجتمع المغربي عموما؛ يتعلق الأمر بنمط تدين شعبي. هذا النمط تم الكشف عنه من خلال الطقوس والممارسات الدينية. جاء تقسيم الباحث كالاتي: ممارسات يومية تتمثل في البسملة، والحمدلة، والاستغفار والتعوذ، والدعاء واللعنة (ثنائية الجزاء والعقاب) ثم الصلاة (تكافؤ منشود وتفاوت مشهود). في هذه النقطة هناك إشارة من الباحث إلى أن الدراسات الكولونيالية أهملت الممارسات الدينية ذات الطابع الإسلامي، لم تتعرض لها بالدراسة والتحليل بسبب انكبابها في البحث عما يصلح لأطروحتها الاستعمارية (البقايا الوثنية)، خدمة لمشروعها الأيديولوجي. لذلك اهتم الباحث بصلاة الدكاليين (اختار دوار واحد: أولاد فقيرة)، حيث يبلغ عدد سكان هذا الدوار 1191. وقد توصل إلى أن هناك نوع من الإهمال والتفريط في الصلاة بسبب عدة اكراهات مرتبطة بالواقع المعيش اليومي للدكاليين، وأن عدم الاهتمام بالصلاة لا يعني أنهم خارج الدائرة الاعتقادية والانتماء الديني والهوياتي. أما الممارسات الموسمية فهي تتمثل في عاشوراء، والعيد المولد النبوي، ورمضان وعيد الفطر، والحج، ثم عيد الأضحى. ويؤكد منديب وجود حماس ديني شديد في بعضٍ من هذه الممارسات، هناك قدسية وكثافة على مستوى الممارسة (رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى). أما الممارسات الظرفية فهي طقوس تؤدي وظيفة استشفائية وعلاجية مهمة، إنها بمثابة ترياق ضد القلق والتوتر، تتمثل أساسا في زيارة الأضرحة، والطقوس الجنائزية والختان.
ما خلص إليه الباحث عموما، أن تدين الدكاليين يتوافق مع الحس المشترك والوعي الجمعي، ولا تتأتى دراسته في استقلال تام عن الشروط الاجتماعية، هذا التدين يستمر في وجوده ليس فقط بسبب توافقه مع الحس المشترك وانسجامه مع التنظيم الاجتماعي، بل أيديولوجية الدين الرسمي للدولة لها دور في المحافظة عليه كذلك، حيث تدعم استمرار بعض الممارسات والطقوس المتعلقة بالأضرحة وبالاعتقاد في القدرات الخارقة للأولياء من خلال السماح لها بالوجود ( وجود مزارات ومؤسسات دينية ضخمة)، والاعتراف بشرعية هذا الوجود ( دعم الزعامات الدينية وتنظيم المواسم كموسم مولاي عبد الله…)، وتقديم مساعدات مالية (ضريح مولاي عبد الله يستفيد من هبات ملكية، دعم الزعامات المحلية المرتبطة به: إعفاء من الضرائب على أملاك الضريح، توليهم مناصب عليا داخل جهاز الدولة، الترشح للانتخابات…). وقد كشفت النتائج بأن زيارة الأولياء تشمل كل الفئات الاجتماعية سواء الغنية منها أو الفقيرة، المتعلمة أو التي لم تتلقى تعليمًا قطُّ.
مجمل القول، يقر الباحث بأن نمط تدين الدكاليين كان محط اعتراض ونفور من لدن الحركات الإسلاموية، حيث تراه منافٍ للعقيدة وكانت تعمل على محاربته وترسيخ مذهبية جديدة، إلا أنها فشلت في مشروعها السياسي ولم تستطع كسب تأييدهم وتعاطفهم.
إن جوهر الاعتقاد الديني ثابت ولا يتحول، ما يتغير هو الشكل الذي يتجسد عبره هذا الاعتقاد على مستوى الواقع؛ الإسلام كدين ثابت، إلا أنه كممارسات وتمثلات يختلف كليا من فرد إلى آخر ومن جماعة الى أخرى. بالنسبة للباحث هذه الدينامية لم تكشف عنها الدراسات الكولونيالية والاستشراقية، إلاّ أن الدراسات الأنثروبولوجية والأنجلوأمريكية، بالأخص التأويلية، ركزت على دراسة التحولات التي عرفتها بعض الأشكال الدينية (عاشوراء: أصبح مجرد يوم لا معنى له\ تطور الاعتقاد في الأرواح…).
يربط الباحث أسباب هذا التحول الاعتقادي بالتحولات التي شهدتها البنية الاجتماعية للمجتمع المغربي، حيث أنها بنية مرنة وقادرة على استيعاب التحولات الكبرى، وما يضمن استمرارية بعض أشكال التدين رغم عدم معقوليتها هو قدرتها على تفسير النشاط الاجتماعي تفسيرًا مقبولاً ومتماسكًا ومنطقيًّا بالنسبة لحامليها والمؤمنين بها.



