قراءة في كتاب: إتحاف نبلاء الساحة بآثار فضلاء حاحة لمؤلفه الفقيه محمد ألواح التيگوتي
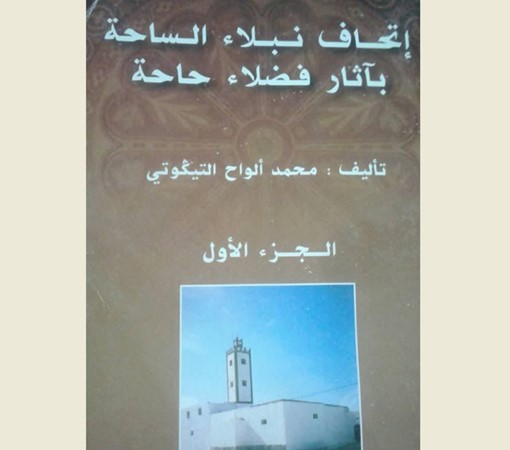
حمزة مولخنيف
يشكّل كتاب “إتحاف نبلاء الساحة بآثار فضلاء حاحة” لمؤلفه الفقيه محمد ألواح التيگوتي، في جزأيه، واحداً من الأعمال المرجعية النفيسة في مجال الكتابة التاريخية المحلية بالمغرب، بل يمكن اعتباره نصاً جامعاً بين التراجم والأنساب، والتأريخ الثقافي والديني، والبحث السوسيولوجي والأنثروبولوجي.
فهو ليس مجرّد تجميع لأسماء الأعلام أو عرضٍ للأنساب والطبقات، كما درجت عادة كثير من المصنفات التراثية، بل هو مشروع معرفي متكامل يروم إعادة الاعتبار لمنطقة حاحة ورجالاتها عبر قرون، من خلال إعادة إحياء الذاكرة الجماعية وربطها بالبنية الوطنية الشاملة للهوية المغربية.
وفي هذا السياق، يصبح الكتاب بمثابة مرآة تعكس عمق التجربة الدينية والاجتماعية والثقافية التي طبعت المنطقة، وتبرز تفاعلها الخصب مع التحولات الكبرى التي عرفها المغرب الوسيط والحديث.
أهمية هذا العمل تتبدّى منذ العنوان ذاته؛ فهو “إتحاف” أي هدية معرفية للقارئ والباحث، موجهة إلى “نبلاء الساحة” أي المهتمين بالثقافة المغربية، يقدم لهم “آثار فضلاء حاحة”، أي الإرث الرمزي والعلمي والروحي الذي خلّفه علماء وصلحاء وفقهاء وأدباء هذه المنطقة.
والكتاب في جوهره ينتمي إلى تقليد عريق في الثقافة المغربية هو تقليد كتب التراجم والأنساب والطبقات، مثل “التشوف إلى رجال التصوف” لابن الزيات، ودوحة الناشر لابن عسكر الشفشاوني، والمستفاد للتميمي، والإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام للقاضي بن ابراهيم السملالي، والمتعة والراحة في تراجم أعلام حاحة للتامري، والمعسول لمحمد المختار السوسي.
غير أنّ ما يميز عمل التيگوتي هو أنه لا يكتفي بالتأريخ للأفراد، بل يربطهم بسياقاتهم الاجتماعية والثقافية، محاولاً أن يقدّم قراءة أقرب إلى السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، مما يمنح نصه نَفَساً مختلفاً وأفقاً أوسع.
لقد حرص المؤلف على إبراز المكانة المركزية للفقهاء والصلحاء في المجتمع الحاحي، حيث لم يكن الفقيه مجرد مُعلّم للعلوم الشرعية أو إماماً في محراب المسجد، بل كان شخصية محورية تجمع بين المرجعية العلمية والسلطة الأخلاقية. فقد اضطلع الفقهاء بدور الضامن الرمزي للتماسك الاجتماعي، إذ كانوا يُستشارون في القضايا القبلية الكبرى، ويتدخلون في فض النزاعات، ويحفظون الأنساب، ويوجهون السلوك الجماعي وفق ميزان الشرع والعرف.
إن الفقه هنا لم يكن علماً مدرسياً مجرداً، بل علماً حيّاً مرتبطاً بالحياة اليومية، يمارس تأثيره في القرارات الجماعية والعلاقات القبلية، ويسهم في صناعة التوازنات الكبرى داخل المجتمع. بهذا المعنى، يظهر الفقيه في المجتمع الحاحي بمثابة محور رمزي يتجاوز حدود المسجد والزاوية والمدرسة العلمية العتيقة إلى عمق النسيج الاجتماعي والسياسي.
وإلى جانب الفقهاء، أفرد الكتاب مساحة واسعة للصلحاء وزواياهم، الذين شكلوا عبر قرون مراكز الثقل الروحي والرمزي للقبائل الحاحية. فالصلحاء في نظر التيگوتي، لم يكونوا مجرد متعبّدين منعزلين، بل كانوا علامات روحية كبرى استمدت منهم القبائل شعوراً بالهوية والاستمرارية. الزوايا والمقامات التي ارتبطت بهم لم تكن أماكن عبادة فحسب، بل فضاءات جامعة يتقاطع فيها الديني بالاجتماعي، والروحي بالاقتصادي، والسياسي بالثقافي.
والمواسم المرتبطة بزيارة الأولياء تحولت إلى لحظات جماعية كبرى تُعيد إنتاج التضامن القبلي، وتفتح المجال للتبادل التجاري، وللتواصل الثقافي بين القبائل. بذلك، تصبح ظاهرة الولاية مفتاحاً لفهم الأنثروبولوجيا الدينية لحاحة، حيث يُنظر إلى الولي كوسيط رمزي بين السماء والأرض، وضامن للخصب، وحامٍ للجماعة من التشتت والانقسام. إنّ هذا البعد الرمزي يبرز كيف أن الصلحاء لم يكونوا مجرد أفراد، بل مؤسسات اجتماعية وروحية متجذرة في الوجدان الجمعي.
ومن زاوية أخرى، يكشف الكتاب عن الحضور الأدبي والفني القوي في المنطقة، من خلال استحضار أسماء الشعراء والأدباء الذين تركوا بصماتهم في ذاكرة القبيلة. فالشعر في حاحة لم يكن ترفاً فنياً أو نشاطاً نخبوياً، بل ممارسة اجتماعية حيّة تمارس وظيفة مزدوجة: فهو من جهة خطاب جمالي وإبداعي، ومن جهة ثانية وثيقة اجتماعية تعكس المواقف والأحداث والمشاعر الجمعية.
في قصائد الملحون والفصيح نجد تصويراً للحب والحنين، ورثاءً للموتى، ومدحاً للأولياء، ووصفاً للطبيعة والأرض، ما يجعل الشعر مخزوناً رمزياً أساسياً لفهم نفسية المجتمع الحاحي، وسجلاً رمزياً يحفظ لغته وإيقاعاته وتصوراته عن العالم. بذلك يصبح الأدب، إلى جانب الفقه والولاية، ركناً ثالثاً من أركان البنية الرمزية للمنطقة، ويعكس ثلاثية مغربية عريقة قوامها الفقه والدين والأدب.
إن القيمة المضافة الكبرى لكتاب التيگوتي هي أنّه لا يقدّم الأعلام باعتبارهم أسماء معزولة، بل باعتبارهم عقداً في شبكة اجتماعية معقدة. فالفقهاء والصلحاء والشعراء كانوا مرتبطين بالقبائل وبالزوايا، وبعلاقات القرابة والمصاهرة، وهو ما يجعل دراسة سيرهم بمثابة مدخل لفهم البنية الاجتماعية والسياسية للمجتمع الحاحي.
فالزوايا مثلاً، لم تكن مجرد مؤسسات دينية، بل كانت أيضاً وسائط للوساطة بين القبائل والسلطة المركزية، ومجالات لإنتاج المعرفة والتعليم التقليدي، وأدوات لدمج العرف القبلي بالشرع الإسلامي. وهنا يقدم الكتاب صورة عن كيفية اشتغال السلطة الرمزية داخل المجتمع، وعن تداخلها مع السلطة السياسية، بما يكشف عن دينامية غنية تتجاوز السرد التاريخي البسيط.
ولعل ما يميز عمل التيگوتي أيضاً هو الوعي الإبستمولوجي الذي يوجّه كتابته. فهو يدرك أن التدوين حول الأعلام ليس مجرد عمل وصفي، بل هو في جوهره فعل لإعادة إحياء الذاكرة الجماعية، وبناء لرأسمال رمزي تحتاجه الأجيال لفهم تاريخها وربطه بالوطنية الجامعة.
وفي هذا السياق، يغدو التأريخ المحلي أداة لمقاومة النسيان، ووسيلة لإعادة إدماج “الهامش” في سردية الوطن. إنّ حاحة، التي طالما همشتها المركزيات الحضرية الكبرى، تظهر هنا كفضاء حضاري وروحي وعلمي أسهم بعمق في تشكيل الهوية المغربية. ومن ثم، فإن الكتاب يُعيد صياغة مفهوم “المجال”، ليس باعتباره مجرد جغرافيا، بل باعتباره وحدة متداخلة يتقاطع فيها الديني بالسياسي، والعرف بالشرع، والعلمي بالأدبي.
بهذا المعنى، يصبح “إتحاف نبلاء الساحة بآثار فضلاء حاحة” أكثر من مجرد كتاب في التراجم أو التاريخ المحلي، بل هو نصّ بانورامي يقدم صورة شاملة عن المجتمع الحاحي في أبعاده المتعددة: الدينية والفقهية، الروحية والرمزية، الأدبية والجمالية، والسوسيولوجية والأنثروبولوجية.
إنه نصّ يأنسن التاريخ، إذ يقدّم الأعلام لا كأسماء جامدة أو تواريخ ميلاد ووفاة، بل كشخصيات لحم ودم أثرت في حياة الناس اليومية، وتركَت آثارها في الحكايات الشعبية، وفي الأمثال، وفي المواسم والزوايا.
وخلاصة القول، فإن هذا الكتاب هو مشروع لإعادة كتابة الهوية المغربية من خلال ذاكرة محلية مخصوصة. لقد استطاع الفقيه محمد ألواح التيگوتي أن يمنح لصوت حاحة مكانتها داخل الذاكرة الوطنية، وأن يبرهن على أن الهوامش ليست ثانوية، بل هي مراكز للمعنى والرمز، وأن التاريخ لا يُكتب فقط في المدن الكبرى والعواصم، بل أيضاً في القرى والقبائل، في الزوايا والمواسم، وفي الأشعار والأحلام.
من هنا تبرز قيمة الكتاب المزدوجة: فهو من جهة مصدر أساسي لدراسة تاريخ المنطقة وأعلامها، ومن جهة ثانية نصّ يفتح آفاقاً لفهم كيفية تشكّل الذاكرة الجماعية المغربية عبر تفاعل الدين والمجتمع والأدب في فضاء محلي تحوّل بالتوثيق إلى جزء أصيل من الذاكرة الوطنية الجامعة.
إنّ كتاب “إتحاف نبلاء الساحة بآثار فضلاء حاحة” بما يحمله من غنى معرفي وتاريخي، يقدّم لنا أكثر من مجرد تراجم لأعلام أو سرد لأحداث؛ إنه نصّ تأسيسي في الذاكرة الثقافية المغربية، ومنصة لفهم آليات اشتغال المجتمع الحاحي في أبعاده المتعددة.
فما ينجزه المؤلف محمد ألواح التيگوتي هو إعادة بناء لسيرة جماعية لا تختزل في الأسماء بل تنفتح على البنى، ولا تقتصر على الحوادث بل تنفذ إلى الرموز، ولا تكتفي بالتوثيق بل تؤسس لرؤية شمولية تجعل من حاحة مرآة مصغّرة للهوية المغربية.
لقد بيّن هذا الكتاب أنّ الفقهاء كانوا حجر الزاوية في بنية المجتمع الحاحي، إذ جسّدوا سلطة العلم والشرع، وصاغوا المرجعية الأخلاقية التي تحفظ التوازنات القبلية. وبيّن أيضاً أنّ الصلحاء وزواياهم مثّلوا مراكز روحية جامعة، تجاوزت حدود التعبّد لتصبح فضاءات للوساطة والتربية والتضامن الاجتماعي، وضمانة لهوية جماعية متماسكة.
كما أظهر أن الشعراء والأدباء لم يكونوا مجرد مبدعين أفراد، بل صوت الجماعة ولسان حالها، حافظوا ببلاغتهم وإيقاعاتهم على ذاكرتها الحية، وعبّروا عن وجدانها العميق.
إنّ القيمة الجوهرية لهذا العمل تتجلى في أنه ينتصر للهامش، فيعيد إلى منطقة حاحة موقعها المستحق في خريطة التاريخ والثقافة المغربية. فالمؤلف لا يكتب عن “منطقة معزولة” بقدر ما يكشف عن فضاء دينامي تفاعل مع الدولة والمجتمع، وأسهم في إنتاج المعرفة، وفي تأطير الحياة الروحية، وفي إثراء الأدب المغربي بمختلف أشكاله.
ومن هنا تبرز أهميته كمصدر سوسيولوجي وأنثروبولوجي، إذ يتيح للباحثين اليوم فرصة لفهم كيفية تداخل الدين بالاجتماع، والفقه بالعرف، والروح بالأرض، في بنية محلية تعكس أفقاً وطنياً أوسع.
وإذا كان التاريخ الرسمي غالباً ما يركّز على العواصم والمدن الكبرى، فإن هذا الكتاب يذكّرنا بأن الذاكرة الوطنية لا تكتمل إلا بجمع أصوات الهوامش، وأن ما يُعتبر “هامشاً” ليس إلا مركزاً آخر للمعنى. فالمجتمع الحاحي، بما أنتجه من علماء وصلحاء وأدباء، وبما نظمه من زوايا ومواسم، لم يكن على هامش التاريخ، بل كان شريكاً في صناعته، ومساهماً في بلورة ملامح الهوية المغربية الجامعة.
وعليه، فإنّ “إتحاف نبلاء الساحة بآثار فضلاء حاحة” ليس كتاباً من الماضي فحسب، بل هو نصّ للمستقبل أيضاً. فهو يقدّم للجيل الحاضر وللأجيال القادمة درساً في قيمة الذاكرة، وفي ضرورة رد الاعتبار للثقافات المحلية باعتبارها ركيزة للهوية الوطنية. كما يذكّر بأن بناء الحاضر لا يكون إلا بفهم الماضي، وأن استشراف المستقبل يتطلب إنصاتاً عميقاً للأصوات التي شكّلت وجداننا الجماعي.
إنّ الخلاصة الكبرى التي يفضي إليها هذا الكتاب هي أنّ المعرفة بالهامش تعني في العمق معرفة بالذات، وأن الاحتفاء بفضلاء حاحة هو احتفاء بجزء أصيل من المغرب العميق، بذاكرته ورموزه ومؤسساته.
وهنا يكمن البعد الرسالي لهذا العمل: إنه لا يسجّل فقط “تاريخاً محلياً”، بل يؤسس لوعي جماعي جديد، يرى في التنوع ثروة، وفي التعدد مصدر قوة، وفي إعادة إحياء الذاكرة المحلية خطوة أساسية نحو صيانة الذاكرة الوطنية وحمايتها من التآكل والنسيان.



