في نقد العقل المادي المجرد: الحلقة الرابعة
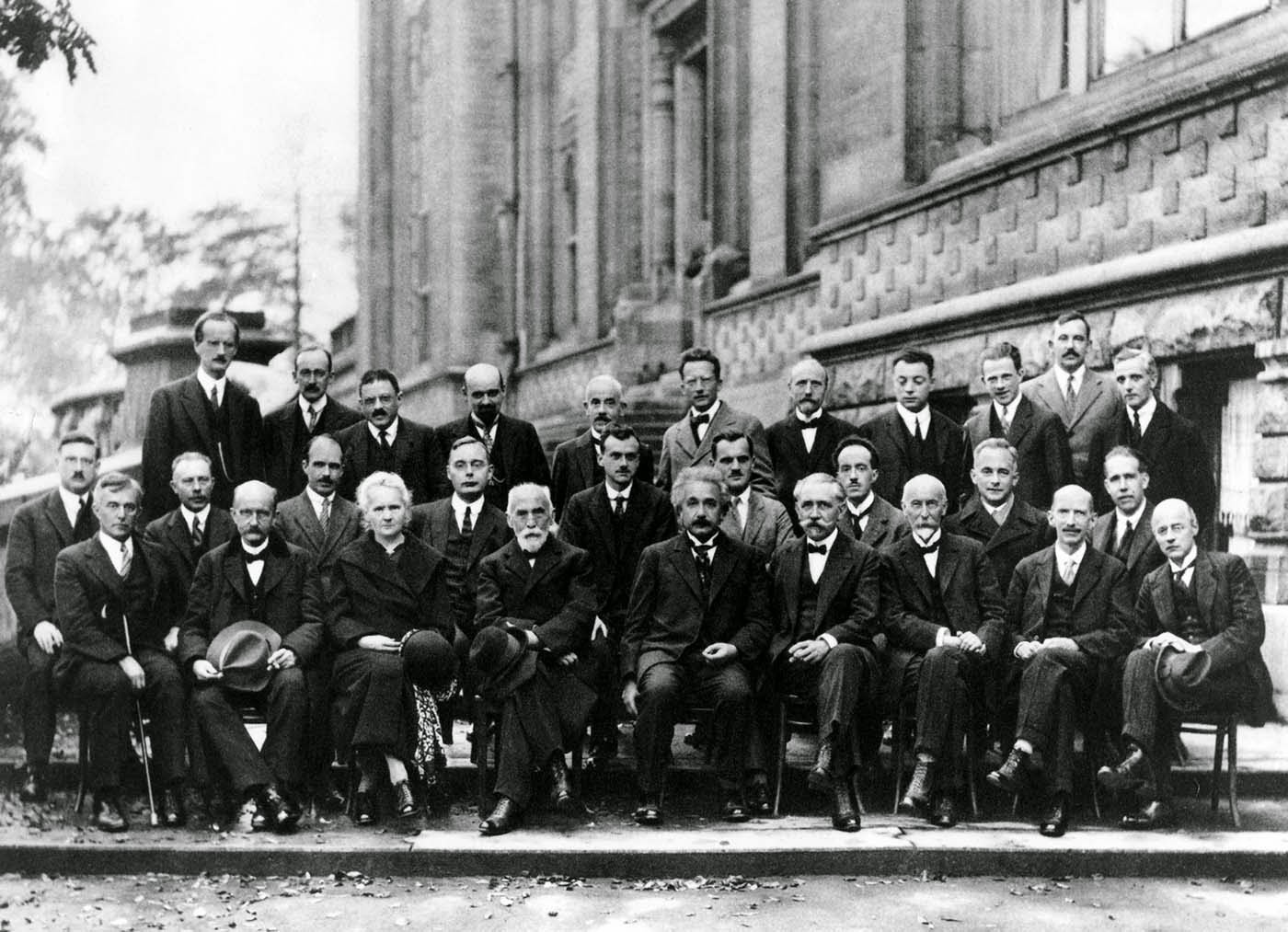
طارق حنيش
إن الاعتراف بقصور التفكير العقلاني الصوري لم يكن مقتصرا على أهل الإشراق وأرباب الكشف، بل تسلل إلى أروقة الفلسفة العقلانية الحديثة، حتى عند أولئك الموسومين بالصرامة المنهجية والالتزام الآيديتيكي، فإنهم – وقد تأملوا نتائج العقل العلمي – لم يجدوا بدا من الإقرار بأن للعقل حدا لا يتعداه، وأن الفكر إذا استغلق على ذاته انقلب إلى وهم منطقي يعيد إنتاج ذاته لا اكتشاف غيره. وقد عبر عن هذا المعنى جونستيت أبلغ تعبير، على خطى ألفرد نورث وايتهد، حين وصف هذه المدرسة الحديثة التي ابتنت على التفكير الآيديتيكي المغلق، بأنها ليست إلا فسحة فلسفية تعيد في بنيتها ما كانت تزعم أنها تتجاوزه، وكأنها تقيم علة هدمها في أساس بنائها. وهذا الوصف، وإن جاء في ثوب اصطلاحي حديث، فمعناه مدركٌ عند المتكلمين، فإنهم لطالما نبهوا إلى أن العقل إذا استقل بنفسه، ولم يستضأ بنور الوحي أو البيان الفطري، تردى في الدور أو تسلسل العلل، أو انحرف إلى تحكيم الصور دون المعاني.
لقد كان لجاينش سهمٌ مشهودٌ في بيان هذه الأزمة الكامنة، إذ أسهم في فلسفة العلوم الحديثة، بعمله المرموق Dialectica، الذي صار، بفضل تحقيق بيرنيز وباشلار وجونستيت، منارة تهدي أهل النظر الطبيعي، وخصوصا في أفق الحلقة الفلسفية التي احتضنها جونستيت. وليس بخاف على من غاص في دقائق تلك الحلقة أن ما طرح في الاجتماع الأول بزيوريخ، كان منعطفا غير مسبوق في تاريخ الفلسفة، حيث رقى جان لوكاسيفيتش المنطق الافتراضي إلى مرتبة المنطق التعددي القيمي، ثم تلقفه رايشنباخ فصقله، وأخرج منه منطقا ثلاثي القيم، ليكون وعاء مستوعبا للتقلبات التي فرضتها فيزياء الكم. وهنا، يلمح – لمن كان له قلبٌ – أن الفيزياء الحديثة، إذ طرحت مبدأ عدم تحديد الطاقة ــ الذي صاغه ماكس بلانك ــ لم تزح مزاحمة خصم للعقل، بل ألزمته بأن يتواضع، ويقبل بما ليس في متناول قوانينه القديمة.
ومن ثم، أخذت الفلسفة تنقب عن أدوات جديدة، تبقي بها على العنصر العقلاني دون أن تنكر ما أملته المخرجات اللاعقلانية، فبدت وكأنها تفتح أبوابها من الداخل، لا استجابة لهدم خارجي، بل تنبها لانهدام داخلي بدأ يسري في مفاصلها. لكن هذه المحاولة، وإن كانت في ظاهرها انفتاحا محمودا، فإنها ــ عند أهل التمحيص ــ لم تسلم من الإشكال، إذ زلزلت الأسس الموروثة عن الفلسفات القديمة، وهزت أركان من كانوا يظنون أنهم أقاموا النسق العقلي الكامل، وكأنها ترغم الفلسفة على دفع نفسها إلى تخومها القصوى، حيث ينحل المنطق إلى كشف، ويتحول الإدراك إلى ذهول، وتخرج المعرفة من حيز البرهان إلى فضاء الشهود، ومن لم يكن متهيئا لهذا المقام الحدي، بقي حائرا في دائرة المفاهيم، يحصيها عدا، ولا ينال منها إلا الوهم.
وأما منطق رايشنباخ الثلاثي القيم، فإنه ليقيم على أصل فارق، لم يسبق إليه في معهود المنطق الكلاسيكي الأرسطي، إذ ارتكز على مبدأ عدم التعيين للطاقة الكمية، كما صاغه نيلز بور وهايزنبرغ، في لحظة فاصلة انشقت فيها الرؤية الفيزيائية الحديثة عن التقليد الكلاسيكي، لتنذر بمنعطف أبستمولوجي لم تدرك عواقبه بعد إلا جزئيا. ذلك أن المنطق الثنائي، المبني على المثنوية القطعية بين الصواب والخطإ، أو السلب والإيجاب، إنما هو نظامٌ مغلقٌ، يفترض فيه أن كل قضية لا بد أن تكون إما صادقة وإما كاذبة، ولا ثالث لهما. وهذا هو مقتضى مبدأ “الوسط المرفوع” [tertium non datur]، الذي صيغ في أروقة المنطق الصوري الأرسطي، ثم نحتت عليه سائر البنى المنطقية الوسيطة.
غير أن فيزياء الكم، إذ بلغت مبلغ التحول المفهومي، أثبتت أن ثمة مقاما ثالثا بين الصدق والكذب، هو مقام اللاتعيين أو عدم التحديد، أي أن القضية لا تدرك حقيقتها إلا عند القياس، وأن الموجود الكمومي لا يكون متعينا قبل الملاحظة، بل معلقا بين الإمكانات. وهذا التعلق الإمكاني لا يمكن تمثيله في منطق ثنائي، لأن هذا الأخير لا يقبل المعلقات، بل لا يجيز إلا المنفصلات. وإذا اقتحمت القيمة الثالثة ــ وهي “غير المحددة” ــ انفسح بذلك أفق الحقيقة على مجال لم يكن معهودا في المنطق القديم، إذ صار الفكر قادرا على احتضان الاحتمال لا بوصفه عجزا عن التعيين، بل كونه حالة واقعية ذات دلالة معرفية. وهذا ما بلورته مدرسة كوبنهاغن في تأويلها الشهير، حيث اعتبرت الاحتمال صورة للوجود، لا نقصا فيه، بل هو بنيةٌ ذات أصالة أنطولوجية، فالموجود لا يكون موجودا إلا بقدر ما هو قابلٌ لأن يلاحظ، أي أن يحسم من بين البدائل. وقد أتاح هذا الانفتاح للفكر أن يحتضن ما كان يعد بلا معنى، بل خارج حدود المعقول. فالإرجاء الكمومي لم يعد مجرد غموض في الرؤية، بل أفقا ثالثا للكينونة، لا هو الحضور التام، ولا العدم المحض، بل مقامٌ وسطٌ بينهما، يسميه بعضهم: “الإمكان الزمني المتأخر”.
ومن هنا، يصبح مبدأ “الوسط المرفوع” موضع مساءلة فلسفية، إذ كيف نرفع الوسط في واقع يقيم كينونته عليه؟ وكيف نقول بثنائية الماهية والعدم، والعلم يشهد أن الوجود نفسه يترنح بين الاحتمالات، وأن الحسم ليس ذاتيا، بل مرتهنٌ بلحظة الرصد؟ وهنا يلمح بوضوح أن المنطق الأرسطي، وإن أوتي نظاما دقيقا، فإنه كان نظاما مغلقا لا يتسع للعوالم المفتوحة.
ولذلك، فإن عمل فون فايتسكر في المنطق الكمومي، كان عند أهل التحقيق نقلة نوعية، بل من أمهات الأحداث الفلسفية في القرن العشرين. وليس من المبالغة في شيء أن يقارن ما فعله هذا المنطق بما أحدثته الهندسة اللاإقليدية، التي قلبت نظام المكان وقواعد المسافة. فكما أن الهندسة الجديدة أثبتت أن الخط لا يلزم أن يكون مستقيما، ولا الزاوية أن تكون قائمة، كذلك أثبت المنطق الكمي أن القضية لا يلزم أن تكون صادقة أو كاذبة، بل قد تكون “مرجأة الحكم، مؤجلة المعنى، قائمة في طور التعين المنتظر”.
وهذا الانفكاك عن النظم المغلقة، وهذا النزوع إلى منطق يتسع للشرط الزماني المتحول، بدلا من الحسم الماهوي الجامد، إنما هو أمارةٌ بينةٌ على وقوع تحول جذري في البنية العقلية للإنسان المعاصر، وانتقاله من طور التفكير الصوري المغلق إلى طور الاحتواء الإمكاني المنفتح. فإن الاحتمال الذي كان في منطق المتقدمين علامة ضعف أو قصور في التصور، أضحى في هذا النسق الجديد دليلا ذاتيا على طبيعة الموجود، ومعلما وجوديا لا معرفيا فحسب.
وهذا الانفكاك عن النظم المغلقة، وهذا النزوع إلى منطق يتسع للشرط الزماني المتحول، بدلا من الحسم الماهوي الجامد، إنما هو أمارةٌ بينةٌ على وقوع تحول جذري في البنية العقلية للإنسان المعاصر، وانتقاله من طور التفكير الصوري المغلق إلى طور الاحتواء الإمكاني المنفتح. فإن الاحتمال الذي كان في منطق المتقدمين علامة ضعف أو قصور في التصور، أضحى في هذا النسق الجديد دليلا ذاتيا على طبيعة الموجود، ومعلما وجوديا لا معرفيا فحسب.
ذلك أن الفكر المعاصر، وقد عاين تهافت الدوغمائيات المنطقية، وتصدع المذاهب الميتافيزيقية المتصلبة، لم يجد مندوحة عن إعادة النظر في مبادئ الحكم نفسها، لا في موضوعات الأحكام فقط، فاستحدث منطقا يندرج فيه التردد ضمن صلب المعقول، ويدرك فيه الارتباك لا كعرض مرضي، بل كمرحلة تأويلية، تمثل قيد التكون لا فساد التكوين. وفي هذا الإطار، صار الإرجاء لا يعني تعليق الحكم لقصور النظر، بل لكون الموضوع نفسه غير متعين بعد، ومن ثم فلا سبيل إلى القطع فيه، لا لأن العقل قاصرٌ، بل لأن الوجود ذاته لم يبد وجهه الأخير بعد.
فالمعقول، على هذا، ليس مرآة صقيلة تعكس الموجود كما هو، بل هو نظامٌ من التأويل المفتوح، يتكشف فيه المعنى على مراحل، ويترقى فيه الحكم بقدر استعداده للانكشاف. ومن هنا، تغدو الفلسفة المعاصرة—إذا نظر إليها بمنظار هذا المنطق الجديد—أفقا زمكانيا لا يبنى على قاعدة ثابتة، بل يتخلق تخلقا متدرجا، وفقا لانفصالات الزمان، وتقاطعات المكان، وتجاذبات الذات والنص والعالم. فإنها فلسفةٌ تقر بأن الحقيقة لا تمتلك دفعة واحدة، ولا تكتشف بصيغة نهائية، بل تعاين على جهة التجلي المستمر، فمتى ما سكنت، ماتت، ومتى ما جمدت، فقدت. وبهذا اللحاظ، كان لا بد أن يعاد النظر في أسس المنطق ذاته، إذ لا مناص من القول إن المنطق القديم كان منطقا لما هو قار، لا لما هو متغيرٌ، متشظ، متراكبٌ.



