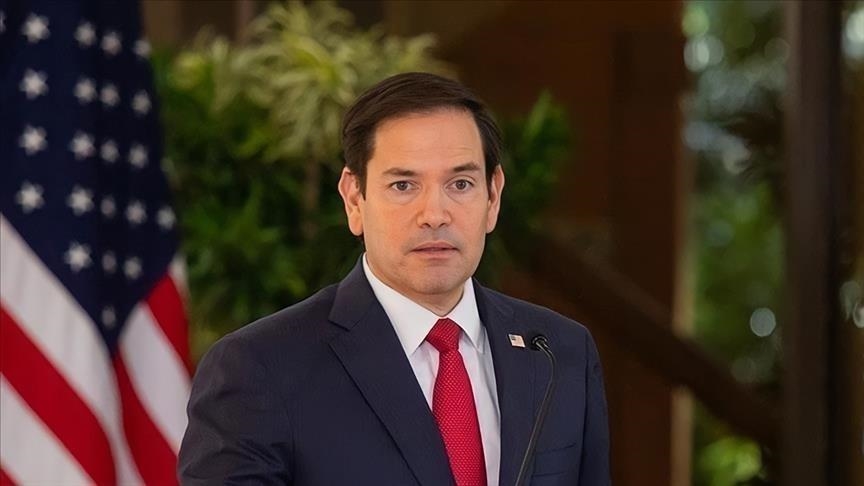صدمة الهجرة إلى يقينٍ جديد: كيف علّمتني كندا أن نقد الذات هو أول الدين

مصطفى بن جماعة. باحث تونسي
أعتبر نفسي مسلمًا متدينًا واعيًا منذ أربعين سنة. تشكّل وعيي الديني في تونس، داخل ثقافة عربية وإسلامية شبه خالصة: لغةٌ واحدة تقريبًا، سرديةٌ واحدة، ومخزونٌ هائل من العبارات الجاهزة التي تمنح الإنسان شعورًا بالطمأنينة قبل أن تمنحه فهمًا حقيقيًا. في ذلك العالم كان الدين حاضرًا بوصفه هويةً جامعة، وكان “التدين” كافيًا ليبدو الإنسان مستقيمًا، حتى وإن كانت الأخلاق العامة تنهار في التفاصيل اليومية.
قبل هجرتي إلى كندا منذ 27 سنة، حاولت أن أتهيأ نفسيًا وفكريًا. تبنيت فكرة “الخيرية” بوصفها درعًا داخليًا: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾. وقرأت كتبًا تُضخم إحساس التفوق الرمزي، من نوع “ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين”، وكأن العالم ينتظرنا لنعود فننقذه، وكأننا نملك الجواب الكامل لمجرد أننا نحمل اسم الإسلام.
ثم جاءت الهجرة… فانهارت الدروع بسرعة مدهشة.
1. الصدمة الأولى: المقارنة التي لا ترحم
الاحتكاك اليومي بالثقافة الكندية لم يكن مجرد اختلاف عادات أو أطعمة أو هندام. كان صدمة مباشرة لأن المقارنة كانت فورية، محسوسة، لا تحتاج تنظيرًا: احترام الدور، احترام الوقت، ثقافة الاعتذار، هدوء التعامل، الثقة العامة، قوة المؤسسات، النزاهة في الإجراءات، وتفضيل الحلول المنظمة على “التحايل”.
في تلك اللحظات انفتح السؤال الجارح:
لماذا تخلّف العرب والمسلمون وتقدم غيرهم؟
ولماذا تطورت حضارة الغرب إن لم يكن ذلك مبنيًا—ولو جزئيًا—على قيمٍ وأخلاقٍ حقيقية؟
كنت قد تعودت على تفسيرٍ سهل: “هم عندهم مادة ونحن عندنا روح”. لكن الواقع كان يفرض تفسيرًا أقل راحة: ربما نحن نملك خطابًا روحيًا كثيفًا، لكننا لا نملك دائمًا تمثّلًا أخلاقيًا مؤسسيًا يليق بهذا الخطاب. وربما الغرب يملك أخلاقًا مدنية قوية—even دون أن يرفع شعاراتٍ دينية—بينما نحن نرفع الشعارات ونستهلك الدين كهوية أكثر مما نعيشه كقيمة.
2. أخلاق مدنية… ومعنى ناقص
مع الوقت اكتشفت مفارقة دقيقة: كثير من الكنديين يمتلكون أخلاقًا اجتماعية رفيعة، لكنها ليست دائمًا أخلاقًا “وجودية” تُجيب عن سؤال المعنى.
هناك فرق بين الأخلاق المدنية (نظامٌ، قانونٌ، سلوكٌ عام، احترامٌ للمسافة بين الناس) وبين الأخلاق الوجودية (سؤال: لماذا نعيش؟ ما الغاية؟ ما معنى الخير والشر؟ ما مصير الألم؟ ما قيمة الروح؟).
هذه المفارقة كانت مهمة لأنها منعتني من وهمين متقابلين:
• وهم أن الغرب “لا أخلاق له”، وهو ظلمٌ للواقع.
• ووهم أن الغرب “اكتمل”، وهو أيضًا مبالغة.
النتيجة: الغرب ليس جنة، ونحن لسنا جحيمًا. لكننا نحن—بصدق—في أزمة أعمق، لأننا نملك نصًا مؤسسًا غنيًا بالقيم، ثم نعيش تناقضًا واسعًا في التمثل.
3. انعطافة 2006: من الدفاع إلى الفهم
ظلّت الرجّة الفكرية سنوات. ثم جاء التحول الحقيقي سنة 2006 حين غيّرت اتجاه قراءتي: بدل القراءة الدفاعية التي تبحث عن مثالب الغرب لتطمئن، دخلت إلى قراءة النهضة والحضارة الغربية: كيف نشأت الدولة الحديثة؟ كيف تطورت فكرة المواطن؟ كيف تأسست المؤسسات؟ كيف انبنت العلوم؟ كيف تشكلت القيم المدنية؟ كيف تنتج المجتمعات “قواعد لعب” تقلل الفوضى حتى مع اختلاف الناس؟
ثم تعمقت في موضوعات التنوع الثقافي والهويات المتزاحمة والهويات المتراكمة. هنا فهمت نفسي أكثر: لستُ هويةً واحدة صافية، بل طبقات تتداخل: تونسي، مهاجر، مسلم، عربي، كندي بالمعيش، حداثي في بعض الأدوات، تقليدي في بعض العواطف، نقدي في التفكير، وروحاني في العمق.
والتوتر بين هذه الطبقات ليس عيبًا بالضرورة؛ قد يكون علامة حياة، وقد يصبح مصدر نضج إن تحوّل إلى وعي لا إلى صراعٍ أعمى.
4. أربع سنوات من الشك المنهجي: “ميلادٌ جديد”
مررت بفترة فقدان توازن دامت قرابة أربع سنوات. مارست شكًا منهجيًا يشبه ما يسميه البعض “الشك الغزالي” أو “الديكارتي”: لا شكًا عبثيًا يهدم كل شيء، بل شكًا يعيد فحص المسلمات.
ناقشت كل شيء تقريبًا: صورة الله في الوعي الشعبي، معنى التدين، سلطة التراث، منطق الأحكام، موقع العقل، معنى الروحانية، وحدود التأويل.
لكن ما لا يظهر عادة في السرد المختصر، هو أن الشرارة الأولى لهذا الشك لم تكن سؤالًا تجريديًا من نوع “هل الله موجود؟”، بل كانت سؤالًا أخلاقيًا صادمًا: حين تابعت جرائم القاعدة—ذبح الرهائن باسم الدين—شعرت أن شيئًا داخليًا قد انكسر. كان السؤال مباشرًا وقاسيًا: هل هذا هو الإسلام؟ وكيف يجرؤ إنسان على استعمال الآيات والأحاديث لتبرير هذه الكمية من العنف والإجرام؟
لم تكن الأزمة هنا أزمة “معلومات”، بل أزمة “قيمة”: هل يمكن أن يكون الدين الذي يرفع شعار الرحمة والعدل قابلاً لأن يتحول إلى ماكينة قتل بهذا البرود؟
ومن هنا توسعت الدائرة. انتقلت من سؤال التطرف إلى سؤال “القيم الدينية” نفسها: هل المشكلة في الدين أم في القراءة؟ هل نحن أمام نصوص تولّد العنف، أم أمام عقول تنتقي من النص ما يوافق هواها ثم تمنحه قداسة؟ ثم دفعتني هذه الأسئلة إلى منطقة أكثر حساسية: إشكالية الشر في العالم. كيف نفهم الألم، والظلم، والعبث الظاهر في التاريخ؟ وكيف نواجه السؤال الذي يعتبره كثيرون مدخلًا إلى الإلحاد: إذا كان الله خيرًا وقديرًا، فلماذا كل هذا الشر؟
في تلك السنوات دخلت عن عمد إلى عالم الشك كما يدخل الإنسان مختبرًا باردًا: قرأت “أمهات” كتب الشك والإلحاد، وتابعت مناظرات “فرسان الإلحاد الجديد” الأربعة: ريتشارد دوكنز، دانيال دينيت، سام هاريس، وكريستوفر هيتشنز. لم أقرأهم لأجل الانبهار أو الاستفزاز، بل لأجل أن أرى قوة حججهم من داخل منطقهم: أين يصيبون؟ وأين يتجاوزون؟ وأين يستثمرون ثغرات التدين الشعبي والتاريخ الدموي ليُدينوا “الدين” بوصفه فكرة؟
ومع التعمق بدأت تتضح لي نقطة محورية: أن جوهر الإشكال—في كثير من التطرفات الدينية والالحادية معًا—ليس “العقل” في ذاته، بل التحيز الإرادي والانتقائية.
المتطرف الديني ينتقي من النص ما يغذي غضبه ويترك ما يقيده بالرحمة والعدل. والمتطرف الإلحادي ينتقي أسوأ نماذج التدين والتاريخ ويترك كل ما هو أخلاقي وروحي وعميق في التجربة الدينية. كلاهما يشتغل بالطريقة نفسها: انتقاء الأدلة التي تخدم النتيجة المرغوبة سلفًا، ثم تقديمها على أنها “حقيقة عقلية نهائية”.
حين أدركت ذلك، بدأت أستعيد توازني ببطء: لم تعد المعركة عندي بين “إيمان” و“عقل”، بل بين أمانة فكرية وانتقائية مصلحية. وبقي السؤال الأهم: كيف أصل إلى يقين لا يقوم على القمع الداخلي ولا على التسليم الأعمى، بل على ميزان يربط العقل بالروح، ويجعل الأخلاق معيارًا لفهم الدين لا ضحية له؟
وفي يومٍ ما—لا أقدّمه كمعجزة ولا كبرهان هندسي—شعرت أنه “يوم ميلادي الجديد”: يقين هادئ بقدرتي على الموازنة بين عقلانيتي وروحانيتي.
يقين لا يجعلني أطفئ عقلي باسم الإيمان، ولا يجعلني أجفّف روحي باسم العقل.
وهنا تبلور عندي مفتاح صارم وبسيط: التمييز بين ثلاثة مستويات:
1. الوحي: النص المؤسس، مصدر القيم والمعنى.
2. التأويل: فهم البشر للنص، وهو تاريخي نسبي، يتأثر باللغة والسياق والمعرفة والمصلحة.
3. التطبيق: تنزيل التأويل على الواقع، وهو الأصعب لأنه يصطدم بالمؤسسات والاقتصاد والسلطة والعادات.
هذا التمييز حررني من معادلتين قاتلتين:
• أن نقد التراث نقد للدين.
• وأن نقد تطبيقات المسلمين كفرٌ بالرسالة.
صرت أستطيع أن أقول: قداسة الوحي شيء، وقداسة ما قيل في تفسيره شيء آخر. وأن الخطأ فينا لا في النص، وأن فساد التطبيق لا ينسف صدق الرسالة.
5. انقلاب السؤال: من “ماذا خسر العالم؟” إلى “ماذا خسرنا نحن؟”
قبل الهجرة كنت أرى العالم “مدينًا” لنا: خسر لأننا تراجعنا.
بعد رحلة الاهتزاز والتعلم صار السؤال الحقيقي عندي: ماذا خسرنا نحن كمسلمين حين لم نتعاطَ مع الرسالة القرآنية بالشكل السليم؟ لماذا انحرفنا؟
انحرفنا يوم جعلنا الإسلام “هوية” أكثر مما جعلناه “قيمة”.
انحرفنا يوم تحول التدين إلى طقوسٍ بلا أخلاق، وإلى صراعات فرعية بلا عدل.
انحرفنا يوم صار التراث الفقهي سقفًا نهائيًا، بدل أن يكون خبرة تاريخية تُحترم وتُراجع.
انحرفنا يوم غابت مركزية القرآن عن حياتنا، وحلّت محلها مركزية “الخطاب عن القرآن”.
هنا بدأ نقدي الحقيقي: نقدٌ إصلاحي من داخل البيت، لا ضد الدين ولا ضد المجتمع، بل ضد الوهم الذي جعلنا نعيش تناقضًا فادحًا بين ما نقوله وما نفعله.
6. المفارقة الساخرة: “هنيئًا لك الدعوة هناك!”
كلما زرت تونس سمعت العبارة نفسها: “هنيئًا لك فرصة الدعوة في كندا، ستُدخل الناس في الإسلام.”
كنت أبتسم بسخرية حزينة؛ لأن التحدي الحقيقي لم يكن كيف “أدخل” غيري في الإسلام، بل كيف أكون أنا مسلمًا حقًا.
كيف أخرج من مستوى “الانتماء” إلى مستوى “الإيمان”؟
الآية التي كانت تحاصرني كمرآة لا تُجامل:
﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾
أي أن الانتقال من الإسلام كعنوان إلى الإيمان كحقيقة ليس مضمونًا، ولا يُشترى بالشعارات، ولا يُثبت بكثرة الكلام.
صار هدفي أن أكون مؤمنًا لا متدينًا فقط: أن يظهر أثر الإيمان في الصدق، وفي العدل، وفي احترام الإنسان، وفي الأمانة، وفي مقاومة الظلم، وفي الشجاعة الأخلاقية.
7. “الخيرية” ليست بطاقة تفوق… بل شرط أخلاقي
من أكثر ما احتجت إلى إعادة فهمه هو فكرة “الخيرية”. فقد اكتشفت أن تحويلها إلى درع نفسي ضد الواقع يقتل معناها.
الخيرية ليست امتيازًا مجانيًا، بل تكليفٌ مشروط:
﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله﴾
أي أن الخيرية تُقاس بمقدار حضور المعروف والعدل والرحمة في المجتمع، لا بمقدار الصراخ بالهوية.
وإذا غابت المؤسسة العادلة، وغابت حماية الضعيف، وغاب الصدق في المعاملة، فـ”الخيرية” تتحول إلى شعارٍ يجرح صاحبه قبل أن يقنع غيره.
8 ) كندا لم “تُفسد إيماني”… بل كشفت لي أن العالم كله في أزمة معنى
بعد أن استعادت نفسي شيئًا من التوازن، بدأت ألاحظ بوضوح: كثير من الكنديين الطيبين—أناس محترمون، متعاطفون، صادقون—يعيشون هم أيضًا أزمة روحية وفكرية.
أخلاقهم المدنية عالية، لكن سؤال المعنى يطاردهم: فراغ داخلي، وحدة، قلق وجودي، بحث عن روحانية بديلة، أو ارتهان لنمط استهلاكي يعوّض المعنى باللذة والشراء.
وبالقدر نفسه اكتشفت أن التضليل لا يخصنا وحدنا. هناك أيضًا ثلاثي عالمي يخترق المجتمعات بأشكال مختلفة: سلطة تتحكم، مال يشتري، و“كهنوت” جديد يشرعن—لا بعمامة بالضرورة، بل بإعلام، وخبراء، ولوبيات، وصناعة رأي، وآليات تزييف تجعل الناس يصدقون ما يُراد لهم أن يصدقوه.
هذه الملاحظة لم تُعدني إلى جلد الغرب ولا إلى تمجيده. بل أعادتني إلى فكرة أعمق: الإنسان واحد في ضعفه وحاجته للمعنى، وكل حضارة معرضة للانحراف حين تفقد ميزانها الأخلاقي.
9. ماذا يمكن أن يقدمه الإسلام للبشرية اليوم؟
ليس ما يمكن أن يقدمه الإسلام هو “إخضاع الآخر” أو تحويله إلى نسخة منا، ولا إغراقه في جدالات الهوية والرموز. الإسلام—في جوهره الذي أبحث عنه اليوم—لا يُعرض بوصفه “علامة انتماء” تُرفع في وجه العالم، بل بوصفه منظومة تحرير أخلاقي ومعنوي: تحرير الإنسان من عبودية نفسه، ومن ضغط الجماعة، ومن فتنة السلطة، ومن سطوة المال، ومن الكهنوت الذي يبيع المعنى لمن يدفع أكثر.
ما الذي يمكن أن يقدمه الإسلام إذن؟ يمكن أن يقدمه على ثلاثة مستويات مترابطة: ميزان معنى، وميزان أخلاق، وميزان علاقة بالآخر.
(أ) ميزان المعنى: استعادة السؤال الأكبر
كثير من أزمات الإنسان الحديث ليست أزمة معلومات بل أزمة معنى: لماذا نعيش؟ ماذا نفعل بالألم؟ ما قيمة الخير إذا لم يكن له أصلٌ متعالٍ؟ لماذا “الحق” حقٌّ؟ ولماذا “الظلم” ظلمٌ؟
الإسلام هنا لا يقدّم وصفة تقنية، بل يعيد الإنسان إلى مركزه الصحيح: مخلوقٌ ذو كرامة ومسؤولية، لا مجرد مستهلك. ويعيد للوجود أفقًا يرفع الإنسان فوق العبث: أن الحياة امتحان أخلاقي، وأن الألم ليس دليل عبثٍ بالضرورة، وأن للإنسان قيمة لا تُختزل في إنتاجيته ولا في رصيده.
هذا لا يعني أن كل مؤمنٍ يعيش المعنى تلقائيًا؛ لكنه يعني أن القرآن يضع “المعنى” في قلب الحياة، ويرفض أن يتحول الإنسان إلى ترسٍ داخل آلة.
(ب) ميزان الأخلاق: بناء الإنسان قبل بناء الشعارات
إذا كان من شيء يمكن للإسلام أن يقدمه حقًا فهو أخلاقٌ لا تُساوم:
• أن الصدق ليس خيارًا تجميليًا بل أساس الاستقامة.
• أن الأمانة ليست “فضيلة شخصية” فقط، بل شرط عدالة اجتماعية.
• أن العدل ليس شعارًا سياسيًا، بل عبادة ومعيار.
• أن الرحمة ليست ضعفًا، بل قوة إنسانية تضبط الفطرة.
والميزة هنا ليست في “المواعظ” بل في تحويل الأخلاق إلى معايير محاسبة: أن تُحاسِب نفسك قبل أن تُحاسِب غيرك، وأن تُراجِع نيتك قبل أن تُهاجم الآخر، وأن تفهم أن التدين بلا أخلاق هو صورةٌ مشوّهة للدين.
ومن أعمق ما يقدمه الإسلام—إن فُهم جيدًا—أنه لا يختزل التدين في الطقوس، بل يجعل الطقوس تربيةً على الأخلاق. الصلاة ليست حركات بل مدرسة انضباط وضمير. الصوم ليس جوعًا بل مدرسة ضبط شهوة وتحرير إرادة. الزكاة ليست صدقة بل مدرسة مقاومة الأثرة وبناء التكافل. والحج ليس رحلة بل تمرين على المساواة وكسر الغرور.
إن لم تُنتج العبادة أثرًا أخلاقيًا فهي تتحول إلى شكلٍ بلا روح، بل وقد تتحول إلى غطاء للانحراف.
(ج) ميزان العلاقة بالآخر: حوارٌ لا استحواذ
الإسلام الذي أستطيع أن أقدمه للآخر اليوم ليس إسلام “الاستحواذ”، بل إسلام الحوار: أن تخاطب الإنسان في كرامته وعقله، لا في خوفه. أن لا تجعل هدفك أن “تغلبه” بل أن تفهمه وتبني معه أرضية قيم مشتركة.
هذا يعني أنني لا أطلب من الآخر أن يبدأ من مفرداتي الدينية، بل أبدأ أنا من قلقه وأسئلته داخل منظومته: معنى الحياة، مركزية الضمير، قيمة الإنسان، رفض الظلم، معنى العدل، خطر الاستهلاك، هشاشة الأسرة، أزمة الوحدة… ثم أقول: في القرآن وفي التجربة الإيمانية ما يساعد على استعادة هذه المعاني دون أن تفقد إنسانيتك أو استقلالك.
وعلى هذا المستوى يصبح “الإسلام” ليس بطاقة هوية تُرفع، بل مشروع إنقاذ أخلاقي: إنقاذ الإنسان من اختزال نفسه في المال، أو في المتعة، أو في السلطة، أو في القطيع.
10. نقد الذات ليس هزيمة… بل بداية الإيمان
أكبر تحول في حياتي لم يكن انتقالًا جغرافيًا من تونس إلى كندا، بل انتقالًا داخليًا: من التدين الذي يكتفي بالانتماء، إلى الإيمان الذي يطلب الحقيقة في النفس قبل أن يطلبها في الآخرين.
ومن السؤال الذي يلوم العالم على غيابنا، إلى السؤال الذي يلومنا على سوء تمثلنا لرسالةٍ كان يمكن أن تُنقذنا قبل أن “تنقذ العالم”.
إن كان لي أن ألخص خبرتي في جملة واحدة فهي:
الإيمان الحقيقي يبدأ حين نصير قادرين على نقد أنفسنا دون أن نفقد حبّنا لديننا، ودون أن نفقد احترامنا للآخر، ودون أن نكذب على الواقع.
وعندها فقط يصبح الدين نورًا فعليًا: نورًا يحرر العقل، ويهذب الروح، ويمنح الإنسان شجاعة أن يكون صادقًا—أولًا—مع نفسه.