ثقافة الاعتراف: دفاعا عن محمد أركون
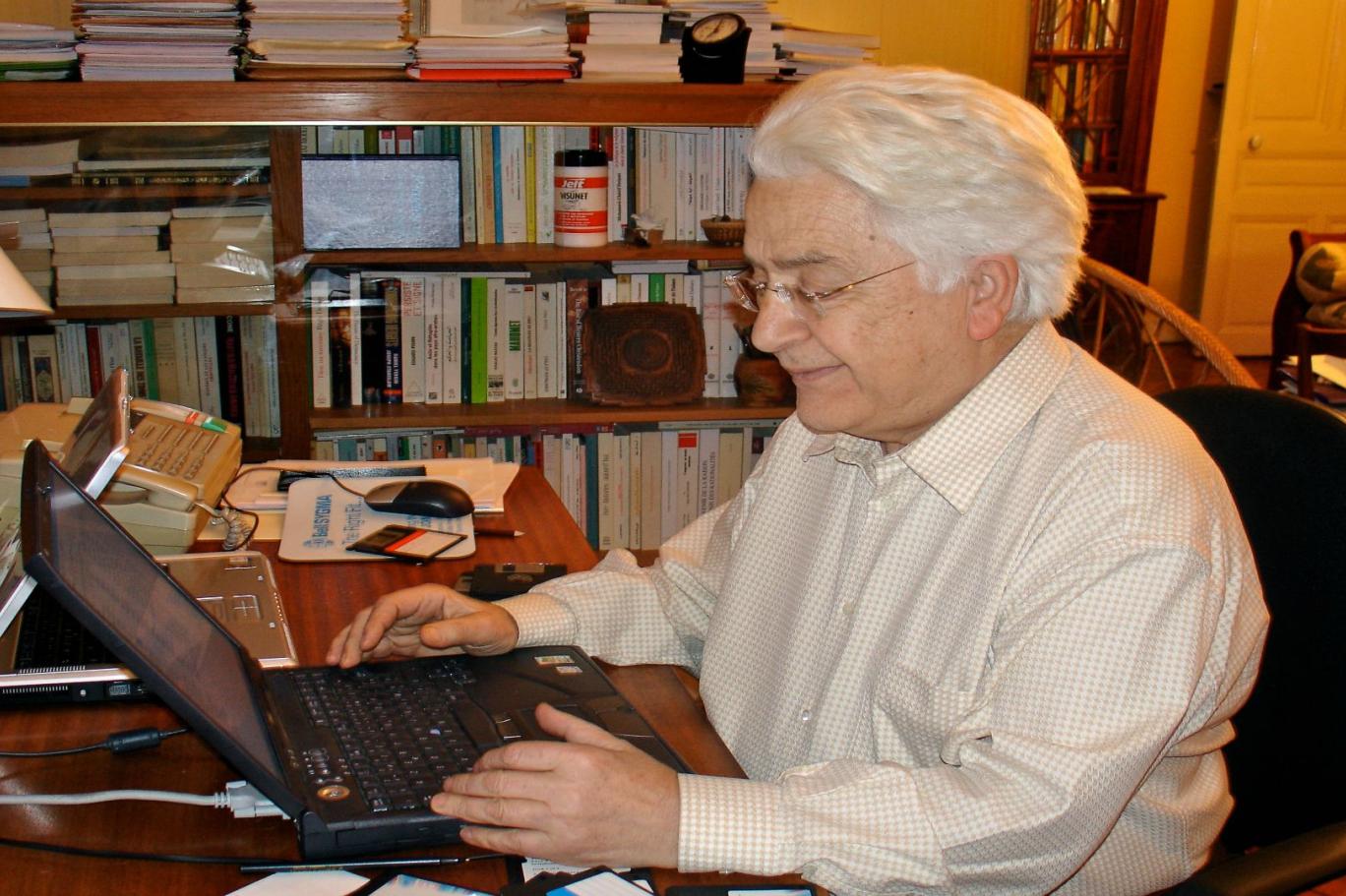
علي مزيان
كنت أقرأ كتابا أحد المرات في مكان عام، تطفل أحدهم ونظر للعنوان، ثم قال: “ننصحك متبقاش تقرأ هذه الكتب”. كان الكتاب لمحمد أركون، انزعج صاحبنا من عنوانه: قضايا في نقد العقل الديني. مارس الرجل سلطة العمر ليقدم نصيحة بلهاء منزعجا من عنوان لم يقرأ ما بعده.
هذا ما حدث لكتابات محمد أركون، أسيء فهم الرجل، فخاضت الأصولية والإستشراق حربا بالتوازي مع كتاباته.
سأحاول توضيح بعضا من سوء الفهم الذي أساء لمحمد أركون، على الرغم من أني كثيرا ما انتقدت أفكار محمد أركون:
اتهم محمد أركون بالاستشراق الكولونيالي بينما كانت مراكز الدراسات الغربية تصفه بالأصولي، لأنه رفض كذبة رفض الإسلام للحداثة، حجة أركون أن الحداثة اصطدمت بإسلام الامبراطورية العثمانية في مرحلة أولى، ثم تحولت لاستعمار في مرحلة لاحقة صدم فقراء العالم الثالث، فليس الاسلام بالمطلق هو الذي اصطدم بالحداثة.
اتهم محمد أركون بالعمالة للإمبريالية وخاصة الاستعمار الفرنسي في الوقت الذي كان يخوض معركة ضد الامبريالية المعرفية التي ظهرت مع سرديات هنتنغتون عن صدام الحضارات، رفض أركون فكرة الأمة الإسلامية الواحدة التي تصطدم بالغرب كما ابتكرها الاستشراق ليجعلها مطية لتبرير تخلفنا، حجة أركون أن لكل شعب من الشعوب متخيله الخاص وبناءه الأنثروبولوجي (أو الذهنية الثقافية) الخاصة به من آلاف السنين. بالتالي لا ينبغي اختصار شعوب بكلمة إسلام، وكأن المغاربة والاتراك والإيرانيون متماثلون كما توهم الاستشراق. فلا يمكن فهم انحطاط الحضارة على أرض الإسلام إلا عن طريق العلوم الاجتماعية ومناهجها.
اتهم محمد أركون بالطعن في اللغة العربية بينما كان محمد أركون مصرا على أن اللغة العربية كانت لغة علوم ومعارفة طيلة قرون بعد أن كانت لغة الشعر الجاهلي ثم انتقلت إلى لغة القرآن الذي دخل بها عالما جديدا، ثم تتفاعل مع لغات البلاد الذي دخلتها، إلى لغة الدواوين والإدارة منذ النصف الثاني للعصر الأموي، ثم لغة العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية منذ بيت الحكمة والترجمة في بغداد، وربما قبلها، ثم بقيت لغة العلم الأولى لعدة قرون، ولجأت اليها لغات أخرى تتلقى ويترجم عنها، وهي اللغات اللاتينية وغيرها في طليطلة وفي باليرمو، وكتب بها اليهود علوم الدين والفكر والفلسفة وغيرها لعدة قرون بألف باء عبرية، أو ما عرف باليهودية العبرية.
اتهم محمد أركون بمحاولة إسقاط العلمانية الفرنسية على واقعنا العربي، بينما اعتبر أركون أن للعلمانية الفرنسية حكاياتها التأسيسية التي تخلق المشروعية عليها على غرار باقي الأديان (هنا الثورة الفرنسية بدلا من الوحي المسيحي بالنسبة للنظام القديم)، لأن الناس لا يستطيعون التعايش معها دون ذروة عليا يقدسونها، وبالتالي فإن التداخلات بين العالمين الديني / والسياسي، أو المقدس / والدنيوي، أو الروحي / والزمني هي مستمرة دائما. إنها مستمرة ومتسربة بشكل سري إلى درجة أن الفصل القانوني بين الكنيسة والدولة لا يمكن أن يخدعنا كثيرا.
اتهم محمد أركون أنه يؤيد حملة بوش الإبن بتماهيه مع فكرة (الإرهاب الإسلامي)، بينما كان أركون لا يرى أن الارهاب شأن إسلامي خاص، بل هناك الإرهاب المفصلي أو البنيوي وهو عنف متضمن في تركيبة الدول الصناعية نفسها، أو في بنيتها التشكيلية. ولذلك سماه بالعنف البنيوي، أي الملازم لبنية المجتمعات الناتجة بعد الحرب العالمية الثانية والتي (فصلتها) القوى العظمى على هواها وخلعت عليها المشروعية القانونية الدولية، ولكن دون أن تراعي تركيبتها الداخلية الحقيقية.
اهتم محمد أركون أنه صنيعة الغرب، لكن محمد أركون أكثر من شرح مصطلح الغرب، الغرب اليوم يعني كتلة الدول السبع الكبار التي تلتقي سنويا، وبانتظام، منذ سنة 1989. وهي مجموعة (جغرافية سياسية) و(جغرافية اقتصادية) و(جغرافية مصرفية) مؤلفة من الدول التالية: الولايات المتحدة، كندا، اليابان، فرنسا، إيطاليا، انجلترا، ألمانيا. وتعبر كتلة الكبار السبع التي تهيمن على العالم عن الإرادة الجغرافية _ الاستراتيجية الجديدة في تطوير المبادئ السياسية والاقتصادية التي تؤسس الديموقراطية الليبرالية والتبادل التجاري الحر. إن قبول اليابان في هذا المنتدى الغربي الكبير يبين لنا كيف أن المعايير الثقافية والفلسفية ليست مأخوذة فعلا بعين الاعتبار. وإنما المهم هو القوة التكنولوجية والاقتصادية والمالية. فالتراث الياباني -يقول محمد اركون- هو غير التراث الأوروبي أو الأمريكي. ويزداد هذا الخلط كلما كان الإسلام (أو الاتحاد السوفياتي سابقا) هو الخصم المقابل. حتى الأوروبيين أنفسهم يشعرون بالتمايز عن الولايات المتحدة التي لا يكتمل مفهوم الغرب بدونها.
تطول الاتهامات الموجهة لمحمد أركون وتطول، ويمكن الدفاع عن محمد أركون عن طريق محمد أركون نفسه، هذا الرجل ساهم في إثراء المكتبات العربية ولا يمكن نفي إرثه الكبير بتلفيق تهمة جاهزة.



