تقديم كتاب “الحديث: إرث محمد في العصور الوسطى والعالم الحديث”
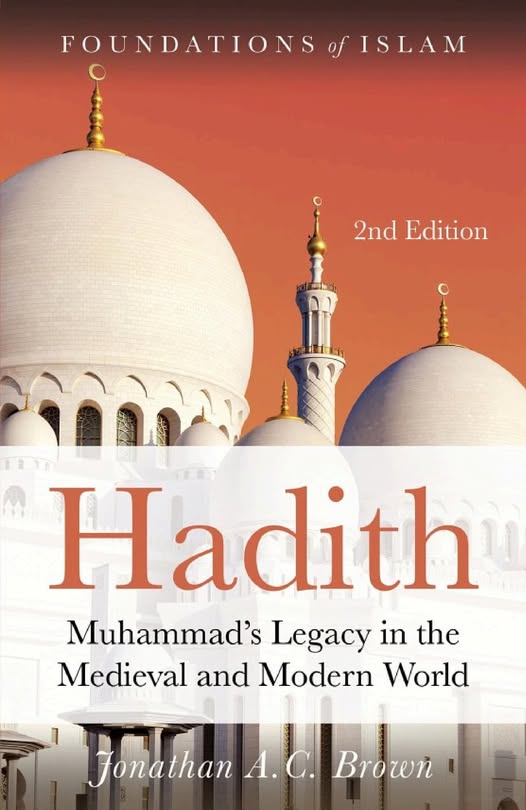
مصطفى سمير
هذه مقتطفات مهمة، في نظري، اجتزأتها وترجمتها سريعا من مقال تضمن فصلا من كتاب مهم لجوناثان براون، أظنه يترجمه الآن أحد المترجمين المهتمين وربما صدرت ترجمته. تتجلى أهمية الكلام المقتطف أدناه في أن كلام براون هذا من أنفس ما كتب أو ما يمكن الانطلاق منه في الرد على هؤلاء الأكاديميين.
كتاب جوناثان بروان المقصود هو: الحديث: إرث محمد في العصور الوسطى والعالم الحديث
Hadith : Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World
*****************
لقد تناولنا حتى الآن الأحاديث النبوية ووظائفها في الحضارة الإسلامية بوصفها تقليدًا نشأ في أوساط قوم آمنوا بأن محمدًا ﷺ نبيٌّ، هو خاتم سلسلة من المرسلين إلى البشر، بعثهم إلهٌ خلق الكون، وهو وحده مصدر الحقيقة. وحتى هذه اللحظة، ظلّت تقاليد الحديث تدور في الفضاء الإسلامي. صحيح أن المسلمين قد اختلفوا في طرائق استعمال الحديث وتفسيره، لكنهم ظلّوا هم من يتحكّم في حدود النقاش.
أما هذا الكتاب، فلا يفترض أن قارئه يؤمن بأن الله يتدخل في مجريات التاريخ، أو بأن محمدًا ﷺ كان نبيًّا. ولعل القارئ قد لاحظ، إن كنتُ قد وفّقت في عملي، أن هذا الكتاب يتناول الحديث بلهجة «محايدة» أو «موضوعية» وفق مناهج المؤرّخين المحدثين للأديان. غير أن مناهج النقد التاريخي الغربية، شأنها شأن مناهج نقّاد الحديث المسلمين، لها هي الأخرى تقاليدها ومسلّماتها.
ما ينبغي الاعتراف به قبل المضي في أيّ نقاش آخر، هو أن الكتاب الذي لا يفترض تدخّل الله في الشأن البشري، ولا يفترض نبوة محمد ﷺ، ولا صحة الحديث على العموم، فإنه في الحقيقة يُسلّم، ضمناً، بأن الله لا يتدخل في مجرى التاريخ، وأن محمدًا ﷺ مجرد إنسان، وأن هنالك شكوكًا حقيقية حول مصداقية كتب الحديث كلها. ولعلّ قليلًا من القرّاء الغربيين، مثلًا، يقبلون التفسير القائل إننا نعلم أن الحديث محفوظ لأنه كلام نبيٍّ أرسله الله، ولا يمكن أن يدع اللهُ دينَه الذي اختاره يُفقد أو يُطمس (وهو من التفسيرات الشائعة في التقليد الإسلامي). ويمكنك أن تتصوّر أن البحث في الحديث عند الغربيين يختلف اختلافًا جذريًّا عن بحثه في سياقه الأصلي الإسلامي.
وهذا الفصل يتناول البحث الأكاديمي الغربي في تاريخ الإسلام المبكر، ونقده الجذري للتقليد السنّي في الحديث. وسنُطلق على هذا الإشكال اسم «مسألة الصحّة»، وله وجهان يجب أن لا نغفل عنهما. فمن جهة، يمكن النظر إلى التحقيق النقدي الذي أجراه الغربيون في الحديث، وفي مناهج المسلمين في التثبّت منه، على أنه خطوة نافعة في فهم أصول الإسلام، وجزء من المسعى البشري العام لتوسيع آفاق العِلم. ولكن من جهة أخرى، يمكن اعتبار نقد الغرب لتقليد الحديث ضربًا من ضروب الهيمنة، تُمارَس فيها سلطة منظومة فكرية على أخرى، عن طريق فرض المعيار الذي تُحدَّد به «الحقيقة» و«المعرفة». ومن هذا المنظور، يمكن للمرء أن يتساءل: لمَ يُعدّ «النور» الذي ألقاه الغربيون على الحديث أنفعَ للبشرية من «الأنوار» التي أسهم بها التقليد الحديثي الإسلامي؟ كما بيّن أمثال إدوارد سعيد، فإن المعرفة سلطة، ودراسة الشيء ضرب من فرض السيطرة عليه.
إن مسألة الصحّة، إذن، ليست مجرد جدل داخلي حول الحديث، بل هي جزء من السجال الأوسع بين «الدين» و«الحداثة»، وبين «الإسلام» و«الغرب». ولن نتناول هذه المسألة من منظور غائي، يُفترض فيه أن التصوّر «المسلم» لتقليد الحديث تصوّر خاطئ، وأن المستشرقين الغربيين قد أيقظوه من رقاده الطويل، وأخذوا يوجّهونه شيئًا فشيئًا إلى النور. بل سنسلك، فيما أراه أصدق وأقرب إلى الصواب، منهجًا آخر: فتراث الحديث الإسلامي واسع إلى حدٍّ لا يُقارن، ومحاولاتنا لتقييم صحّته لا تتجاوز عينات يسيرة، ومن ثم فإن الموقف من صحته مرهون –أكثر من كونه مبنيًّا على حقائق تجريبية– بالأُفق الفكري الذي ينطلق منه الباحث. وما دمنا لا نستطيع، من جهة البحث التجريبي، أن نُثبت إن كان محمد ﷺ نبيًّا أو شخصيةً صنعتها السياقات التاريخية، أو إن كان الله قد تدخّل فعلاً في حفظ أقواله، فلن نتناول «مسألة الصحّة» بوصفها قضية لها جوابٌ واحد صحيح. بل سنعرض للاتجاهات المتنوعة في هذه المسألة، ونبيّن ما تنطلق منه من مسلّمات، وكيف شيّدت رؤاها على تلك المسلّمات. وسننظر كيف ردّت بعض المدارس الفكرية على غيرها، وكيف سعى كل منها إلى التشكيك في مقدمات أخرى.
من البديهي أن يكون المؤرّخون الغربيّون على حقّ حين يشيرون إلى الشبهة الزمنية في حديث يُنسب إلى النبي ﷺ يقول فيه: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه»، أو الحديث الأشدّ غرابة الذي يُزعم فيه أنه قال: «يكون في أمتي رجل يُدعى محمد بن إدريس – يعني الشافعي – وفتنته أضرّ على أمتي من إبليس». غير أن نُقّاد الحديث البارزين من المسلمين، مثل ابن عدي (ت. 975م)، والجوْزقاني (ت. 1148–1149م)، والذهبي (ت. 1348م)، قد اعتبروا حديث معاوية حديثًا غير صحيح، بل موضوعًا، أما الحديث الذي يذم الشافعي فقد اتخذه العلماء المسلمون مثالًا مدرسيًا يُضرَب به المثل في الوضع والكذب على النبي.
ومع أن كثيرًا من العلماء المسلمين قد رأوا هذه الأحاديث غير صحيحة، فإن الأحاديث التي تذمّ القَدريّة – تلك الفرقة المبكرة التي قالت بالحرية التامة لإرادة الإنسان – قد وردت في مصنّفات معتبرة مثل «السنن» الأربعة. ومما لا شك فيه أن الاسم الاصطلاحي «القَدريّة» لم يظهر إلا بعد نحو قرن من وفاة النبي ﷺ. ومع ذلك، فإن المسارعة إلى الحكم بوضع هذه الأحاديث استنادًا إلى ما يبدو أنه شبهة انتحال إصطلاحي في زمن لاحق – أي بأن النبي ﷺ قد “تنبأ” بظهور هذه الفرقة – يُعدّ تسرّعًا في الاستنتاج. فقد لا يقبل الباحثون الغربيّون بإمكانية عِلم النبي ﷺ بالمستقبل، لكن القرآن نفسه يتناول قضايا الجبر والاختيار، ولا يُستبعد أن يكون بعض المسلمين في عصر النبي ﷺ قد أثاروا سخطه بقولهم إن الله لا يتحكم بأفعال العباد، فيكون من المعقول إذًا أن يكون قد حذّر من تلك الفكرة ومن مروّجيها. والأهمّ من ذلك أن لكل حديث ورد فيه ذمّ للقدريّة بهذا الاسم الاصطلاحي ما يقابله من رواية لا يظهر فيها هذا الاصطلاح بل يُعبّر عنها بعبارات من قبيل: «قوم القدر» أو «الذين كفروا بالقدر»، وهذه الروايات هي الأصح عند نُقّاد الحديث المسلمين. وعليه، فإن ما يبدو للدارسين الغربيّين شبهةَ انتحال زمني(مفارقة زمنية)، قد يكون في حقيقته تحذيرًا نبويًا من بدعة قائمة في زمانه ﷺ، ثم جاء بعض الرواة في أزمنة لاحقة فأبدلوا وصف «قوم القدر» بالتسمية الاصطلاحية الشائعة في عصرهم وهي «القدريّة»، من باب التيسير أو التساهل.
لقد دأب نقّاد غربيّون من أمثال إجناتس جولدتسيهر (ت. 1921م) على توبيخ علماء الحديث المسلمين لعدم اعتبارهم مضمون الحديث عاملًا في الحكم عليه، ولكننا – كما رأينا – نجد أن بعض نُقّاد الحديث من المسلمين، كالبخاري (ت. 870م)، قد استعملوا مضمون الحديث نفسه في الطعن في صحته. نعم، لم يبلغوا في ذلك مبلغ الشكّ الذي عليه المنهج النقدي الغربي الحديث، ولكنهم لم يهملوا محتوى الحديث بالكلية.
ومع أن نُقّاد الحديث المسلمين يختلفون عن الباحثين الغربيّين في إيمانهم بأن النبي ﷺ كان يعلم الغيب، فإنه ربما كان من المفيد للباحث الغربي أن يتأمل في تأنّيهم وتحرّيهم. فعلى سبيل المثال، إن الاستدلال على وضع الحديث المشهور: «لا تُشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» بأنه يخدم أجندة أموية لأن فيه ذكْرًا للمسجد الأقصى، الذي كان تحت سلطة الأمويّين، وبسبب وجود الزهري (ت. 742م) – المعروف بصلته ببلاط بني أمية – في إسناده؛ هذا الاستدلال قد يكون متعجلًا، لا سيّما وأن للحديث أسانيد أخرى مبكرة لا يظهر فيها اسم الزهري أصلًا. فهل علينا في هذه الحال أن نُعيد النظر في نتيجة الحكم، أم نُسلّم – من دون بيّنة – بأن تلك الأسانيد الأخرى قد زُيّفت كذلك؟ ثم إن المسجد الأقصى مذكور في القرآن، فهل يُستبعد مع ذلك أن يحثّ النبي ﷺ أمّته على زيارة هذه المساجد الثلاثة وبيان فضلها؟
إن المنهج الغربي في نقد الأحاديث يبدو أحيانًا وكأنه يدور في حلقة مفرغة، كقضية «الدجاجة والبيضة»: هل السرد هو الذي خلق الحدث، أم الحدث هو الذي استدعى السرد؟ لقد انتقد جولدتسيهر وغيرُه الحديث الصحيح عند المسلمين: «إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من خراسان، فأتُوها، فإن فيها خليفة الله المهدي»، واعتبروه مظهرًا من دعايات العباسيّين الثورية (إذ إنهم خرجوا من خراسان، وراياتهم كانت سوداء). غير أن علينا أن نتوقف هنا: أليس من الممكن أن يكون النبي ﷺ قد قال ذلك فعلًا؟ سواء آمنّا بنبوته أم لا، فربما تصرّف أحيانًا كما يتصرّف الأنبياء وتحدّث عن أمور غيبية. فهل صنع العباسيون هذا الحديث خدمةً لأجندتهم، أم أنهم ببساطة انتفعوا بحديث موجود أصلًا فصاغوا راياتهم لتوافق الصورة المهدوية الموصوفة في النص؟
ولو وسّعنا الدائرة، لرأينا مثالًا مشابهًا في الكتاب المقدس، إذ جاء في سفر زكريا: «ابتهجي جدًا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم. هو ذا ملكك يأتي إليك. هو عادل ومنصور، وديع، وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان» (زكريا 9: 9). فهل كون الأناجيل تصف دخول عيسى إلى أورشليم راكبًا على حمار أو جحش (مرقس 11: 1–11؛ متى 21: 1–4)، يعني أن المسيحيين اختلقوا هذه النبوءة في سفر زكريا دعمًا لفكرة مسيانية عيسى؟ الجواب معلوم، فكتاب زكريا يسبق المسيحية تاريخيًا. فالأرجح إذًا أن يكون عيسى قد دخل المدينة (وهو أمر غير مستبعَد)، وراكبًا على دابّة زمانه – أي الحمار – وهو أمر كذلك غير مستبعَد، ثم جاء كُتّاب الأناجيل فصاغوا الحدث بلغة الكتاب المقدس ليبيّنوا توافق حياة عيسى مع نبوءاته.
ولو مضينا أبعد من ذلك، لرأينا رجلاً مثل جيمس نايلر (ت. 1660م) من طائفة الكويكرز يدخل مدينة بريستول الإنكليزية عام 1656م راكبًا حمارًا، ونساءٌ ينثرن أغصان الشجر أمامه، وهنّ يردّدن: «قدوس، قدوس، قدوس». فهل يعني ذلك أن الكويكرز اختلقوا قصة دخول المسيح؟ قطعًا لا، بل لقد أراد نايلر أن يتمثل بصورة المسيح كما نُقلت في الكتب. وكذلك الشأن في بعض ما يبدو شُبهات زمانية في الأحاديث النبوية؛ قد يكون بعض المسلمين في عصور لاحقة قد أرادوا أن يُطابقوا أعمالهم وسِيَرهم مع أقوال النبي ﷺ، لا اختلاقًا بل تنسيبًا وتفسيرًا واستلهامًا.
وافق علماء الحديث المسلمون وغير المسلمين على حدٍّ سواء على أنّ كثيرًا من الأحاديث قد وُضِعت. وأرى أنّ شرح كيف حدث ذلك يتطلّب فهم الخيارات التي انتهجها التقليد السنّي أكثر مما يتطلّب التشكيك في فعالية منهجهم النقدي نفسه في فحص الحديث. ذلك أن نظام الجرح والتعديل السنّي، في نظريّته وتطبيقه كليهما، كان طريقة فعّالة في التثبّت من صحة الأخبار، إذ اشترط المصدر، وفتّش في موثوقيته، وطلب له شواهد. والحق أن المراسلين الإخباريين في زمننا يعملون على نحو مشابه.
وقد استشهد بعض المستشرقين الغربيين، كالهولندي يويْنبول (ت 2010) والبريطاني مايكل كوك، بظاهرة التدليس –وهو أن يروي المحدّث عن شيخ له ما لم يسمعه منه، ولكن بصيغة توهم السماع– وعدّوها الثغرة التي نُسبت بها الأحاديث إلى كبار الرواة، أو رُكّبت بها أسانيد زائدة. وقد قال يويْنبول إنّ «التدليس لم يكن يُكتشف تقريبًا».
غير أنّ علماء الحديث المسلمين منذ منتصف القرن الثاني للهجرة، كانوا شديدي الحرص على تتبّع الرواة الذين دلسوا، وبيان متى وقع التدليس. فقد قال شعبة بن الحجاج (ت 160هـ): «التدليس أخو الكذب»، ودرس مرويات أستاذه قتادة بن دعامة (ت 117هـ) بدقة ليُميّز بين ما سمعه قتادة من شيخه مباشرة وما فيه واسطة غير مذكورة. وكان يحيى بن سعيد القطان (ت 198هـ) لا يتوانى عن وصف الحديث بالتدليس، ولو كان راويه مثل سفيان الثوري (ت 161هـ)، على جلالة قدره. ثم جاء بعدهم نقّاد كبار، كعلي بن المديني (ت 234هـ) والحسين الكرابيسي (ت 245هـ)، وغيرهما، فألّفوا مجلّدات تُحصي أسماء من دلس، وتُبيّن درجات تدليسهم.
وقد زعم يويْنبول أن المنهج النقدي الذي اتّبعه المحدّثون لم يكن يلحظ احتمال اختلاق الأسانيد برمّتها. ولكنّ تركيزهم الشديد على التوثيق والمقارنة بين الروايات كان في جوهره وسيلة لرصد الرواة الذين ينفردون بأسانيد لا يرويها سائر تلاميذ الشيخ. ولو أن راوياً اخترع أسانيد مختلقة، فإنهم كانوا يعدّونه ممن «لا يُتابع عليه» أو ممن يروي «المنكر». والمثال الذي يُضرب هنا أن عدد الأحاديث المنسوبة إلى ابن عباس يبدو كأنّه يتضخّم على نحو لا يُصدّق كلما مرّ الزمن، ولكن هذا لا يكون إلا إذا أغفلنا التمييز بين ما رواه ابن عباس سماعًا من النبي ﷺ، وهو عدد قليل، وبين ما قال فيه: «قال رسول الله»، وكان قد سمعه من صحابيٍّ أكبر منه لم يذكره.
ولا شك أن أحكام العلماء المسلمين على صحّة الأحاديث تحتاج إلى نظر وتفحّص، ولا يجوز قبولها دون تمحيص. ولكنّ المستشرق الألماني هارالد موتسكي، وغيره، قد بيّنوا أن طريقة علماء المسلمين في تمحيص الحديث المكذوب كانت أنجع بكثير مما ظنه المستشرقون الأوائل كغولدزيهر ويويْنبول. إلا أنّ علماء السنّة لم يطبقوا هذا المنهج النقدي على كلّ شيء، بل اختاروا مواضع تطبيقه. فأئمة النقد من أهل السنّة الأوائل، كَسفيان الثوري، وابن المبارك (ت 181هـ)، وأحمد بن حنبل (ت 241هـ)، ويحيى بن معين (ت 233هـ)، وابن أبي حاتم الرازي (ت 327هـ)، كانوا يُشدّدون في أسانيد ما يتعلّق بالأحكام والعقائد، ويتساهلون في ما يروى عن المغازي، وفضائل الأشخاص والأعمال، والمواعظ، وأخبار الملاحم، والآداب، وتفسير القرآن. وقد نبّهت الباحثة نبيهة أبوت (ت 1981) إلى أنّ هذا النوع من الروايات كان ينفذ بسهولة من خلال فلاتر النقد الحديثي. ومن الشواهد على هذا ، أن جامع الترمذي (ت 279هـ) كان هو وحده من بين أصحاب الكتب الستة الذي وضع لكل حديث في كتابه حكمًا نقديًا صريحًا. وقد تبيّن عند النظر في أبواب الأحكام أن نسبة الأحاديث التي وصفها الترمذي بأنها «غريبة» –أي تفتقر إلى التوثيق الكافي– كانت ضئيلة نسبيًا: ففي باب الزكاة والصوم مثلًا بلغت 17%، وفي باب الفرائض لم تتجاوز 7%. أما في الأبواب غير الفقهية، فقد ارتفعت النسبة ارتفاعًا ملحوظًا: ففي باب الفتن بلغت 35%، وفي باب المناقب 52%، وفي باب الدعوات 50%، وفي باب الآداب 27%. فإن كانت المشابهة والموافقة (الصحة) هي حجر الزاوية في نقد الحديث، فإن الترمذي قد أرخى هذا الضابط في غير أبواب الفقه. والمؤسف أن أغلب الموضوعات التي يرى الباحثون الغربيون أنها الأكثر أهمية –كالتاريخ السياسي، والرؤى الأخروية، وتفسير القرآن– لم تكن من أولويات المحدّثين السنّة. وربما كان هذا التركيز على الفقه دون غيره هو ما فتح الباب لكثرة الأحاديث الضعيفة في مصنفات الحديث، لا عيبًا في المنهج السنّي في نفسه.
ماخوذ مقال للمؤلف بعنوان: «النقاط العمياء: أصول المنهج الغربي في نقد الحديث»
Blind Spots: The Origins of the Western Method of Critiquing Hadith



