النشر العربي: بين مجد البدايات وتحديات الحاضر
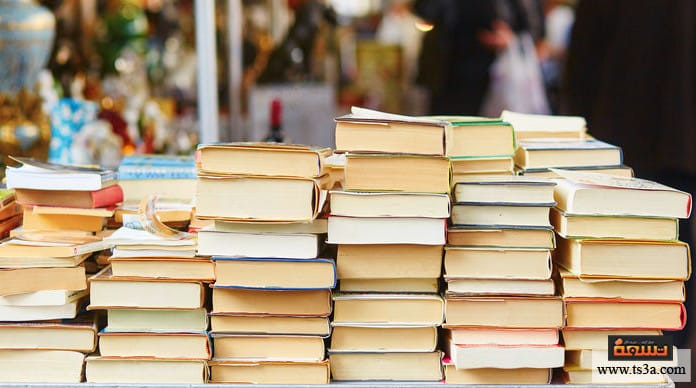
خالد دعيبس
مرّت صناعة النشر في العالم العربي برحلة طويلة، مفعمة بالأمل، ولكنها لم تخلُ من العثرات. فمنذ بزوغ فجر الطباعة، تبوأت بعض العواصم العربية مكانة رفيعة في هذا الميدان، فبرزت بيروت أولاً، ثم القاهرة وبغداد، حتى قيل: “مصر تؤلف، بيروت تنشر، والعراق يقرأ”. ومع مرور الزمن، بدأت دور النشر تتوسع بهدوء، حتى غدت حاضرة في معظم أرجاء العالم العربي.
في سبعينيات القرن الماضي، شهدت صناعة النشر ذروة من الازدهار، بفضل المعارض العربية التي أقيمت برعاية حكومية مجانية، شملت حتى الإقامة للناشرين وشراء الكتب المتبقية في نهاية كل معرض. هذا الدعم أسهم في خلق بيئة خصبة للناشرين، وشجعهم على المشاركة الواسعة في الفعاليات الثقافية في مختلف البلدان العربية.
ومع انتشار الجامعات ومراكز البحوث، ازداد عدد المؤلفين، وارتفعت حاجة الطلبة للكتب والمراجع، ما ساهم في نشوء عدد متزايد من دور النشر العربية. ولم يكن للإنترنت أن يتأخر كثيرًا؛ فقد شكّل ظهوره أداة دعائية فعّالة للكتب، وساهم في توسيع قاعدة القرّاء بشكل غير مسبوق.
لكن، كما لكل نهضة عقبات، فإن قطاع النشر لم يسلم من التحديات في الألفية الجديدة. ويمكن تلخيص أبرز هذه التحديات في النقاط التالية:
اولاً: هيمنة الإنترنت على مصادر المعرفة
لم يعد الكتاب الورقي المصدر الحصري للعلم والمعرفة، بل أصبح “غوغل” هو المرجع الأوسع والأسرع، ما أثّر سلبًا على الإقبال على الكتب المطبوعة.
ثانياً: ارتفاع تكاليف الطباعة وقرصنة المحتوى
سواء في التأليف أو الترجمة، فإن تكاليف النشر باتت عبئًا ثقيلاً، أضيف إليه خطر القرصنة الإلكترونية، التي سلبت حقوق المؤلف والناشر على حد سواء.
ثالثاً : تراجع الإبداع والتأليف
الصراعات الداخلية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وهجرة الكفاءات، كلها عوامل أثرت في الحراك الثقافي وأضعفت إنتاجية الكتّاب.
رابعاً : غياب ثقافة القراءة في الأجيال الجديدة
تقاعس الأسرة والمدرسة عن غرس حب القراءة، مقابل انشغال الجيل الجديد بالألعاب الإلكترونية، أضعف الرابط بين النشء والكتاب.
خامساً : ضعف اللغة العربية في المؤسسات التعليمية
التعليم بلغات أجنبية في كثير من الدول العربية، أسهم في إضعاف اللغة العربية لدى الشباب، فباتوا ينفرون من الكتب المكتوبة بلغتهم الأم.
سادساً : غياب دراسات موجهة لسلوك القراءة لدى الجيل الجديد.
لا توجد دراسات حديثة توضح توجهات القارئ العربي الشاب، هل يفضل الرواية؟ أم الكتاب العلمي؟ هل يهتم بالفكر؟ أم بالتكنولوجيا؟ في ظل هذا الغياب، تظل دور النشر في حالة تخمين.
سابعاً : اختلاف نمط الحياة وصعوبة تخصيص وقت للقراءة
على عكس المجتمعات الغربية التي تستثمر وقت التنقل في القراءة، فإن نمط الحياة العربي لا يوفر مثل هذه المساحة، وهو ما انعكس على مبيعات الكتب.
ثامناً : ضعف المؤسسات الثقافية غير الربحية
معظم مؤسسات النشر هدفها ربحي بحت، ما يجعلها عرضة للتوقف عند أول أزمة، في ظل غياب الدعم المؤسسي الثقافي طويل الأمد.
تاسعاً : المعارض العربية: بين الدعم والعبىء
رغم أن معارض الكتب أصبحت ملاذًا رئيسيًا للناشر العربي، فإن تكاليف المشاركة (إيجارات، شحن، إقامة، تذاكر…) باتت تثقل كاهله، حتى أصبحت هذه المعارض مصدر استنزاف بدلاً من كونها دعامة.
ختامًا… كيف ننهض من هذه المحنة؟
صناعة النشر اليوم تمر بمرحلة دقيقة. وبين التحديات التقنية والاجتماعية والاقتصادية، يظل السؤال الأهم: كيف نعيد للكتاب العربي مكانته؟ كيف نخلق بيئة تعيد الاعتبار للغة، وتشجع القراءة، وتدعم الكاتب والناشر على حد سواء؟



