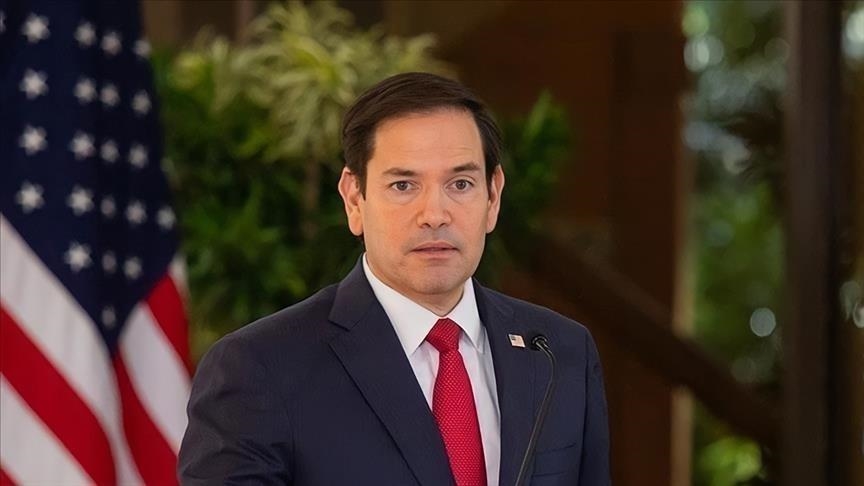المجتمع كما هو… لا كما تتخيله النخب

حكيم شملال
الحشد الهائل والجموع التي حجت لاستقبال الفقيه والواعظ سعيد الكملي قلبت فرضيات كانت تقدم باعتبارها مسلمات، رأسا على عقب، وأربكت خطابا كان يعتقد أنه يقرأ تحولات المجتمع بدقة.
وقد عبر موقع ناظورسيتي في مقاطع من مقاله عن هذا الارتباك باستغراب، يلخص جانبا كبيرا مما دار في الساحة السياسية والفكرية بالناظور، إذ أشار إلى أنه “لوحظ حضور وجوه غريبة عن سياق المناسبة”، مضيفا “كما لوحظ، بالموازاة مع الاختلالات التنظيمية، حضور بعض الوجوه التي لا تربطها أي صلة بالشأن الديني أو العلمي، ولم يعرف عنها اهتمام بالعلم أو بالمجالس المعرفية”.
هذا المشهد أعاد إلى الذهن ما تعلمته أوروبا، عبر التجربة لا عبر التنظير، أن غالبية المسلمين، مهما بلغ مستوى اندماجهم في المجتمع الأوروبي، ومهما انغمس بعضهم في أنماط العيش الغربية، بما فيها المتعة والعبث والتناقضات الشخصية، فإنهم عند لحظة الصدمة أو الاستفزاز الرمزي، خصوصا حين تمس حرمة الإسلام أو تستحضر شعاراته الكبرى، يستعيدون انتماءهم الديني بشكل تلقائي وعاطفي، وقد يدافعون عنه دون وعي أو حسابات عقلانية، حتى وإن كانوا في لحظة شخصية لا تعكس التزاما دينيا ظاهريا.
غير أن بعض التوجهات والتنظيمات الفكرية هنا في المغرب وخاصة الناظور لم تستوعب هذا الدرس بعد. إذ تذهب إلى افتراض جاهز مفاده أن التحولات التربوية والفكرية المصاحبة لتعاقب الأجيال، وهي تحولات طبيعية وضرورة تاريخية، ستقود بالضرورة إلى جيل أكثر تحررا اعتقاديا، وأكثر ميلا إلى الفردانية والحرية الدينية، باعتبار ذلك “موضة” الفلسفة السائدة اليوم. ويبنى هذا الافتراض على أن الأجيال الجديدة، مع تغير مستوى الوعي وتطور التفكير، ومع التقدم العلمي والتحولات في فلسفة الاجتماع، ستعيد بالضرورة النظر في التمثلات الدينية او الصورة الذهنية عن الدين، أو ستراجع المفاهيم الاعتقادية، وربما تتجاوزها.
غير أن الواقع الاجتماعي لا يسير بهذه الخطية المطمئنة، فمهرجانات الموسيقى، التي يحج إليها الآلاف، ولنأخذ مثالا مدينة الناظور، حيث يرقص الشباب في الفضاءات المفتوحة ويعبرون عن حرية فردية تقدم بوصفها تجسيدا مثاليا لما تنادي به الحداثة، لا تعني بالضرورة تحولا عميقا في البنية القيمية أو في الوعي الاعتقادي. كما أن الخطابات المتداولة حول “التحرر الفكري” في المنابر الحوارية والمنصات الثقافية، قد توهم بأن الغطاء السائد فوق العقل الناظوري، أو المغربي عموما، هو غطاء حداثي أو عقلاني أو متجاوز للدين، بينما الواقع يكشف عن تعايش معقد بين سلوكيات حداثية سطحية، وهوية دينية راسخة تعود للظهور بقوة كلما تعرضت للامتحان الرمزي.
سياسيا، ينعكس هذا الواقع في كون الخطاب الديني يظل الأقرب إلى المواطن الناظوري من أي خطاب آخر، إذ لا يستطيع أي خطاب حداثي أو حزبي أن يحشد عشر ما تحشده اللقاءات ذات الطابع الديني. فالتنظيمات الحداثية لا تستقبل روادا، والتنظيمات الحزبية تعاني عزوفا واضحا، بينما يستمر الخطاب الديني في استقطاب جمهور متنوع، يتجاوز الفئات التقليدية المتوقعة.
أمام هذا المعطى، لا ينظر إلى الخطاب الديني بوصفه ظاهرة اجتماعية قابلة للفهم والتحليل، بل ينظر إليه غالبا كمنافس سياسي يصعب هزيمته. وبدل الاشتغال على تطوير خطاب بديل قادر على الإقناع والتجذر، يتم اللجوء إلى محاربته رمزيا، عبر التقليل من شأنه، أو تصوير من يتبناه باعتباره متجاوزا للتاريخ أو “داس عليه الزمن”. غير أن هذا الأسلوب لا يزيد الفجوة إلا اتساعا، لأنه يواجه واقعا اجتماعيا حيا بخطاب إقصائي، ويعالج عجزا سياسيا بتوصيف ثقافي متعال، بدل مساءلة الذات وإعادة بناء الثقة مع المجتمع. والمشكلة في النهاية ليست في المجتمع، بل في الخطابات التي تصر على قراءة مجتمع متخيل، بدل الإنصات إلى المجتمع كما هو.
المصدر: صفحة الكاتب على منصة فيسبوك.