العلوم في المجتمعات الإسلامية: مقاربات تاريخية وآفاق مستقبلية – قراءة في مشروع إعادة بناء الوعي العلمي الإسلامي
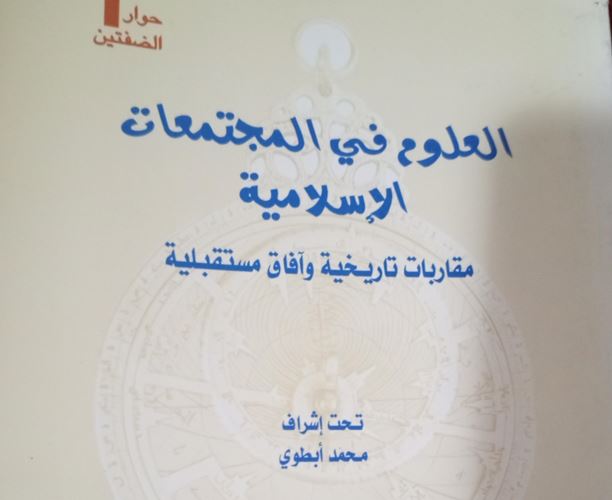
حمزة مولخنيف
يمثل كتاب «العلوم في المجتمعات الإسلامية: مقاربات تاريخية وآفاق مستقبلية» محاولة فكرية وعلمية جادة لإعادة التفكير في مسألة العلم داخل الحضارة الإسلامية، لا من زاوية التمجيد التاريخي ولا من منظور الندب الحضاري، بل من موقع التحليل الإبستيمولوجي الذي يسعى إلى مساءلة علاقة المعرفة العلمية بالتحول الحضاري، وبالهوية الفكرية، وبالشروط التاريخية التي احتضنت أو أعاقت تطورها.
فهو ليس جمعًا لأوراق علمية متفرقة بقدر ما هو بناء تصوري يحاول أن يؤسس لوعي جديد بمفهوم «العلم» في الإسلام، بوصفه ظاهرة حضارية كلية تتجاوز مجالات التخصص الضيقة نحو الأفق القيمي والمعرفي والإنساني العام. ومن هنا يمكن النظر إلى الكتاب باعتباره ثمرة لجهد علمي منسجم يجمع بين التاريخ والفكر والمنهج، ويسعى إلى إعادة وصل ما انقطع بين المعرفة والروح، وبين العلم والوجود، في ظل واقع معاصر طغت عليه الرؤية الأداتية للعلم وانفصل فيه التفكير العلمي عن السؤال القيمي.
لقد انبثقت فكرة الكتاب من حاجة موضوعية وملحة إلى مساءلة التصور الشائع عن «العلم الإسلامي» بين مدرستين متقابلتين: الأولى تميل إلى تقديس التراث العلمي القديم بوصفه نموذجًا مكتفيًا بذاته، والثانية تميل إلى القطع معه لصالح النموذج الغربي الحديث باعتباره الطريق الوحيد نحو النهضة والتقدم.
والكتاب، في هذا السياق، يتخذ مسافة نقدية من الاتجاهين معًا، إذ يقدّم مقاربات متعددة تتقاطع في مقصدها الأساس، وهو بناء وعي علمي متجدد يستلهم التراث ولا يكرّره، ويتفاعل مع الحداثة دون أن يذوب فيها.
ولعلّ هذا التوازن هو ما يميّز الكتاب، إذ يعيد ترتيب العلاقة بين الماضي والمستقبل عبر مفهوم «الاستئناف الحضاري» الذي يتجاوز الرؤية الخطية للتاريخ نحو منظورٍ جدليٍّ يرى في العودة إلى الجذور مدخلًا لتجاوز المأزق المعرفي الراهن.
إن أول ما يلفت الانتباه في الكتاب هو الطابع المنهجي الذي يوجّه مقالاته، إذ ينهض على فكرة مركزية مفادها أن العلم في المجتمعات الإسلامية لم يكن مجرد تراكم تقني أو رياضي أو طبيعي، بل كان نسقًا معرفيًا مشدودًا إلى رؤية للعالم، ومؤطرًا بنظام قيمي وأخلاقي يحكم علاقته بالإنسان والكون.
ومن ثَمّ، فإن مقاربة العلم في هذا الإطار لا يمكن أن تنفصل عن السؤال الفلسفي حول معنى المعرفة وحدودها وغايـاتها، ووظيفتها في تحقيق التوازن بين المادة والروح. فالكتاب يذكّر القارئ بأنّ ازدهار العلوم في العصور الإسلامية الكلاسيكية لم يكن نتاج صدفة تاريخية أو محض تراكم تجريبي، بل ثمرة تفاعلٍ خصب بين النص والتأمل، بين النقل والعقل، بين الدين والفكر، وهو تفاعل مكّن من إنتاج معرفة متكاملة لم تنفصل فيها الرياضيات عن الميتافيزيقا، ولا التجريب عن المقاصد الأخلاقية.
ويُبرز الكتاب أنّ هذا التفاعل بين العقل والنص لم يكن قائمًا على التنافر أو التبعية، بل على الحوار والتكامل، فالعلم في السياق الإسلامي وُلد من رحم سؤال وجودي لا من نزوع نفعي، وكان الإنسان فيه غايةً للمعرفة لا وسيلة.
بهذا المعنى، يشكّل العلم في التجربة الإسلامية وجهًا من وجوه العبادة، ومظهرًا من مظاهر السعي إلى فهم سنن الله في الكون، لا إلى امتلاكها أو إخضاعها. ومن هذا المنطلق، فإن الوعي العلمي الإسلامي لم يفصل بين النظر والعمل، ولا بين الحقيقة والمنفعة، بل أسّس لفكرة «المسؤولية المعرفية» التي تجعل من العالم شريكًا في بناء المعنى الكوني لا مجرد فاعلٍ في معملٍ مغلق.
هذه الرؤية المندمجة بين العلم والإيمان، بين البحث والتزكية، هي التي مكّنت العقل الإسلامي من أن يبدع في مجالات الرياضيات والفلك والطب والفلسفة دون أن يفقد مركزه القيمي أو يختل توازنه الداخلي.
غير أن الكتاب لا يكتفي بإعادة إحياء هذا التراث في بعده المثالي، بل يمارس عليه نقدًا إبستيمولوجيًا رصينًا. فهو يُظهر أنّ الفكر العلمي الإسلامي لم يكن معصومًا من التناقضات الداخلية، وأنّ تراجعه التاريخي لم يكن مجرد نتيجة لعوامل خارجية أو استعمارية، بل ارتبط بتحولات في بنية التفكير نفسها، حين غلبت النزعة النقلية على الروح النقدية، وحين تحوّل العلم من مجال للاجتهاد والإبداع إلى مجال للحفظ والتكرار.
بهذا المعنى، يتبنى الكتاب مقاربة نقدية مزدوجة: نقد الانبهار بالغرب من جهة، ونقد الجمود على التراث من جهة أخرى، ساعيًا إلى استعادة القدرة على إنتاج علم منغرس في الثقافة الإسلامية، منفتح على الكونية، ومؤسس على قاعدة الاجتهاد الدائم.
وتتجلّى في ثنايا الكتاب رؤية فلسفية واضحة للعلم كقيمة حضارية لا كأداة هيمنة. فالعلم في تصوره ليس محايدًا، بل هو مشروط بمرجعية ثقافية وأخلاقية تحدّد مساراته واتجاهاته. وهذا الوعي النقدي يجعل من السؤال عن «العلم في الإسلام» سؤالًا عن «الإنسان في الإسلام» في المقام الأول، لأنّ نمط المعرفة يعكس دائمًا صورة الإنسان الذي ينتجها.
فالكتاب يذكّر بأنّ أزمة العالم الإسلامي المعاصر ليست في نقص المختبرات أو ضعف التمويل، بل في غياب الرؤية الكونية التي تؤطر الفعل العلمي وتمنحه المعنى. فحين ينفصل العلم عن القيم، يتحوّل إلى تقنية بلا بوصلة، وحين ينفصل عن التاريخ، يفقد جذوره وهويته.
ومن هنا تأتي دعوة الكتاب إلى إعادة تأسيس العلاقة بين العلم والأخلاق، بين البحث والتزكية، بين الفعل المعرفي والغاية الإنسانية.
وفي هذا الأفق، يستعيد الكتاب التجربة المغربية في تاريخ العلوم بوصفها نموذجًا مصغرًا عن الإمكان الحضاري الإسلامي. فالبيئة المغربية كانت ولا تزال مجالًا لتفاعل فريد بين البعد الروحي والبعد العقلي في إنتاج المعرفة، حيث امتزجت عند علمائها النزعة البرهانية بالنزعة الذوقية، والعقل بالحكمة، والبحث بالتأمل.
إنّ إبراز هذا البعد المغربي لا يأتي في الكتاب بدافع الإقليمية، بل من أجل التأكيد على أنّ التجربة الإسلامية في العلم لم تكن مركزية أو أحادية، بل كانت شبكة واسعة من المراكز العلمية الممتدة من قرطبة إلى سمرقند، ومن فاس إلى بغداد. ومن خلال هذا التعدد في البيئات والمناهج، تشكّلت وحدة فكرية عميقة جعلت من العلم الإسلامي نظامًا مفتوحًا على التنوع والاختلاف.
يتقدم الكتاب أيضًا بتحليل نقدي لتأثير العولمة على الوعي العلمي في المجتمعات الإسلامية، مبرزًا أنّ التحدي الأكبر لا يكمن في مجاراة الغرب في التكنولوجيا أو في الكمّ البحثي، بل في استعادة القدرة على «تأصيل الحداثة» في منظومة قيمية خاصة. فالعولمة، كما يشير الكتاب، ليست مجرد حركة تبادل معرفي، بل هي منظومة فكرية واقتصادية تُعيد تشكيل علاقة الإنسان بالعلم وبالعالم.
وفي ظل هذا السياق، تصبح الحاجة إلى خطاب علمي إسلامي معاصر أكثر إلحاحًا، خطاب لا ينكفئ على ذاته ولا يذوب في الآخر، بل يشارك في النقاش الكوني حول مصير الإنسان والمعرفة والتقنية. إنّ الكتاب يقدّم بذلك مساهمة في بلورة ما يمكن تسميته «إبستيمولوجيا المشاركة»، التي تجعل من الثقافة الإسلامية طرفًا فاعلًا في الحوار العالمي حول مستقبل العلم لا مجرد متلقٍ أو مستهلك.
ويُبرز التحليل الكامن في نصوص الكتاب أنّ استئناف الفعل العلمي في المجتمعات الإسلامية يتطلب تجاوز ثنائية التقليد والقطيعة، وبناء رؤية مقاصدية للعلم تعيد ترتيب أولوياته في ضوء حاجات الإنسان والكون. فليس المطلوب استيراد النموذج الغربي كما هو، ولا إعادة إنتاج النموذج التراثي كما كان، بل بناء نموذج ثالث قوامه الاجتهاد والإبداع، يقوم على وعي نقدي بالذات والآخر معًا.
وفي هذا السياق، يعيد الكتاب طرح سؤال المنهج باعتباره المدخل إلى كل إصلاح علمي، إذ لا يمكن الحديث عن نهضة معرفية دون مساءلة منطق التفكير السائد في التعليم والبحث، ودون تحرير العقل من التبعية والتجزئة. فالمنهج في الفكر الإسلامي، كما يُفهم من السياق العام للكتاب، لم يكن مجرد أداة تنظيم للمعرفة، بل كان رؤية للعالم، ومنظومة قيمية تنعكس في طريقة السؤال والإجابة معًا.
وفي مقابل الرؤية الغربية التي اختزلت العلم في بعده التقني، يذكّر الكتاب بأنّ التجربة الإسلامية ربطت بين العلم والحكمة، بين المعرفة والوجود، فكانت تنظر إلى الطبيعة لا كموضوع للسيطرة، بل كآية دالة على الخالق. هذه الرؤية التوحيدية للكون جعلت من البحث العلمي مسارًا من مسارات معرفة الله، ومن الفعل المعرفي جزءًا من الفعل العبادي.
غير أنّ الانفصال بين العلم والدين في العصور الحديثة أدّى إلى انكسار هذا التوازن، فتحوّل العلم إلى سلطة، وفقدت المعرفة بعدها الغائي. ومن هنا تأتي أهمية الدعوة التي يطلقها الكتاب إلى إعادة تأسيس العلاقة بين الإبستيمولوجيا والأخلاق، وإلى بناء «علم إنساني» يتجاوز المنظور الأداتي، ويعيد للإنسان مركزه في منظومة المعرفة.
يتميز الكتاب أيضًا بقدرته على الجمع بين التاريخ والتحليل، فهو لا يكتفي بوصف ماضي العلوم في الإسلام، بل يقرأ هذا الماضي بوصفه مخزونًا للقدرة على التجدد. إنّه يتعامل مع التاريخ لا كمتحفٍ للإنجازات، بل كمختبرٍ للأسئلة التي لم تُستنفد بعد.
ومن خلال هذا المنظور الدينامي، يتحوّل التاريخ العلمي الإسلامي إلى فضاء للتأمل في إمكانات الحاضر والمستقبل، لا إلى مجرد مادة للافتخار أو الندم. فالتاريخ، في القراءة التي يقترحها الكتاب، هو مصدر للفاعلية لا للحنين، وذاكرة للممكن لا للماضي المنغلق.
من جهة أخرى، يقدّم الكتاب تصورًا ضمنيًا حول وظيفة الجامعة والبحث العلمي في العالم الإسلامي، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منظومات التعليم. فهو يدعو إلى تجاوز النموذج التلقيني نحو نموذج تفاعلي يجعل من الجامعة فضاءً لإنتاج المعرفة لا لتلقينها، ومن الباحث فاعلًا في صناعة الفكر لا ناقلًا له.
وهذا التوجه يعكس وعيًا عميقًا بأن النهضة العلمية لا تتحقق بالوسائل التقنية فحسب، بل تحتاج إلى إعادة بناء الإنسان الذي يفكر ويبحث، وإلى تجديد العلاقة بين المعرفة والمجتمع. إنّ العلم، في الرؤية التي يحملها الكتاب، لا ينفصل عن مشروع حضاري شامل يستهدف إعادة تأسيس قيم العقل والنقد والاجتهاد، وإحياء روح التساؤل التي كانت محركًا أساسيًا في التجربة الإسلامية الأولى.
وهكذا يتضح أن القيمة الكبرى لهذا الكتاب تكمن في قدرته على إعادة طرح سؤال العلم داخل الإسلام من داخل الوعي الذاتي للحضارة نفسها، لا من موقع الدفاع أو التبرير. فهو لا يسعى إلى إثبات أن المسلمين كانوا علماء، بل إلى فهم كيف أنتجوا علمًا له منطق خاص، وكيف يمكن لهذا المنطق أن يتجدّد اليوم في مواجهة تحديات العولمة والتقنية والمادية.
بهذا المعنى، يُمكن القول إنّ الكتاب يشكّل حلقة من حلقات التحوّل في الفكر العلمي الإسلامي المعاصر، إذ يقدّم مشروعًا لإعادة بناء الإبستيمولوجيا الإسلامية على أسس نقدية حديثة دون أن تفقد جذورها الروحية.
إنّ القراءة المتأنية لهذا العمل تكشف عن روح بحثية جادة تسعى إلى إعادة الاعتبار للفكر العلمي بوصفه أحد أركان النهضة الإسلامية الممكنة. فهو دعوة إلى مراجعة الذات، وإلى تجاوز الثنائيات المدمّرة التي شلّت الفكر العربي والإسلامي طويلًا: ثنائية النقل والعقل، التراث والحداثة، العلم والإيمان.
ومن خلال هذا المسار التحليلي المتماسك، يصبح الكتاب بمثابة مرآةٍ لتاريخنا العلمي ومختبرٍ لأسئلتنا الراهنة في آنٍ واحد، لأنه يضعنا أمام مسؤولية مزدوجة: مسؤولية فهم ماضينا كما كان، ومسؤولية بناء علمٍ جديدٍ كما يجب أن يكون.



