الذات الإنسانية في مجتمع المعلوميات
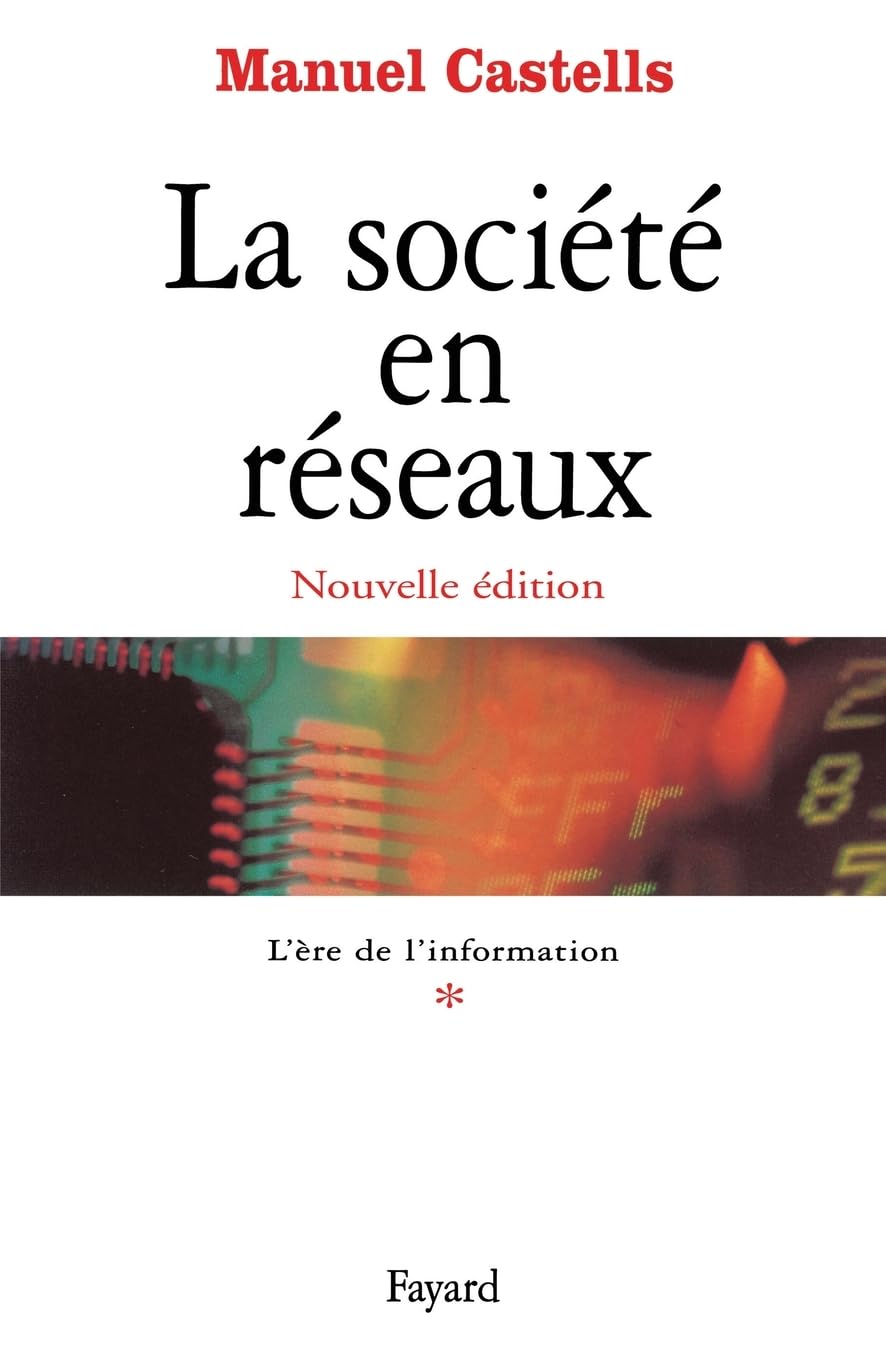
حسن صعيب
تُدمج تقنيات المعلومات الجديدة العالم في شبكات عالمية من الأدوات. ويُولّد التواصل عبر الحاسوب طيفًا واسعًا من المجتمعات الافتراضية. ومع ذلك، كان الاتجاه الاجتماعي والسياسي المميز في تسعينيات القرن الماضي هو بناء الفعل الاجتماعي والسياسي حول الهويات الأساسية، سواءً أكانت منسوبة إلى التاريخ والجغرافيا أو متجذرة فيهما، أو حديثة العهد في بحثٍ مُلِحٍّ عن المعنى والروحانية.
يبدو أن الخطوات التاريخية الأولى للمجتمعات المعلوماتية اتسمت بتفوق الهوية كمبدأ مُنظِّم. أفهم الهوية على أنها العملية التي يُدرك من خلالها الفاعل الاجتماعي ذاته ويُنشئ معناه، في المقام الأول، بفضل سمة ثقافية مُحددة أو مجموعة من السمات، مع استبعاد أي إشارة أوسع إلى هياكل اجتماعية أخرى.
لا يعني تأكيد الهوية بالضرورة عدم القدرة على الارتباط بهويات أخرى (على سبيل المثال، لا تزال النساء مرتبطات بالرجال) أو شمول المجتمع بأكمله في تلك الهوية (على سبيل المثال، تهدف الأصولية الدينية إلى تحويل الجميع). لكن العلاقات الاجتماعية تُعرّف تجاه الآخرين بمقتضى السمات الثقافية التي تُحدد الهوية. على سبيل المثال، يُعرّف يوشينو، في دراسته لمفهوم “نيهونجيرون” (فكرة التفرد الياباني)، القومية الثقافية تعريفًا جوهريًا بأنها هدف تجديد المجتمع الوطني من خلال خلق هوية ثقافية للشعب أو الحفاظ عليها أو تعزيزها عندما يُعتقد أنها معدومة أو مُهددة. وتعتبر القومية الثقافية الأمة نتاج تاريخها وثقافتها الفريدين، وتضامنًا جماعيًا يتمتع بسمات فريدة. (31)
بينما يرفض كالهون الطابع التاريخي الجديد للظاهرة، يُسلط الضوء أيضًا على الدور الحاسم للهوية في تحديد السياسة في المجتمع الأمريكي المعاصر، وخاصةً في حركات حقوق المرأة والمثليين وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وهي حركات “لا تسعى فقط إلى تحقيق أهداف عملية مُختلفة، بل تسعى أيضًا إلى تأكيد الهويات المُهمّشة باعتبارها منفعة عامة وذات أهمية سياسية”. (32). يذهب آلان تورين إلى أبعد من ذلك، مجادلاً بأنه “في مجتمع ما بعد الصناعة، حيث حلت الخدمات الثقافية محل السلع المادية في صميم الإنتاج، فإن الدفاع عن الذات، بشخصيتها وثقافتها، ضد منطق الأجهزة والأسواق، هو ما يحل محل فكرة الصراع الطبقي”. (33). لذلك، فإن القضية الأساسية، كما يؤكد كالديرون ولازرنا، في عالم يتسم بالعولمة والتجزئة المتزامنة، تتمثل في “كيفية الجمع بين التقنيات الجديدة والذاكرة الجماعية، والعلم العالمي وثقافات المجتمع، والشغف والعقل”. (34). كيف، في الواقع، ولماذا نلاحظ الاتجاه المعاكس في جميع أنحاء العالم، ألا وهو اتساع الفجوة بين العولمة والهوية، وبين الشبكة والذات؟
يشير ريموند بارغلو، في مقاله حول هذا الموضوع من منظور التحليل النفسي الاجتماعي، إلى المفارقة المتمثلة في أنه على الرغم من أن أنظمة المعلومات والترابط تزيد من قدرات الإنسان على التنظيم والتكامل، إلا أنها في الوقت نفسه تقوض المفهوم الغربي التقليدي للذات المنفصلة والمستقلة. يُسهم التحول التاريخي من التقنيات الميكانيكية إلى تقنيات المعلومات في تقويض مفاهيم السيادة والاكتفاء الذاتي التي شكّلت ركيزةً أيديولوجيةً للهوية الفردية منذ أن طوّرها الفلاسفة اليونانيون قبل أكثر من ألفي عام. باختصار، تُسهم التكنولوجيا في تفكيك النظرة العالمية ذاتها التي شجّعت في السابق.(35) ثم يُقدّم مُقارنةً مُلفتةً بين الأحلام الكلاسيكية المُسجّلة في كتابات فرويد وأحلام مرضاه في بيئة سان فرانسيسكو التكنولوجية المُتطورة في تسعينيات القرن الماضي: “صورة رأس […] وخلفها لوحة مفاتيح حاسوب مُعلّقة […] (أنا ذلك الرأس المُبرمج!)” (36)
هذا الشعور بالوحدة المطلقة جديدٌ مقارنةً بالتمثيل الفرويدي الكلاسيكي: “أولئك الذين يحلمون […] يعبرون عن شعور بالوحدة يُختبر كوجودي لا مفر منه، متأصل في بنية العالم. في عزلة تامة، تبدو الذات ضائعة في ذاتها لا رجعة فيها.(“37) ومن هنا يأتي البحث عن قدرة جديدة على التواصل حول هوية مشتركة مُعاد بناؤها.
على الرغم من بصيرتها، لا يمكن لهذه الفرضية إلا أن تكون جزءًا من التفسير. فمن جهة، قد توحي بأزمة ذات تقتصر على المفهوم الفردي الغربي، تهتز بفعل قدرة لا يمكن السيطرة عليها على التواصل. ومع ذلك، فإن البحث عن هوية جديدة وروحانية جديدة يحدث أيضًا في الشرق، على الرغم من الشعور الأقوى بالهوية الجماعية وتبعية الفرد التقليدية والثقافية للعائلة. يمكن اعتبار صدى أوم شينريكيو في اليابان بين عامي 1995 و1996، وخاصة بين الأجيال الشابة الحاصلة على تعليم عالٍ، أحد أعراض الأزمة التي تواجه نماذج الهوية الراسخة، إلى جانب الحاجة الماسة لبناء ذات جماعية جديدة، تمزج بشكل كبير بين الروحانية والتكنولوجيا المتقدمة (الكيمياء والبيولوجيا والليزر) وروابط الأعمال العالمية وثقافة الهلاك الألفي. (38) من ناحية أخرى، يجب أيضًا إيجاد عناصر إطار تفسيري أوسع لتفسير القوة المتنامية للهوية فيما يتعلق بالعمليات الكبرى للتغيير المؤسسي، المرتبطة إلى حد كبير بظهور نظام عالمي جديد. وهكذا، كما اقترح آلان تورين (39) وميشيل فيفيوركا (40،) يمكن ربط التيارات المنتشرة للعنصرية وكراهية الأجانب في أوروبا الغربية بأزمة هوية، أصبحت تجريدًا (أوروبيًا)، في الوقت الذي اكتشفت فيه المجتمعات الأوروبية، بينما تشهد هويتها الوطنية تتلاشى، وجودًا دائمًا للأقليات العرقية (وهي حقيقة ديموغرافية على الأقل منذ ستينيات القرن العشرين). أو، مرة أخرى، في روسيا والاتحاد السوفييتي السابق، يمكن ربط التطور القوي للقومية في فترة ما بعد الشيوعية، كما سأزعم لاحقا (المجلد الثالث)، بالفراغ الثقافي الناجم عن سبعين عاما من فرض هوية أيديولوجية حصرية، إلى جانب العودة إلى الهوية التاريخية الأساسية (الروسية، الجورجية) كمصدر وحيد للمعنى بعد انهيار الشعب السوفييتي الهش تاريخيا.
يبدو أن صعود الأصولية الدينية مرتبطٌ أيضًا بتوجه عالمي وأزمة مؤسساتية. نعلم من التاريخ أن هناك دائمًا أفكارًا ومعتقدات من مختلف الأنواع في الاحتياط، تنتظر أن تنبت في الظروف المناسبة. (41 ) ومن الجدير بالذكر أن الأصولية، سواءً كانت إسلامية أو مسيحية، انتشرت، وستستمر في الانتشار، في جميع أنحاء العالم في اللحظة التاريخية التي تربط فيها شبكات الثروة والسلطة العالمية بين عقد وأفراد ذوي قيمة عالية في جميع أنحاء العالم، بينما تفصل وتستبعد شرائح كبيرة من المجتمعات والمناطق، بل وحتى دولًا بأكملها. لماذا لجأت الجزائر، وهي من أكثر المجتمعات الإسلامية حداثةً، فجأةً إلى منقذيها الأصوليين، الذين تحولوا إلى إرهابيين (مثل أسلافهم المناهضين للاستعمار) عندما حُرموا من الفوز الانتخابي في انتخابات ديمقراطية؟ لماذا تجد تعاليم يوحنا بولس الثاني التقليدية صدىً لا يُنكر بين جماهير العالم الثالث الفقيرة، حتى يتسنى للفاتيكان تجاهل احتجاجات أقلية من النسويات في بعض الدول المتقدمة، حيث يُسهم تقدم الحقوق الإنجابية تحديدًا في تقليل أعداد الأرواح التي لم تُنجَز بعد؟ يبدو أن هناك منطقًا لإقصاء المُقصين، ولإعادة تعريف معايير القيمة والمعنى في عالمٍ تتضاءل فيه مساحة الأميين الحاسوبيين، والفئات التي لا تستهلك، والمناطق التي تفتقر إلى الاتصال الكافي. عندما تفصل الشبكة الذات، فإن الذات، فردية كانت أم جماعية، تُنشئ معناها دون مرجعية آلية عالمية: تصبح عملية الانفصال متبادلة حيث ينكر المُقصون المنطق الأحادي للهيمنة الهيكلية والإقصاء الاجتماعي. هذا هو المجال الذي يجب استكشافه، لا مجرد التعبير عنه. إن الأفكار القليلة التي طرحتها هنا حول المظهر المتناقض للذات في مجتمع المعلومات تهدف فقط إلى تحديد مسار بحثي لإعلام القراء، وليس إلى استخلاص أي استنتاجات محددة مسبقًا.



