الدراسات القرآنية بين القديم والحديث: محمد عابد الجابري
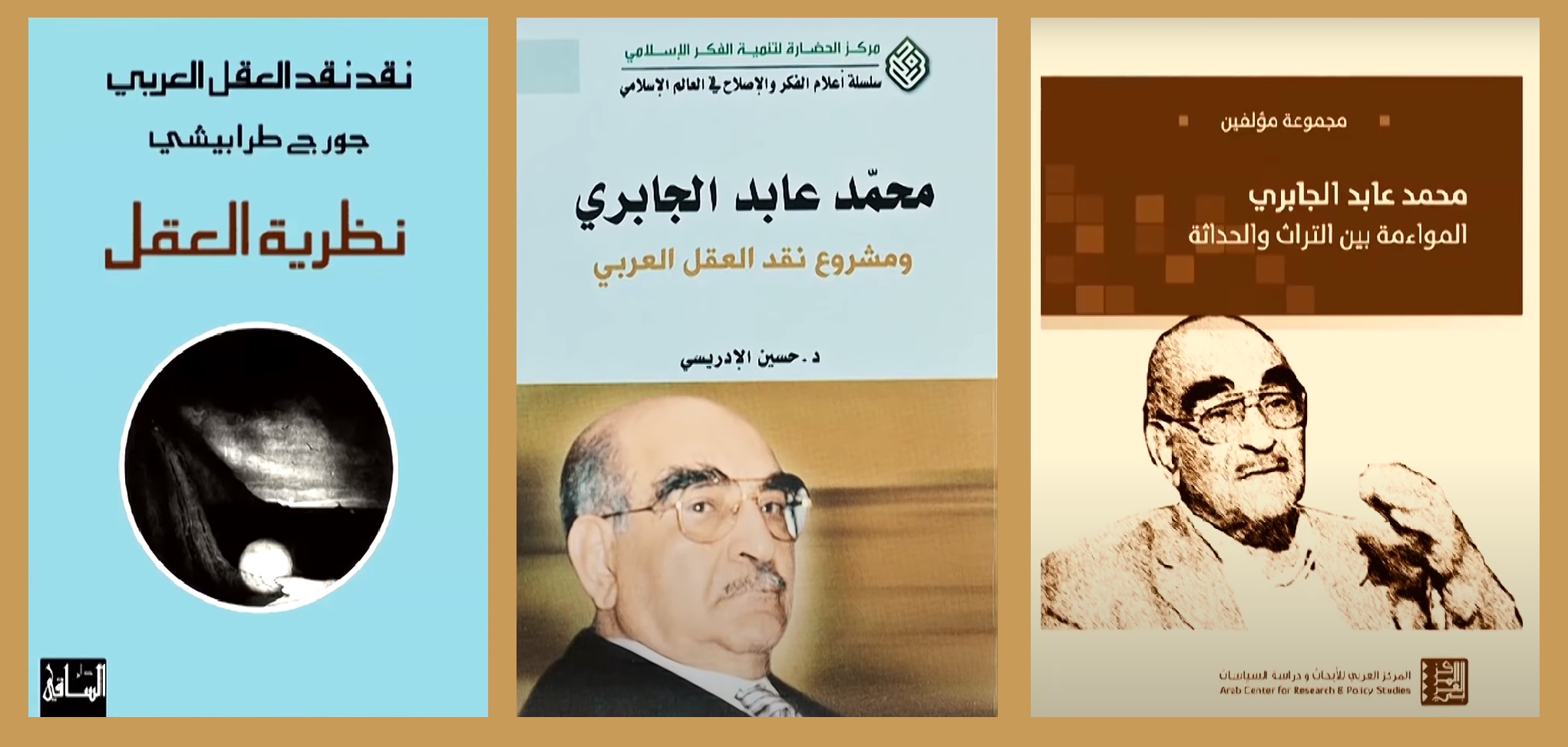
محمد أومليل
رجل من أهل العلم والفكر والنضال السياسي والنقابي والصحافي له سمعة طيبة وشهرة واسعة في العالم الإسلامي والعربي وبنسبة أقل في العالم قاطبة كون كتبه مترجمة إلى عدة لغات.
محمد عابد الجابري مغربي (2010،1935) مسقط رأسه شرق المغرب (فيكيك) أهلها مشهود لهم بالاستقامة والجدية وسلامة الفطرة (وذلك ملحوظ في شخص الجابري)، ابن عائلة فقيرة وعانى في بداية مشواره من الفقر والحرمان واشتغل من أجل كسب قوت يومه، حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة سنة 1970 من جامعة محمد الخامس (لم يدرس في السربون مثل العروي وأركون)، مفكر فيلسوف صحافي مناضل اشتراكي سياسي نقابي؛ كان قياديا ومنظرا ضمن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل أن يتفرغ للبحث الأكاديمي، وبعد أن رصد الدخن الذي حصل في مجال السياسة؛ وذاك ما لا يقبله رجل فكر ومبادئ.
مهتم كثيرا بالإبستمولوجيا والإسلاميات وابن رشد والأحداث السياسية القطرية والإقليمية والدولية وما يجري في العالم من أحداث وتقلبات وتحولات.
له عدة مؤلفات ورسائل (سلسلة مواقف) ومقالات في جوانب متعددة ضمن مجال المعرفة والعلم والسياسة والنقابة والمعيش اليومي للمواطن المغربي والعربي بشكل عام كونه اشتراكيا عروبيا.
سأذكر مؤلفاته التي لها علاقة بموضوعنا الذي نحن بصدد الاشتغال عليه “الدراسات القرآنية” والدراسات الإسلامية كونها مرتبطة بما سبق.
كان له اهتمام بالتراث الإسلامي مبكرا من مسيرته العلمية، من ضمن هذه الكتب:
– نحن والتراث
– تكوين العقل العربي
– بنية العقل العربي
– العقل السياسي العربي
– العقل الأخلاقي العربي
هذه الكتب شكلت مشروعه الفكري؛ “نقد العقل العربي”.
– الدين والدولة وتطبيق الشريعة
– مدخل إلى القرآن الكريم
– فهم القرآن الكريم.
بالإضافة إلى ما نشره، حول الإسلاميات، في سلسلة مواقف، ومقالات منشورة في مجلات وجرائد.
استنتج من خلال دراسته الإسلامية بعض الأفكار الرئيسية، التي أضحت أدوات تحليل، جمعها في ثلاثيات:
– البيان، العرفان، البرهان؛ توجهات ثلاثة بالنسبة للعقل العربي؛ الأول: نقل، الثاني: تصوف، الثالث: عقل. الجابري يميل للعقل البرهاني، ويرى أن المغرب له هذه الخصوصية، مقابل الشرق لهم ميول للبيان والعرفان؛ هذا الموقف جلب له خصوما من أهل الشرق، لا سيما تلميذه جورج طرابيشي. (هو نفسه اعترف بأنه مدين للجابري باهتمامه بالتراث حيث كان منبهرا به في بداية تعرفه على الجابري) ثم ما لبث أن انقلب عليه فألف عدة كتب يرد فيها على الجابري مفندا مشروعه الفكري تحت عنوان (نقد نقد العقل العربي)؛ فلم يرد عليه الجابري ولو مرة واحدة!
من ضمن مصطلحات المتداولة للجابري في بعض كتبه:
– العقل المستقيل؛ دوغمائي متشبت بالماضي غير منفتح على المستجدات المعرفية والعلمية؛ يعد مانعا من التقدم والتخلص من التخلف.
– الأفكار المتلقاة؛ قبول بأفكار دون مساءلة وتحقق وغربلة فيتم تبنيها وتكرارها واجترارها..
– المانع الأيديولوجي؛ مانع عن الرؤية الموضوعية والاعتراف بما عند الآخر المخالف من إيجابيات، ومن النقد الذاتي.
منهجه المعتمد في دراسته للقرآن ذكره في كتاب (مدخل إلى القرآن الكريم):
” كيف يمكن إذن، من الناحية المنهجية، التعامل مع القرآن بوصفه معاصرا لنفسه ومعاصرا لنا في نفس الوقت؟
لعل كثيرا من القراء الذين يتابعون أعمالنا يذكرون أننا قد حددنا لأنفسنا منذ أزيد من ربع قرن (منذ مقدمة “نحن والتراث” 1980) منهجا ورؤية فيما نقوم به من أبحاث في موروثنا الثقافي. من ركائز هذا المنهج/الرؤية: جعل المقروء معاصرا لنفسه ومعاصرا لنا في الوقت نفسه. ولما كان الأمر يتعلق هنا بالقرآن فإن أحسن طريق إلى تطبيق هذا المنهح/الرؤية في التعامل معه هو، في نظرنا، ذلك المبدأ الذي نادى به كثير من علماء الإسلام، مفسرين وغيرهم، وهو أن “القرآن يشرح بعضه بعضا” “(1).
ومع ذلك لم يلتزم بهذه القاعدة الأخيرة. كما سنرى لاحقا.
بالإضافة إلى اعتماده، في تفسيره للقرآن، على ترتيب النزول اقتداء بالمستشرق (ثيودور نولدكه).
أما منهجيته في تفسير كل سورة على حدة فهي كالتالي:
– تقديم
– نص السورة
– تعليق.
ذلك أهم عناصر منهجه في التعامل مع القرآن الكريم دراسة وتفسيرا.
حسب رأيي الشخصي، الجزء الأول من الكتاب ( المدخل) يتضمن قيمة مضافة جديرة بالاهتمام وقد استفدت منه كثيرا، أما تفسيره للقرآن فلم يشكل جديدا ذا مساحة شاسعة ملفتة للنظر، بل ربط القرآن بموطن نزوله ولم يتعداه ولم يربطه بعالمنا المعاصر إلا بقدر قليل؛ تفاديا، حسب نظره، الوقوع في التفسير الأيديولوجي الذي ذمه وحذر منه غير ما مرة..
اعتمد في تفسيره، بالضمن، على قاعدة: “العبرة بخصوص السبب لا بعمومه”؛ والصواب هو الاعتماد كذلك على: “العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب “؛ مقاربة شمولية موضوعية.
سأذكر تعليقه على مستهل سورة العلق على سبيل المثال لا الحصر:
تعليق:
ما يلفت النظر في هذه الآيات الخمس أنها تقرر العقيدة من خلال التركيز على مبدأين اثنين: خلق-علم، وربطهما أولا بمحور واحد هو الإنسان الشخص، والمقصود هنا به هو محمد (ص) بالذات…”!
مع أن العبرة، هنا بالذات، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي المراد ب “الإنسان” هو “الإنسان الجمع” (والمصطلح للجابري نفسه ويفسره: “يعني بني آدم”)؛ غريب هذه المفارقة بأن يربط “الإنسان بشخص محمد بالذات” وأن يعطي تفسيرا ل “الإنسان”: “الإنسان الجمع” “يعني بني آدم”؟!
لم يعطي لآيات العلم ما تستحقه من توضيح، مع أن ذلك يندرج ضمن تخصصه “الإبستمولوجيا”، بالإضافة إلى أنه لم يلتزم بما وعد به “القرآن يشرح بعضه بعضا”؛ لو طبقها على مستهل “سورة العلق” حول العلم لذكر أصناف العلم الواردة في القرآن (علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين)، ناهيك عن ذكر وسائل العلم (السمع، البصر، الفؤاد، النظر، التدبر، التفقه، التعقل، التفكر، الاعتبار، الاستبصار)، ولم يذكر أهمية العلم في القرآن كون مشتقات مادة (ع ل م) وردت في القرآن ما يقرب من ألف مرة !؟
لكن مما لا شك فيه أن الرجل أنفق أكثر من نصف عمره في الاشتغال على التراث الإسلامي وختم بكتاب حول دراسة القرآن وتفسيره؛ كأن القدر هيأه عدة عقود في الاشتغال على الدراسات الإسلامية ليختم مسيرته العلمية بتفسير القرآن!
مما صدر عنه، رحمه الله، الفيئة التي استفادت من كتبي؛ الإسلاميون!
وأنا واحد منهم ومدين له بذلك.
تغمده الله بواسع رحمته..
المراجع:
محمد عابد الجابري، نحن والتراث، ص 21.



