الدراسات القرآنية المعاصرة: بانوراما كتب التفاسير
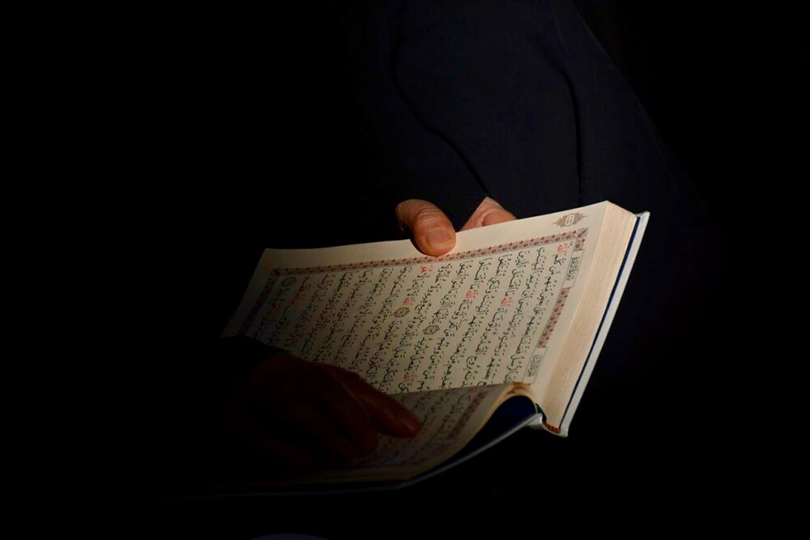
محمد أومليل. كاتب وباحث من المغرب
كل ما تقدم ذكره من أصول وقواعد، بشيء من التفصيل في الفقرات السابقة، يخدم مجال التفسير الذي نحن بصدد الاشتغال عليه حاليا؛ نسقية ترتيب الفقرات فرضه التسلسل المنطقي بشكل سلس وعفوي، يتوفر ذلك حين يكون الحس المنهجي على درجة عالية جدا.
بقدر ما يكون، الباحث في القرآن، مزودا بأصول التفسير وقواعده بقدر ما يكون عطاؤه جيدا وذا جدوى نافعا، والعكس كذلك صحيح؛ بقدر ما يكون الباحث مفتقرا لبعض الأصول والقواعد بقدر ما تكون مبادرته متواضعة.
“الحكم على الشيء فرع عن تصوره”؛ كما هو معلوم عند المناطقة. بل حتى في بعض الحكم لدى العرب: “كل إناء بما فيه ينضح”، ومما يجلب التوفيق، بعد التزود بأصول التفسير وقواعده، الدعاء الصادق وحسن القصد، ودقة التدبر والتأمل في بواطن القرآن وظاهره.
أقصد بعنوان الفقرة “كتب التفسير” ما تم إنجازه في القرون الخمسة الهجرية الثانية، أي بدءا من القرن السادس انتهاء بالقرن العاشر.
أهل التفسير لتلك المرحلة التاريخية ليسوا سواء من حيث المنهج المعتمد ونوع التفسير المرغوب فيه؛ فالمناهج مختلفة، والميولات متنوعة، مرد ذلك إلى عوامل ذاتية وعوامل موضوعية، من ضمنها التوجهات العقدية والطائفية والمذهبية والأيديولوجية، بالإضافة إلى اختلاف مستوى الذكاء والنباهة والعبقرية وقابلية الإبداع والتجديد والابتكار.
ترتب عن ذلك في تلك المرحلة التاريخية تحديدا؛ تفاسير متنوعة كلها تندرج ضمن ثلاثة أصول:
– تفسير بالمأثور
– تفسير بالرأي
– تفسير بالحدس.
النوع الأول؛ هو السائد في تلك المرحلة التاريخية اقتداء بالمتقدمين الذين لهم فضل السبق والتأسيس وعلى رأسهم ابن جرير الطبري وكل من ظهر في القرون الخمسة الهجرية الأولى؛ الاعتماد على “التفسير بالمأثور”، في تلك المرحلة التأسيسة المبكرة من تاريخ المسلمين، أمر طبيعي كون أولئك الرواد كانوا قريبين من العهد النبوي حيث كان النقل هو المعتمد بناء على مبدأ “الكتاب والسنة” مقابل إقصاء مبدأ “الكتاب والسنة والرأي” وصية الرسول لمعاذ بن جبل.
يأتي في الرتبة الثانية من حيث الاعتماد والانتشار؛ “التفسير بالرأي”، أصحاب هذا النوع من التفسير قلة قليلة كون آرائهم صادمة وخارجة عن المألوف بحكم إعمال العقل وإطلاق العنان للتدبر والتأمل ورصد بواطن القرآن؛ ذلك ما يجلب الجديد، والجديد دوما صادم.
“التفسير بالحدس”؛ أقلهم تداولا وانتشارا، من ضمنه: التفسير الباطني، التفسير الإشاري، التفسير العرفاني، التفسير الفلسفي؛ لا يخلو من جديد مفيد، كما أنه لا يخلو من شطحات وتجاوزات؛ ينبغي التحفظ منها والتوقف، دون تبخيس وإقصاء وممارسة محاكم التفتيش والوصاية على الناس؛ ما تقدم ذكره يساهم في الحجر والمنع وتثبيط العزائم والإرادات اتجاه التجديد والابتكار والتنقيب والإبداع والغوص في بواطن القرآن.
هذا النوع الأخير من التفاسير رهين بالأكابر من المتصوفة والفلاسفة لا تخلو منهم طائفة؛ سنة، شيعة، معتزلة..، إلى غير ذلك من الطوائف.
هؤلاء مصيرهم الرفض من قبل أصحاب التفسير بالمأثور، وقد يصل الأمر إلى التحريم، وأحيانا؛ التكفير والعياذ بالله.
هذا ابن كثير من ضمن القرون الخمسة الهجرية الثانية يقول في مقدمة تفسيره حول التفسير بالرأي: ” فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام “!
نجد الموقف نفسه لدى جميع أصحاب التفسير بالمأثور، مرد ذلك إلى تشبتهم بالنقل مقابل معارضتهم للعقل بحكم عدم انفتاحهم على ما عند الصوفية والفلاسفة من تأملات وإشراقات وقيمة مضافة للتراث الإنساني بشكل عام، والتراث الإسلامي على وجه الخصوص.
مما يندرج ضمن الأصول الثلاثة في مجال التفسير: تفسير فقهي، تفسير لغوي، تفسير إجمالي، تفسير تحليلي، تفسير باطني، تفسير فلسفي، تفسير إشاري، تفسير عرفاني، وهذا مما ظهر في القرون الخمسة الهجرية الثانية، كان الغالب فيها التفسير بالمأثور.



