التصوّف المسيحيّ
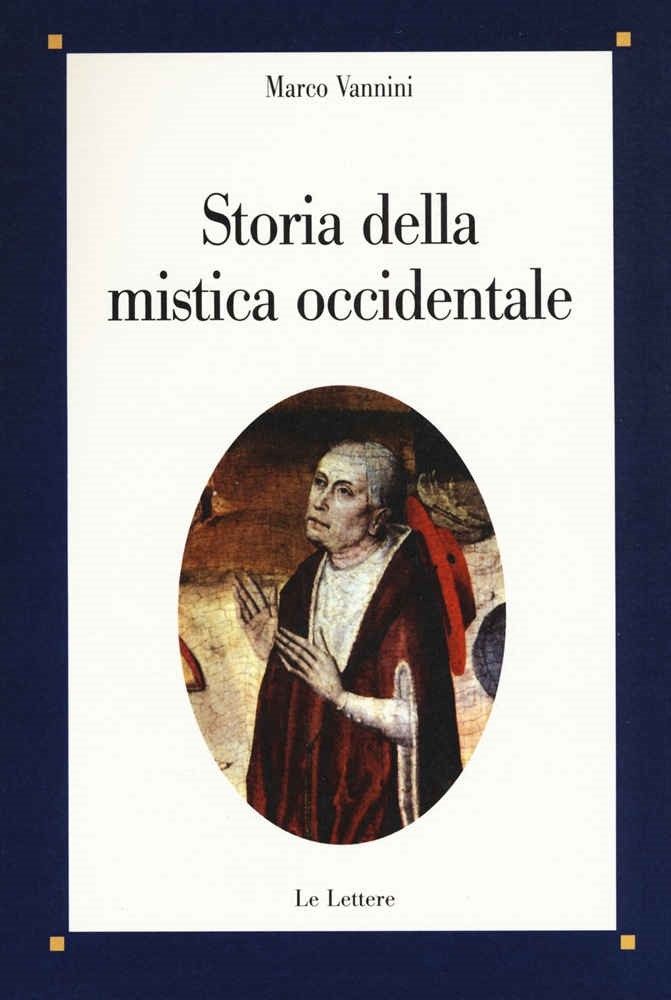
 عزالدين عناية ـ جامعي تونسي مقيم بإيطاليا
عزالدين عناية ـ جامعي تونسي مقيم بإيطاليا
تُعدّ الأعمال الصادرة باللغة الإيطالية حول تاريخ التصوف في الغرب قليلةً، وإن تعددت الأعمال التي تتطرق إلى شخصيات وتجارب روحية محددة. ومن هذا الباب يُعدّ كتاب الإيطالي ماركو فَنّيني (من مواليد 1948) المختص بالظواهر الروحية مرجعا لا غنى لدارسي ظاهرة التصوف في الغرب، بقصد الإحاطة بأهم منابعه ورواده وصولا إلى تطوراته في الفترتين الحديثة والمعاصرة. مؤلف الكتاب فَنّيني مترجم قديرٌ أيضا، سبق وأن نقل من اللاتينية والألمانية إلى الإيطالية كافة أعمال المعلم إيكهارت. ناهيك عن أعماله الصادرة في المجال مثل: “دين العقل” (2007)، “التصوف والفلسفة” (2007)، “التصوف في الأديان الكبرى” (2010)، “قاموس التصوف” (2013).
يقسّم فَنّيني كتابه المعني بتاريخ التصوف في الغرب، من الإرهاصات المبكرة في العهود القديمة حتى الراهن الحالي، إلى ثلاثة أقسام تأتي معنونة على النحو التالي: المنابع الإغريقية، المسيحية، والعالم المعاصر. ويصدّر الأقسام الثلاثة من الكتاب بمقدمة مطولة تتناول قضايا على صلة بالتصوف مثل: اللاهوت وعلم النفس والفلسفة. مبينا أمام تعدد معاني التصوف وتبدل مضامينه من حقبة إلى أخرى، أن مسار التاريخ فقط هو الكفيل بتحديد معاني مفردة “التصوف” ودلالاتها. فالكلمة في أصلها الإغريقي -mistica- والتي أتت صفة لا اسما، عادة ما أُلحقت بكلمة اللاهوت. وفي معناها في تلك اللغة هي علمٌ للربوبية وخطابٌ حولها، صامت، مغلق. ولكن ليس بالمعنى الباطني، ففي الأصل الإغريقي، الإفلاطوني والأرسطي، نشأت المفردة في مقابل الأساطير وفنطازيا الشعراء عن الآلهة. ويُعدّ في هذا الطور المتقدّم الذي يؤرخ له فَنّيني نصُّ أفلاطون “بارمنيدس” نصَّ التصوف بامتياز، لما حواه من إشارات روحية وذوقية. فالتصوف كما لاح في تلك المرحلة المتقدمة هو تجربة التوحد، بل لنقل تجربة الروح والتوحد في الروح، إنه قائم بالفعل على تلك الجدلية كما يقول فَنّيني. حيث يدرك الصوفي أن إرادته هي إرادة الله، وفكره يغدو فكر الله، وبالتالي أناه تصير أنا الله، ولكن ليس بمعنى “البانثييزم”، أي التوحد في الربوبية، وإلغاء الفصل بين الذات البشرية والذات الإلهية. لذلك غالبا ما جاءت لغة الصوفي متداخلة مثقلة بالتضارب، ولكنها في نهاية المطاف تغرق في الصمت، وهو ما لا يعني أنه لا يمكن الإفصاح عن تجربة الروح عبر منطوق اللغة.
مع ذلك يبقى التصوف كما يرى فَنّيني قناة أثيرة خاطب الرب بواسطتها، وبشكل رائع البشر، مانحا إياهم أحوالا تجلت في عطايا ومعارف وضروبا من الوحي الخارق. ولكن المسألة الدقيقة، والمهمة العسيرة، ضمن هذا المسار، تتلخص، وفق فَنّيني، في فرز التصوف الصادق من التصوف الزائف، في تجلّي الرب أو في تلبّسه بظواهر “طبيعية” أو شيطانية. وصحيح يتخلل التصوف الإيمان، لكن ليس بوصف التصوف اعتقادا بل معرفة للروح، ومعراجا، فهو دائما تجربة للمطلق في الحاضر، هنا في الواقع في عالم الشهادة. لذلك يعني التصوف بالأساس معرفة الذات، معرفة العمق الحقيقي للروح، وهو ما تلخص في ذلك القول المأثور “من عرف نفسه فقد عرف ربه”.
في القسم الأول من الكتاب، المعنون بـ”المنابع الإغريقية”، يتناول فَنّيني العالم الهيلنستي، منطلقا مما يوحي به التقارب الدلالي على مستوى اللغة بين كلمتي -mistica- و -mistero- (التصوف/الإبهام). مبينا أن التقارب بين الكلمتين على مستوى اللغة يغدو تباعدا على مستوى المضمون، وبالتالي لا ينبغي المكوث طويلا عند ظاهرة التشابه الإيتيمولوجي/الاشتقاقي على أمل بلوغ المعنى الأصلي للكلمة وطمعا في الإحاطة بفحوى التصوف. معتبرا ملحمة الإلياذة الإغريقية معينا أوليا للنظر الروحي والإيحاء بالقوة والملحمية. وإن يشاطر ماركو فَنّيني الباحثة سيمون فايل في الإقرار بأن الإلياذة تحوي عمقا صوفيا وخيطا روحيا رقيقا، فإنه لا يزعم أننا مع الإلياذة في حضور تجربة للتصوف بمعناها الراقي (وحدة الروح)، لكن هناك سائر العناصر الممهدة لذلك والأرضية المناسبة للحديث عن التجربة الروحية. ففي النص الشعري الملحمي، وبعيدا عن المباشر التعددي لمختلف الآلهة واللغة التجسيمية والتشبيهية الطاغية، ثمة تطلّعٌ لأفق سامٍ في الجمال وفي الربوبية بوصفها ضرورة مطلقة، أو لنقل إلى ألوهية غير مشخصنة. مع وعي في الإلياذة بالوحدة الجامعة للكلّ، ينكشف من خلالها حجاب الضرورة الإلهية. ودائما ضمن ملاحقة منابع التصوف في أصول الفكر الإغريقي نلحظ كيف يجد إيكهارت في هيراقليطس (نهاية القرن السادس ق.م/بداية القرن الخامس ق.م)، المعلّم للحقيقة قبل أن تظهر في الإيمان المسيحي. قولته الشهيرة تبدو آسرة لإيكهارت: “مصغيا إلى اللوغوس وليس إلى ذاتي، من الصواب الإقرار بأن كل شيء واحد”.
لكن أصول التصوف، كما يتبين لفَنّيني، تبدأ في التبلور بشكل واضح مع الفلاسفة الكلاسيكيين، أساسا مع إفلاطون تلميذ الهيراقليطي كراتيلوس، أي قبل الانضمام إلى صفوف مدرسة سقراط. حيث نلاحظ في النص الإفلاطوني التعالي المطلق لله، وهو ما يطلق عليه “ثيوس”، حيث النعت بصيغة المفرد لا الجمع تنزيها له عن التعدد، والذي لا يمتزج بالفانين، مع إشارة في الأثناء إلى وحدة الكل، الإلهي والبشري. وفي “كتاب الجمهورية” تأكيد على أن الله هو خير مطلق، وهو دائما يتجاوز الكائن الزائل. وبالطبع، ليس إفلاطون وحده من يلوح في طريق فَنّيني، في بحثه لتأصيل التصوف الغربي، بل أرسطو أيضا. ففي “كتاب الميتافيزيقيا” تقتضي الضرورة تواجد كائن، لعِلّة غير معلولة يتماهى مع الخير، هو مبدأ لكل الموجودات. ويشمل فَنّيني بتأصيله للتصوف الغربي الإفلاطونيةَ المحدثة أيضا، والحقيقة أن التأمل الأفلوطيني، إضافة إلى المعلم إفلاطون، يولي اهتماما أيضا للضرورات الروحية لعصره، حيث تتداخل أنواع شتى من الاعتقادات الدينية في زمن مأزوم ومهووس بالبحث عن “الخلاص” المتمثل في “الأحد” أو ما نطلق عليه بلغة عصرنا المطلق. فمع أفلوطين ثمة بحثٌ عن التوحد عبر الوجد ومن خلاله مع الواحد الصمد. فهو فوق الكل وبما يتجاوز الجميع، ليس له أية خاصية أنثروبومورفية، والذي يمكن تعيينه بـالعدم و اللاّشيء أيضا. ليس بوصفه ليس موجودا، بل بصفته يتعالى عن أي تمثيل أو احتواء أو أي شكل من أشكال الوجود. كما يتابع فَنّيني بحثه عن بواكير التصوف بالغرب مع برقلس وفرفريوس الصوري (ت. 305).
في القسم الثاني من الكتاب، المعنون بـ”المسيحية”، يستهلّ فَنّيني حديثه بحديث البدايات عن التصوف المسيحي. حيث يتطرّق إلى ضرورة التمييز بين “الدلالات الدينية” و”الدلالات الصوفية” في الكتاب المقدّس، فليس كل ما هو ديني هو بالضرورة صوفي. مستعرضا شخص المسيح (ع) قولا وعملا، بوصفه تجربة حية للتصوف وللصوفي، مارا بالتحول الذي أحدثه بولس من خلال إلحاحه على أسطورة الخلاص التي يمثلها المسيح، أو بالأحرى تقليده بوصفه تجربة في التحول الروحي، حيث انتهاء الإنسان الجسد وحلول الإنسان الروح. وهو ما لخصه في قولة تُعدّ جوهرية في التصوف المسيحي “وأما من التصق بالرب فهو روح واحد” (الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس6: 17). ذلك أن التحوير الذي أدخله بولس في النظر إلى شخص المسيح يعد محوريا وجذريا في المسيحية، ليس على المستوى الروحي فحسب، بل على المستوى العقدي واللاهوتي خصوصا.
ثم يستعرض فَنّيني التحولات التي طبعت مفهوم التصوف مع آباء الكنيسة، مع أوريجنس وغريغوريوس النيصيّ وديونوسيوس الأريوباجي وأوغسطين وغريغوريوس مانيو. ليصل بنا إلى العصر الحديث والتطورات الصوفية الأخيرة في الغرب. يتطرق فَنّيني تحت عنوان “الإصلاح المضاد” إلى جملة من الرموز الصوفية لتلك الفترة فضلا عن جملة من تجمعات الرهبنة المسيحية، غاضا الطرف عن “الإصلاحيين” أي البروتستانت. فالفترة شهدت بروز أهم تشكيلات الرهبنة الكاثوليكية، بدءا من التصوف النُّسكي اليسوعي مع القديس إغناطيوس دي لُويُولا (ت. 1556). هذا الصوفي الناشئ من رحم المعاناة من “الموري” الأندلسي، يلتهب لديه الحماس النضالي لدحر الموريسكيين والحماس الروحي لنشر دينه على حد سواء. لكن التطور الروحي لليسوعيين وللتصوف اليسوعي، تحديدا في إسبانيا، يتغاضى فيه فَنّيني عن أصوله الإسلامية وعن تأثره بالتجارب الإسلامية، دون إشارة إلى ذلك، في زمن كان فيه التصوف في المسيحية الكاثوليكية هرطقة في الدين، باعتباره بدعة منكرة، طورد رواده ولقوا صدّا من الكنيسة.
عقب ذلك يتناول فَنّيني بالحديث التصوف الكرملي مع تيريزا الآفيلية الناشئة في إسبانيا، والغريب أن فَنّيني مع كل ذلك لا يدفعه الأمر إلى إزاحة النظر نحو التجارب الروحية عند الموريسكيين. إذ يروى أن تيريزا الآفيلية في شبابها كانت تود الفرار نحو أرض الموريسكيين. يحدوها شوق عبرت عنه في قولتها الشهيرة “الوجْد قضاءٌ لا مردّ له، تُنتزع فيه الروح من الثرى بيدِ الله كما تختطِف الكواسر طريدتها دون أن تدري إلى أين المساق. وبالتالي لا بد من رباطة جأش لمتابعة المسار، إذ غالبا ما حاولتُ دفع الوجْد، مقدّرةً أنه وهْم، ولكني وجدتُ نفسي صريعة كأني أغالب ماردا”. تلا ذلك حديث عن شخصية صوفية أخرى مهمة يوحنا الصليب المعروف بإقراره أن الله تعالى أبعد من أن يدركه إدراك أو يشعر به شعور أو تتخيله مخيلة، ولا يمكن معرفته مباشرة إلاّ بالحب الخالص.
في القسم الثالث من الكتاب، المعنون بـ”العالم المعاصر”، يستعرض فَنّيني مقولات جوردانو برونو في التصوف ورؤيته الروحية للعالم، ثم ينتقل إلى باروخ سبينوزا، الذي برغم خطه العقلاني فإن الأخلاق لديه مؤدّاها إلى الله. وتحت معنون لاحق ضمن هذا القسم يتناول فَنّيني حقبة “ما بعد التنوير” وخطاباتها ذات النزعة الصوفية، وهو ما يتجلى في المثالية مع فيخته وشيلنغ وهيغل وشوبنهاور ونيتشه. ليخلص إلى الحديث عن “عصرنا الراهن”، وإن كان التصوف الراهن وفق منظوره يغيب عنه المركز، أو بالأحرى يفتقر إلى المرجع المركزي، فنحن نعيش وفق توصيف عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر في “معبد تعددي” يختار فيه كلّ معبوده، أي قِيمه، حيث نشهد زحف التقاليد الشرقية على الغرب، أو بتلطيف العبارة اختراقها للحصانة الروحية للغرب. في خضم ذلك يرحل فَنّيني مع الإلماعات الصوفية لفتغنشتاين، الذي بيّن أن العلم الحديث والتقنية والثقافة الوضعية تبقى جميعها فقيرة ومنقوصة، حتى وإن كان الدين التقليدي غير قادر على توفير إجابة شافية وملائمة في الغرض، فالذكاء وحده يجد الطريق في ما يطلق عليه (das Mystische). إذ التصوف بالنسبة إلى فتغنشتاين هو حدس جمالي للعالم، يتوارى فيه الموضوع المفكر فيه والمتخيل كوهم باطل.
من جانب آخر يتطرق فَنّيني إلى سيمون فايل (1909-1943)، من أصول يهودية، التي تتحدث عن الاغتراب عن الخير، عن الله، وهو ما يتجلى في جل مظاهر التقنية. ففي مسارها التأملي في التجارب الروحية في الكتاب المقدس تذهب فايل إلى أن الإله العبري هو إله طبيعي في حين الإله المسيحي هو ما فوق طبيعي.
يتطرق مؤلف الكتاب كذلك إلى تجربة إيتي هيليسوم (1914-1943)، وهي كاتبة من أصول عبرية هولندية لكنها لا تنتمي لأي دين، بل بالأحرى ترفض اليهودية والمسيحية بوصفهما نسقين دينيين مغلقين. لكن تبقى هيليسوم تفتقر إلى نظرة منهجية لما يطبع رؤيتها من تناثر. ليختتم الكتاب جولته بالحديث عن رموز التصوف في الزمن المعاصر مثل الأم تيريزا، المطوَّبة أخيرا من قِبل البابا فرانسيس برغوليو، جزاء لما دشنته من اختراقات للكنيسة في العالم، والتي تجاوَز فعل الخير لديها، وفق فَنّيني، حدود المسيحية. معتبرا مؤلِّف الكتاب أن “التوحد مع الروح” هو عين الاتحاد مع الحياة، وهو حركة الروح المتسقة مع “الحب الذي يحرك الشمس وسائر الكواكب” كما وصف دانتي الأمر في “الكوميديا الإلهية” (الجنة: XXXIII). فالصوفي وهو يتأمل سرّ الألوهية، ينخطف منجذبا إلى صورته الذاتية، إلى الوجه الإنساني، الماكث في قلب الدائرة المشعة نورا.
الكتاب حوصلة تاريخية لتجربة من تجارب تمظهرات الدين في الغرب كما تجلت في التصوف. لم يخل فيها من بعض النقائص رغم الطابع الأكاديمي الذي نحاه مؤلفه من حيث التوثيق والإحالات، حيث يسقط صاحبه، متعمدا ولا نظنه سهوا، بعض المحاور عند التطرق لموضوع بحجم التصوف الغربي، ونقصد التواصل مع التصوف الشرقي عامة والإسلامي والهندي خاصة، فضلا عن عدم إيلائه اهتماما التصوف البروتستانتي مع أن نظيره الكاثوليكي كان حاضرا، لا سيما في فترتي “الإصلاح” و”الإصلاح المضاد”.
الكتاب: تاريخ التصوف الغربي.
تأليف: ماركو فَنّيني.
الناشر: لي ليتِّري (فورانسا-إيطاليا) ‘باللغة الإيطالية’.
سنة النشر: 2020.
عدد الصفحات: 467ص.



