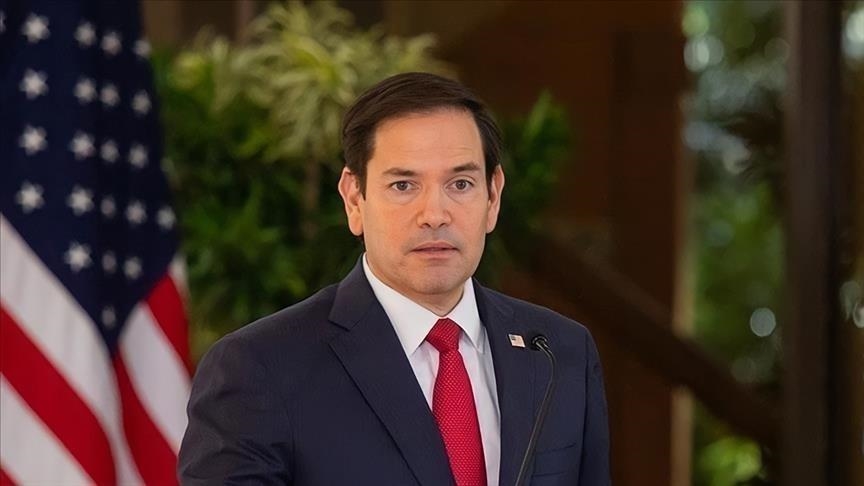إمارة المؤمنين بين الشرعية التاريخية والحكمة المقاصدية: قراءة في فقه الاستمرار والتجدد

د. حمزة مولخنيف
يُعدّ مفهوم إمارة المؤمنين من أكثر المفاهيم السياسية-الفقهية رسوخا في التجربة الإسلامية المغربية، وأكثرها قدرة على الجمع بين مقتضيات الشرع وروح التاريخ، وبين منطق النص وسنن الاجتماع البشري. فهو ليس مجرد صيغة حكم أو لقب سيادي، بل بنية مركّبة تشكّلت عبر قرون من التفاعل العميق بين الفقه والواقع وبين السلطة والمعنى، وبين الديني والسياسي في أفق تكاملي لا تصادمي.
لذلك فإن الحديث عن فقه إمارة المؤمنين يقتضي تجاوز النظرة الاختزالية التي تحصره في بعد قانوني أو طقوسي، إلى أفق أرحب يستوعب الامتداد التاريخي والتطور المفهومي والوظيفة المقاصدية، والدور الحضاري الذي اضطلعت به هذه المؤسسة في حفظ وحدة الجماعة وصيانة الدين وتحقيق الاستقرار، وترشيد السلطة.
منذ اللحظة الأولى التي استقر فيها الإسلام بالمغرب، لم يكن سؤال السلطة سؤال غلبة محضة ولا سؤال تنظير مجرد، بل كان سؤال تنزيل وحكمة، وسؤال مواءمة بين المبدأ والواقع. ولذلك وجد المغاربة مبكرا في نموذج إمارة المؤمنين إطارا جامعا يُمكّن من استيعاب الخصوصيات المحلية دون التفريط في الكليات الشرعية.
وقد أدرك فقهاؤنا في المغرب كما يشهد بذلك تراثهم الغزير، أن الإمامة ليست مقصدا في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق مقاصد أسمى، في مقدمتها حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وهي المقاصد التي عبّر عنها الإمام الشاطبي بقوله المشهور: «إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا».
لقد تميّزت إمارة المؤمنين في السياق المغربي بكونها مؤسسة ذات جذور علمية وروحية، لا مجرد سلطة سياسية. فالبيعة التي هي الأساس الشرعي لهذه الإمارة، لم تُفهم يوما باعتبارها عقدا مفروضا من طرف واحد، ، بل باعتبارها عقد التزام متبادل، ينهض على الرضا والاختيار، ويؤطره الشرع وتزكيه الأخلاق.
وقد عبّر ابن خلدون عن هذا المعنى حين قرر أن «البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره».
هذا الفهم العميق للبيعة هو ما جعل إمارة المؤمنين في المغرب قادرة على الاستمرار التاريخي، لا باعتبارها شكلا جامدا، بل باعتبارها صيغة مرنة قابلة للتطور، تستوعب التحولات دون أن تفقد جوهرها. ومن هنا نفهم لماذا ظلّ هذا المفهوم حاضرا بقوة في الوجدان المغربي، ومحلّ إجماع علمي وفقهي عبر العصور، من عهد الأدارسة إلى الدولة العلوية، مرورا بالمرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسيين والسعديين، حيث ظلّ الرابط الديني-السياسي عنصر توحيد لا عنصر تفريق.
ويكفي أن نستحضر شهادة عدد من المؤرخين والفقهاء في هذا الباب، لنقف على مركزية إمارة المؤمنين في بناء الدولة المغربية. فالمؤرخ عبد الرحمن بن زيدان، في حديثه عن الدولة العلوية، يؤكد أن «قيام الملك في المغرب لم يكن يوما قائما على السيف وحده، وإنما على الشرعية الدينية التي تلتف حولها الأمة، وتجد فيها ضمانا لدينها وأمنها».
وهي شهادة تنسجم مع ما قرره محمد الحجوي الثعالبي حين اعتبر أن إمارة المؤمنين «هي السياج الحامي للشريعة، والضامن لوحدة الأمة، والمحقق لمقصد الاجتماع الذي لا قيام للدين بدونه».
ولعلّ من أبرز ما يميز فقه إمارة المؤمنين في التجربة المغربية هو هذا التوازن الدقيق بين السلطتين: سلطة النص وسلطة الواقع. فالفقهاء المغاربة على اختلاف مدارسهم ومشاربهم، لم يكونوا أسرى للحرفية الجامدة، ولا دعاة تسيّب باسم المصلحة، بل كانوا في الغالب فقهاء تنزيل، يدركون أن النصوص إنما جاءت لهداية الواقع لا لمصادمته، وأن المقاصد هي روح الأحكام. وقد عبّر الإمام القرافي عن هذا المنهج بقوله: «الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين».
في هذا السياق، تبلورت إمارة المؤمنين بوصفها إطارا مرنا يسمح باستيعاب التنوع المذهبي والعرقي والثقافي، دون أن يهدد وحدة المرجعية. فالمغرب وهو بلد تعدد وتنوع، وجد في هذه المؤسسة صمام أمان يحفظ التعدد داخل الوحدة، ويؤطر الاختلاف ضمن الشرعية.
وقد نبّه غير واحد من المفكرين المعاصرين إلى هذه الخصوصية، ومنهم محمد عابد الجابري الذي رأى أن إمارة المؤمنين «ليست مجرد مؤسسة سياسية، بل هي تعبير عن تعاقد تاريخي-ثقافي بين السلطة والمجتمع، قوامه المرجعية الدينية المشتركة».
ولا يمكن فهم تطور فقه إمارة المؤمنين دون التوقف عند الدور المحوري الذي لعبه العلماء في تأصيلها وحمايتها وترشيدها. فالعلماء في المغرب لم يكونوا في الغالب مجرد وعّاظ سلاطين، ولا معارضين عدميين، بل كانوا فاعلين في الحقل العمومي، يوجهون وينصحون ويقومون الاعوجاج متى اقتضى الأمر.
ويكفي أن نتذكر مواقف علماء كبار، كأبي عمران الفاسي وابن رشد الجد وأبي العباس الونشريسي الذين أسهموا بفقههم ونوازلهم في ضبط العلاقة بين السلطة والشرع، وبين الإمام والرعية.
وقد عبّر أبو العباس الونشريسي في «المعيار» عن هذا الدور حين أكد أن «وظيفة العلماء ليست في تبرير كل فعل للسلطان، ولا في الخروج عليه لأدنى شبهة، وإنما في بيان الحكم وإقامة الميزان وتحقيق العدل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا». وهذا التصور هو ما منح إمارة المؤمنين بعدها الأخلاقي وجعلها، في كثير من اللحظات التاريخية أداة استقرار لا أداة استبداد.
إن فقه إمارة المؤمنين ليس فقه طاعة عمياء، ولا فقه معارضة فوضوية بل فقه وسط يستلهم مقاصد الشريعة، ويستحضر سنن العمران ويوازن بين درء المفاسد وجلب المصالح. وقد لخّص الإمام ابن تيمية هذا المنطق بقوله الشهير: «إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة». وهو قول كثيرا ما استحضره فقهاء السياسة الشرعية للتأكيد على أن العدل هو روح الإمامة وغايتها.
ومن هنا نفهم لماذا ظلّ مفهوم إمارة المؤمنين في المغرب مرتبطا في الوعي الجمعي بالأمن الديني والاستقرار السياسي، لا بالقهر والتغلب. فهذه المؤسسة حين كانت قوية بشرعيتها وعدلها، كانت قادرة على احتواء الأزمات وحماية البلاد من الفتن وصون الهوية الدينية من الاختراق.
وقد لاحظ عدد من المستشرقين المنصفين هذه الخصوصية، ومنهم جاك بيرك الذي اعتبر أن «المغرب طوّر نموذجا فريدا في العلاقة بين الدين والسياسة، يقوم على الاستمرارية الرمزية والمرونة العملية».
ولا نهدف في مقالنا هذا إلى استقصاء جميع أبعاد فقه إمارة المؤمنين، بقدر ما نروم وضع إطار نظري وتاريخي وجيز يساعد على فهم نشأتها ومسار تطورها، بوصفها مؤسسة حيّة تشكّلت في سياق تاريخي خاص، وتغذّت من المرجعية الفقهية، وتفاعلت مع التحولات السياسية والاجتماعية، دون أن تفقد جوهرها القائم على الشرعية والبيعة واستحضار المقاصد.
ولقد شكّلت كتب السياسة الشرعية منذ القرن الثالث الهجري، الإطار النظري الأوسع الذي تبلورت داخله مفاهيم الإمامة والخلافة والسلطة. ويكاد يجمع فقهاء هذا الباب على اختلاف مذاهبهم، على أن الإمامة العظمى من فروض الكفايات التي لا يستقيم أمر الدين والدنيا بدونها.
فقد قرر الإمام الماوردي في “الأحكام السلطانية” أن «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا»، وهو تعريف مكثف يجمع بين البعدين الديني والسياسي دون فصل أو تغليب. ويؤكد الجويني في “غياث الأمم” المعنى ذاته حين يقول إن «نصب الإمام واجب بالإجماع، إذ لا بد للأمة من رأس يجمع شتاتها، ويقيم حدودها، ويدفع عنها العدوان».
غير أن اللافت في هذا التراث ليس مجرد تقرير الوجوب، بل المرونة الكبيرة في تحديد الشروط والصيغ، بما يعكس وعي الفقهاء بتغيّر الأحوال وتبدّل السياقات. فشرط النسب القرشي، مثلا، الذي شدّد عليه بعض المتقدمين لم يُفهم دائما على أنه شرط تعبدي صارم، بل خضع لتأويلات مقاصدية عند عدد من العلماء، خاصة حين تعذّر تحققه أو أدى إلى مفاسد أعظم.
وقد أشار ابن خلدون إلى هذا التحول بوضوح حين اعتبر أن «اشتراط النسب إنما كان مراعاة للعصبية في زمنها، فلما ذهبت العصبية وصارت الملكيات قائمة بغيرها، سقط اعتبار ذلك الشرط».
ويمكن فهم إمارة المؤمنين في المغرب بوصفها تنزيلا خاصا لمفهوم الإمامة، لا خروجا عنه. فهي لم تدّعِ يوما استنساخ نموذج الخلافة المشرقية في صورته التاريخية، ولا ادّعت العصمة أو الكمال، بل قدّمت نفسها باعتبارها إمامة شرعية قوامها البيعة، ووظيفتها حفظ الدين وسياسة الدنيا وفق ما تسمح به الأحوال.
وقد استوعب فقهاء المغرب هذا المعنى مبكرا، فركّزوا على جوهر الإمامة لا على شكلها، وعلى مقاصدها لا على تفاصيلها الظرفية.
ويتجلّى هذا بوضوح في فقه النوازل المغربية، حيث نجد حضورا قويا لفكرة الإمام الجامع، الذي تُناط به وظيفة التحكيم بين المصالح ورفع التنازع ومنع الفتنة. فالونشريسي، مثلا، وهو من أدق من كتب في النوازل، يتعامل مع وجود الإمام باعتباره شرطا لاستقامة الأحكام، وضمانا لوحدة القضاء، وسدا لباب التلاعب بالدين. ويصرّح في أكثر من موضع بأن «تعدد الأيدي في الحكم مفسدة محققة، وأن اجتماع الكلمة على إمام واحد أصل من أصول السياسة الشرعية».
ومع دخول المغرب العصر الحديث، واحتكاكه العميق بالقوى الاستعمارية وبالنماذج السياسية الغربية، لم تتراجع إمارة المؤمنين بل أعادت تموضعها، وانتقلت من صيغة تقليدية إلى صيغة أكثر تركيبا، دون أن تتخلى عن مرجعيتها الدينية.
فقد مثّل الاستعمار في نظر كثير من العلماء والمفكرين، تهديدا مباشرا للسيادة الدينية قبل أن يكون تهديدا للسيادة السياسية. ومن هنا برز دور السلطان بصفته أميرا للمؤمنين، رمزا للمقاومة والحفاظ على الهوية، حتى في أحلك لحظات الضعف.
وقد سجّل المؤرخون أن مؤسسة البيعة لم تنقطع حتى في زمن الحماية، وأن الشرعية الدينية للسلطان ظلت حاضرة في الوعي الجماعي، تشكّل رصيدا رمزيا ساهم لاحقا في استعادة الاستقلال. ويشير عبد الله العروي في تحليله للدولة المغربية الحديثة، إلى أن «الملكية المغربية استطاعت أن تحافظ على استمرارية تاريخية نادرة، لأنها لم تقطع مع ماضيها الرمزي، بل أعادت تأويله في ضوء الحداثة».
ومع بناء الدولة الوطنية دخلت إمارة المؤمنين مرحلة جديدة، لم تعد فيها مجرد مؤسسة تقليدية، بل أصبحت جزءا من نظام دستوري حديث، يحدد الاختصاصات وينظم السلط ويؤطر العلاقة بين الديني والسياسي. غير أن هذا الإدماج لم يكن إدماجا شكليا، بل حافظ على جوهر الوظيفة الدينية، خاصة في مجال حماية الملة والدين، والإشراف على الحقل الديني، وضمان وحدة المرجعية. وقد عبّر عدد من المفكرين عن هذه الخصوصية باعتبارها نموذجا للتحديث من الداخل، لا القطع الجذري مع التراث.
ويبرز البعد المقاصدي لإمارة المؤمنين بشكل أوضح في دورها المتنامي في تحقيق الأمن الديني. فالأمن الديني في هذا السياق لا يعني القمع ولا الوصاية على الضمائر، بل يعني توفير إطار مؤسسي يحمي التدين من الفوضى، ويصون العقيدة من الغلو والانحراف، ويضمن ممارسة الشعائر في طمأنينة. وقد أدرك علماء المقاصد منذ وقت مبكر أن حفظ الدين لا يتحقق فقط بالعقوبات أو الشعارات، بل بتحقيق شروط الاستقرار ونشر العلم وضبط الفتوى.
وفي هذا الباب، تبدو إمارة المؤمنين امتدادا عمليا لما قرره الشاطبي حين قال إن «التكليف إنما جاء لإخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا». فوجود إمام جامع يُرجع إليه في القضايا الكبرى، ويؤطر المجال الديني، يساهم في تقليص منازع التسييس، ويمنع احتكار الدين من قبل جماعات أو أفراد. وهذا ما جعل التجربة المغربية في نظر كثير من الدارسين والباحثين، أقل عرضة للاهتزازات العقدية الحادة التي عرفتها مجتمعات أخرى.
ولا يخفى أن البعد الروحي لإمارة المؤمنين شكّل عبر التاريخ، عنصرا أساسيا في قبولها الاجتماعي. فالسلطان في المخيال المغربي لم يكن مجرد حاكم، بل كان أيضا راعيا للعلماء وحاميا للزوايا ومُشرفا على الشأن الديني. وقد لعب التصوف السني المتجذر في المجتمع المغربي دورا مهما في ترسيخ هذه الصورة، حيث التقت الزعامة الروحية بالشرعية السياسية في كثير من اللحظات، دون أن يذوب أحدهما في الآخر. ويشير جاك بيرك إلى أن «الملكية المغربية نجحت في استيعاب البعد الصوفي دون أن تتحول إلى سلطة ثيوقراطية».
وعند مقارنة إمارة المؤمنين بنماذج إسلامية أخرى، يتبيّن أن خصوصيتها لا تكمن في ادعاء التفرد المطلق، بل في قدرتها على التكيف. فالنموذج العثماني، مثلا، قام على فكرة الخلافة الجامعة ذات الامتداد الإمبراطوري، لكنه واجه صعوبات كبرى في استيعاب التعدد القومي والديني.
أما النموذج الصفوي، فقد انبنى على مذهب رسمي مغلق، أدى إلى توترات مذهبية عميقة. وفي المقابل، نجد أن النموذج المغربي بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه، اختار طريقا أقل صدامية، قائما على التدرج، والتسامح المذهبي، وتقديم وحدة الجماعة على الصراعات العقائدية.
ولا يعني هذا أن التجربة المغربية كانت خالية من الإشكالات أو التوترات، لكنها تميزت بقدرتها على تصحيح مسارها من الداخل عبر آليات علمية واجتماعية، دون الحاجة إلى قطيعات جذرية. وقد لاحظ عدد من المفكرين المعاصرين أن هذا النمط من الاستمرارية الإصلاحية هو ما منح إمارة المؤمنين قدرة على الصمود في زمن التحولات العاصفة.
وتتأكد هذه الخلاصة حين ننظر إلى واقع العالم الإسلامي اليوم، حيث تتنازع الشرعيات، وتتناسل التأويلات المتطرفة، ويغيب في كثير من الأحيان الإطار الجامع. في هذا السياق، تبدو إمارة المؤمنين في صيغتها المغربية، تجربة جديرة بالتأمل لا بوصفها نموذجا يُفرض أو يُعمم، بل باعتبارها درسا في فقه الواقع، وفي كيفية تكييف المفاهيم الكبرى مع الخصوصيات التاريخية.
إن فقه إمارة المؤمنين ليس فقها ماضويا ولا خطابا تبريريا للسلطة، بل هو اجتهاد تاريخي مفتوح، تشكّل عبر قرون من التفاعل بين النص والمصلحة، وبين الثابت والمتغير. وهو فقه يذكّرنا بأن السياسة الشرعية ليست علما تجريديا، بل ممارسة أخلاقية، غايتها حفظ الجماعة وصيانة الدين وتحقيق العدل بقدر المستطاع.
لقد استطاعت إمارة المؤمنين في المغرب أن تحافظ على خيط ناظم بين الماضي والحاضر، وأن تؤسس لاستمرارية نادرة في العالم الإسلامي لا تقوم على الجمود، بل على التجدد المنضبط. وهذا ما يجعلها تجربة ذات دلالة عميقة، لا تختزل في لقب أو مؤسسة، بل تُفهم باعتبارها تعبيرا عن حكمة تاريخية، وعن فقه جماعي أدرك أن الاجتماع رحمة، وأن الفرقة مفسدة، وأن الدين لا يُحمى إلا بالعلم والعدل والاعتدال.