إشارات في قراءة السيرة النبوية: فراس السواح نموذجا
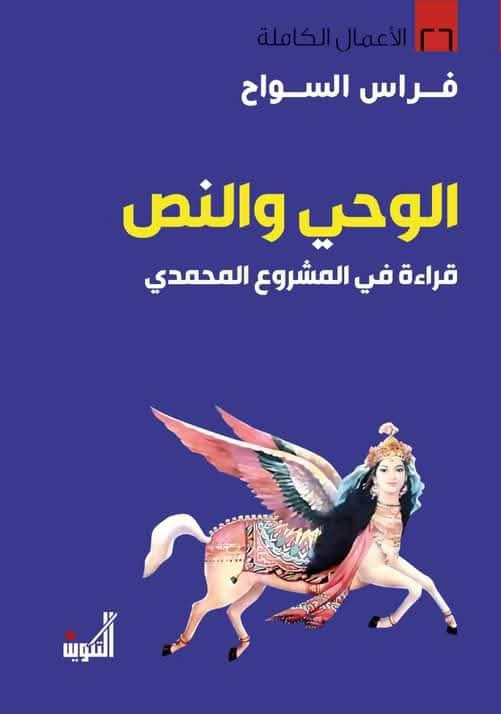
محمد زاوي
غاية فراس السواح في كتابه الجديد “الوحي والنص: قراءة في المشروع المحمدي” فك التناقض بين “محمد القرآن” و”محمد السيرة”؛ يحتج على “تراث السيرة” بغياب تفاصيله في القرآن (من قبيل: الهجرة إلى الحبشة/ الهجرة إلى المدينة/ الفتح/ الخ)، ويرى أنه يناقض في بعض حيثياته أخلاق محمد ورحمته وسعة وجدانه (من قبيل: أمره بحرق يهود بني قريظة).. من خلال هذا العمل، يدعو فراس السواح إلى كتابة سيرة منطقية مخلّصة مما أدرج فيها من أحداث فرضتها مصالح وأغراض المدونين أو من يشرف عليهم.
لا نصادر حق فراس السواح في عمله البحثي والتأملي، لكننا نضع بين يديه جملة إشارات لعلها غابت عنه أو أغفلها، أو لعلها لا تدخل في منهجه النظري:
-أولا: هناك اختلاف بين القرآن والسيرة/ السنة، كما هناك اختلاف بين السيرة والسنة؛ ويشمل هذا الاختلاف الشكل والمضمون معا. القرآن وحي يلقى في صدر النبي، فيتبدى أول الأمر بلغة القوم وثقافتهم وما به يعون أغراضه وغاياته، قبل أن تستوعبه السنة ضمن منطقها التاريخي وغير التاريخي الخاص، وقبل أن يبلغ مداه في تغيرات الزمن والمكان التي روتها السيرة. لا نتحدث هنا عن صحة الموجود بين أيدينا من عدمه، وإنما حديثنا عن الفوارق المنهجية بين القرآن والسنة والسيرة، وهي الفوارق التي تجيز لنا مساءلة فراس السواح: كيف يطلب من خطاب توجيهي وحياني التأريخ للفعل النبوي في الزمن؟ يختص القرآن ببعض هذا المعنى، لا على سبيل اختصاص التأريخ، وإنما على سبيل التوجيه المتزامن مع تعاقب الأحداث..
-ثانيا: وجدان النبي محمد لم يمنعه من خوض غمار التاريخ، ولو منعه لما احتاج إلى دعوة في مكة، ولا إلى هجرة إلى المدينة، ولا إلى سرية أو غزو، ولا إلى فتح أو تنظيم. الذي اعتكف بحراء هو نفسه الذي غزا ببدر، والذي غضب لـ”دابة وُسِم وجهها” هو نفسه الذي جهز السرايا والغزوات وفرض استقرار المدينة وأمنها بالرحمة والقسوة، بالسلم والعنف. إنه اختيار نبوي، اصطفاء قدري، أهل النبي للانتقال بين رحابة الوجدان وضيق التاريخ، فكانت النبوة وكانت الدولة. ما يراه سواح تناقضا ليس كذلك، وإنما هو روح “المشروع المحمدي” كما يسميه. إن هذا الجدل النبوي، بين خلوة وغزوة، هو وقود القرآن والسيرة والسنة، وهو المحرك البدئي للتاريخ الإسلامي. وإذا كان السواح يرفض “عنف السيرة” فما موقفه من “عنف القرآن؟! وإذا كان مغرما بـ”نبي مكة/ الوجدان” فكيف له أن يقبل “نبي المدينة/ التاريخ” ضمن هذا التعلق الوجداني؟!
-ثالثا: مجال المعرفة أكثر اتساعا من مجال العلم، وهذا أكثر اتساعا من مجال الإيديولوجيا.. ولذلك فإن منهج العلم الحديث لا يقبل التمييز بين “وثيقة” و”أخرى” بمنطق إيديلوجي لا يخرج عن إطارين: إيديولوجيا نفسانية يتم الترجيح فيها بين النصوص على أساس وجداني، أو إيديولوجيا “حداثوية” تشتغل بمنطق الأولويات في النقد والتفكيك.. يميل السواح إلى الترجيح على أساس وجداني، وهذا ليس عمل المؤرخ وإنما المؤول الخاضع لغرضين: نفسي أو إيديولوجي. كل الوثائق بالنسبة للمؤرخ شواهد قابلة للدراسة، لا تفاضل بينها إلا من حيث قربها أو بعدها من الحدث المؤرَّخ، من حيث ثبوتها من عدمه. يغيب التأريخ أو يضعف، فينتعش الوجدان ويكثر التأويل وفق أغراض نفسية أو إيديولوجية.. حظنا من “السيرة” قليل إلى حدود الساعة، ولكنه دال على الكيفية التي تجلى بها الأصل في تاريخنا “القديم”، كذا على الكيفية التي تجلى بها هذا التاريخ في حاضرنا “الكئيب”! البحث يجب أن ينكب حول إيجاد الأصل تحت طبقات من ركام الحاضر والتاريخ، وهذه مهمة المؤرخ؛ فأين المؤرخ؟!



