أسلمة المعرفة: العلم وفلسفته
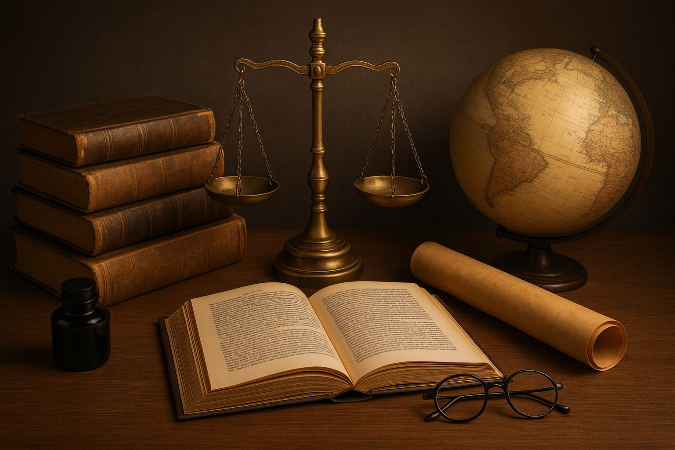
محمد زاوي
غاية مشروع “أسلمة المعرفة” “الفصل بين الإحالات الفلسفية والاكتشافات العلمية، ثم ربط هذه الاكتشافات بفلسفة الإسلام” (بتعبير أبي القاسم حاج حمد في “منهجية القرآن المعرفية”)، وقد اجتهد بعض رواد هذه المدرسة وحددوا المبادئ الفلسفية التي أضاعتها الفلسفة الغربية وحافظ عليها الإسلام.
ذلك ما عبر عنه عماد الدين خليل: ” تقدم الغرب في الوسائل وتخلفه في الغايات”. “إن الدين عند الله الإسلام” (سورة آل عمران، الآية 19)؛ ولما ظن العلم أنْ قد وجد ضالته في دين “الإلحاد وإنكار الغيب وتأليه الإنسان”، ولما كان رده على انحراف “المسيحية” (=الكنيسة الإقطاعية) ردّا منحرفا، فقد أصاب وجهة الكشف العلمي الوضعاني، وضلّ طريق السلامة (المادية والمعنوية) والسلام (في العلاقات بين الشعوب والأفراد).
إن أبرز نقد يوجّه لهذه المدرسة هو الذي وجهه أحد أبرز متأخري “مدرسة فرانكفورت”، يورغن هابرماس، والذي قال باستحالة الفصل بين “التقنية وفلسفتها”، فهي في نظره ذات فلسفة تبقى ملازمة لها مهما حاولت الفلسفات الأخرى تطويعها. إن التقنية بهذا المنظور ليست ولن تكون محايدة (نفس الأمر قال به مارتن هايدغر).
وإذا كان هذا النقد مطروحا بخصوص العلوم التقنية والبحتة، فإن إعماله في العلوم الإنسانية والاجتماعية -حيث يكون الإنسان جزءا من الموضوع- أولى. ولذلك تنتظم نتائج ونظريات الأولى (العلوم التقنية والبحتة) في قوانين، فيما تنتظم الثانية (العلوم الإنسانية والاجتماعية) في قواعد.
“الأسلمة” إذن، بالنسبة للعلوم التي أنتجها السياق الغربي، لا نقول مستحيلة، ولكنها عملية شاقة وتطلب مجهودا كبيرا، لا يعيد قراءة الإنجاز الغربي وحده، بل الإسلامي أيضا.
من عناصر مشروع “الأسلمة”، عند رواده أنفسهم (أمثال: إسماعيل راجي الفاروقي وأبي القاس حاج حمد وأحمد عبد الحميد أبي سليمان وعماد الدين خليل والسيد حسين نصر وطه جابر العلواني)، ربط العلوم والاكتشافات الغربية بنظيرتها الإسلامية (السابقة عليها).
يختلف الشرطان التاريخيان ولكن البناء العلمي الغربي (الحديث) لم يكن من فراغ ولا على “لا شيء” (محمد عابد الجابري في “المثقفون في الحضارة العربية”، وعلي شريعتي في “مسؤلية المثقف”؛ ناقشا بعض ملامح هذا الموضوع).
وإننا نجد في زاوية أخرى من النظر أن التقدم العلمي الحاصل اليوم يرافقه تخلف آخر أخلاقي وقيمي وفلسفي، بل واجتماعي. تتقدم قوى الانتاج، في شقها التقني والتكنولوجي أساسا، يرافقها بؤس فئات واسعة من سكان العالم، يعيشون الفقر الاجتماعي (إفقار مادي)، كما يستهدفون بإفقار آخر هو الإفقار المعنوي (الشذوذ والاستهلاك الفاحش والمخدرات والقمار، إلخ). تقدم في العلم والتقنية واكتشاف الخامات الطبيعية من جهة، واتساع هوة التفاوت الاجتماعي والمجالي من جهة أخرى؛ هكذا عبر المفكر السوفييتي إسحاق دويتشر.
هناك فرق بين “علم وعلموية” (“العلم والعلموية” فصل من كتاب “أفول الغرب” لمؤلفه حسن أوريد، يناقش فيه الفرق بين المفهومين/ مع دعوته إلى تعاقد جديد، “تعاقد وجودي” يكمل “التعاقد الاجتماعي”).
العلم ضروري لاستمرار حياة الإنسان و”تحسينها” (“تحسين الحياة”، تعبير لإلياس مرقص)، ولكنه بغير فلسفة تسدد منحاه -قد- بل يصبح على النقيض من الإنسان، يتحكم فيه ويهدم ما بناه، ليس من العلم في حد ذاته، بل من الفئة التي “تنفخ فيه روح” فلسفة لا إنسانية ولا أخلاقية ولا تقدمية (= لا إسلامية، لمن فهم الإسلام حقا)، من أجل توظيفه لصالحها (الربح وفائض القيمة، على حساب الإنسان).
تسعى “أسلمة المعرفة” إلى ربط العلم بفلسفته على وجه العموم، كما تسعى إلى المصالحة بين تقدم العلم وأصوله الإسلامية على وجه الخصوص. وبهذا الربط المزدوج تكتسب قدرتها التحريرية، وتلتزم سبيلها السديد وما يعنيه من تحرير للعلم من أهواء النفوس ومصالح الاحتكار. “قد أفلح من زكّاها” (سورة الشمس، الآية 9)/ “ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل” (سورة البقرة، الآية 188).



