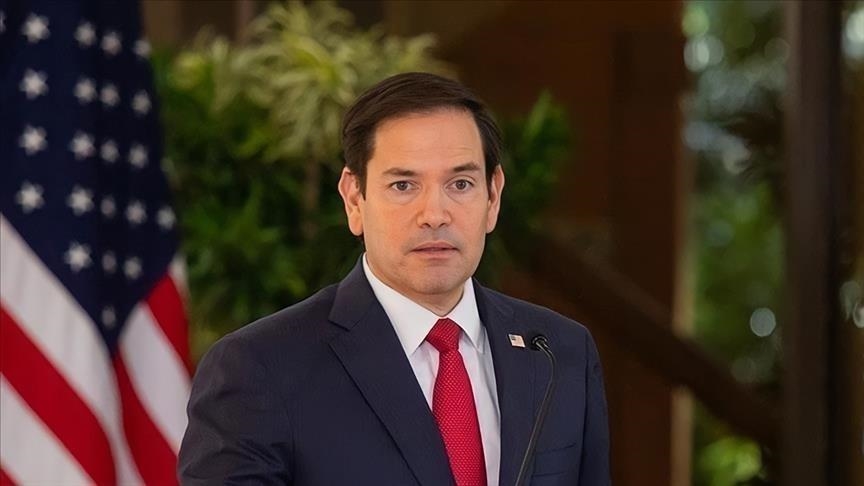نحو فقه انساني رحموتي: قراءة روحية عقلانية للدين الإسلامي

الصادق أحمد العثماني ـ أمين عام رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية
في خضم التحولات العميقة التي يشهدها العالم المعاصر، لم يعد السؤال الديني محصورًا في حدود الحلال والحرام بصيغتهما التقليدية، بل أصبح سؤالًا وجوديًا وأخلاقيًا يتعلق بقدرة الدين على منح الإنسان المعنى، والطمأنينة، والشعور بالكرامة في عالمٍ مضطرب.
فالإشكال الحقيقي الذي يواجه الفكر الإسلامي اليوم لا يكمن في النص الديني ذاته، بل في طرائق قراءته، وفي الكيفية التي تحوّلت بها بعض التفسيرات التاريخية إلى قوالب جامدة، تُقدَّم وكأنها الدين نفسه، رغم أنها نتاج سياقات زمنية واجتماعية لم تعد قائمة.
لقد نزل الإسلام في جوهره خطابًا موجَّهًا إلى الإنسان، يخاطب عقله ووجدانه، ويحرره من الخوف والاستعباد، ويضعه في مركز الاستخلاف والمسؤولية. فالقرآن الكريم منذ أولى آياته دعا الإنسان إلى القراءة، والتفكير، والتأمل، وجعل العقل أداة الفهم والتكليف معًا.
وتكفي الإشارة إلى كثرة الآيات التي تحفّز على التعقل والتدبر، مثل قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، للدلالة على أن الإسلام لا يقوم على تعطيل العقل، بل على إيقاظه وتحريره.
غير أن مسار التاريخ الديني عرف لحظات انحراف، حيث جرى الخلط بين الوحي الإلهي وفهم البشر له، وبين قداسة النص وتاريخية التأويل. فتحولت اجتهادات فقهية ارتبطت بظروف سياسية واجتماعية معينة إلى مسلّمات نهائية، وأصبح الإنسان مطالبًا بالتكيّف معها، حتى وإن أفضت إلى القلق، أو التناقض مع فطرته، أو الصدام مع واقعه المعاصر.
من هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى ما يمكن تسميته بالعقلانية الروحية، أي ذلك المسار الفكري الذي يجمع بين صفاء الإيمان وجرأة العقل، ويجعل من مقاصد الدين وغاياته الإنسانية ميزانًا لفهم النصوص وتفعيلها.
إن العقلانية الروحية لا تعني إفراغ الدين من بعده الغيبي، ولا اختزاله في منظومة أخلاقية مجردة، بل تعني تحرير الإيمان من الخوف والتشدد، وربطه بالمعنى والسعادة الإنسانية. فالإيمان في الإسلام لم يكن يومًا مشروع قلق دائم، ولا عبئًا نفسيًا يُثقل كاهل الإنسان، بل كان وعدًا بالسكينة والرحمة. يقول الله تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾، ويقول أيضًا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾، وهي آيات تؤسس لفهمٍ يرى في الدين طريقًا للطمأنينة لا وسيلة للترهيب.
وقد عبّر النبي ﷺ عن هذا المعنى بوضوح حين قال: “إن هذا الدين يسر”، وحين أوصى بقوله: “يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا”. فالدين، وفق هذا التصور النبوي، ليس مشروع تضييق على الإنسان، بل أفقًا لتحريره أخلاقيًا وروحيًا. وكل خطاب ديني يُنتج الكراهية، أو يشرعن العنف، أو يصادر حرية الضمير، هو خطاب يبتعد عن روح الإسلام، مهما استند إلى نصوص مجتزأة أو قراءات حرفية.
إن جعل الإنسان مركز الفهم الديني، أو ما يمكن تسميته بأنسنة الدين، لا يعني تقديم الإنسان على الله، بل يعني فهم مراد الله من خلال كرامة الإنسان. فالقرآن الكريم يقرر بوضوح: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، وهذه الكرامة غير مشروطة بدين أو عرق أو مذهب. ومن هنا، فإن أي فهمٍ للدين ينتقص من كرامة الإنسان، أو يحوّله إلى مجرد أداة في صراعات أيديولوجية، هو فهمٌ يناقض جوهر الرسالة.
وقد وعى فلاسفة الإسلام الكبار هذه الحقيقة مبكرًا. فابن رشد أكد أن العقل لا يتعارض مع الشريعة، بل إنهما متكاملان، ورأى أن تعطيل العقل هو تعطيل لمقصد من مقاصد الدين. أما أبو حامد الغزالي، فقد جعل مقاصد الشريعة مرتبطة بحفظ مصالح الإنسان الأساسية، وعلى رأسها النفس والعقل، وهو ما يعني أن كل اجتهاد ديني يُفضي إلى العنف أو التجهيل أو الإقصاء هو اجتهاد فاقد للشرعية المقاصدية. كما قدّم ابن عربي رؤية إنسانية عميقة، حين عبّر عن سعة القلب الإنساني وقدرته على احتواء الاختلاف، في مقابل ضيق الأفق التعصبي الذي لا يرى في الآخر إلا تهديدًا.
إن القراءة المعاصرة للنص الديني لا تعني القطيعة مع التراث، بل تعني التعامل معه بوصفه جهدًا بشريًا قابلًا للنقد والمراجعة. فالفقه ليس وحيًا، بل فهم للوحي، وهو فهم يتأثر بالبيئة والسياق.
وقد نبّه الشاطبي إلى أن الأحكام الشرعية إنما وُضعت لتحقيق مصالح العباد، وأنها تدور مع المصلحة وجودًا وعدمًا. وعليه، فإن أي تأويل للنص يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، أو يبرر الإكراه في الدين، أو يشرعن العنف باسم العقيدة، هو تأويل فاقد لروحه الشرعية، حتى لو استند إلى ظاهر النص.
ويكفي التذكير بقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، وقوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾، للتأكيد على أن حرية المعتقد ليست تنازلًا حداثيًا، بل أصل قرآني راسخ. فالإيمان الذي يُفرض بالقوة لا يصنع إنسانًا صالحًا، بل ينتج نفاقًا وعنفًا، وهو ما أثبتته تجارب التطرف الديني المعاصر.
إن الأزمة الحقيقية التي يعيشها الخطاب الديني اليوم ليست أزمة نص، بل أزمة فهم، وليست أزمة عقيدة، بل أزمة عقلٍ خائف من التجديد. ومن هنا، فإن مسؤولية المفكر والفقيه المسلم في هذا العصر هي تحرير الدين من القراءات المغلقة، وإعادة ربطه بالإنسان، بوصفه غاية الخطاب الإلهي وموضوعه. فالدين الذي لا يخدم سعادة الإنسان، ولا يحفظ كرامته، ولا يمنحه الأمل، يتحول إلى طقس فارغ أو أداة صراع.
إن مستقبل الإسلام مرهون بقدرته على استعادة بعده الإنساني والأخلاقي، وعلى تقديم نفسه بوصفه رسالة حياة لا أيديولوجيا صدام. إسلامٌ يوازن بين العقل والوحي، بين النص والمقصد، بين الإيمان والحرية، هو وحده القادر على مخاطبة إنسان العصر، والمساهمة في بناء عالمٍ أكثر عدلًا وسلامًا.
وفي هذا المعنى العميق، تتجلى حكمة قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، باعتبارها خلاصة الدين، وروحه، وغايته الإنسانية الكبرى.