دلائل الخيرات: جمالية الذكر وفلسفة المحبة في التجربة الصوفية عند الإمام الجزولي
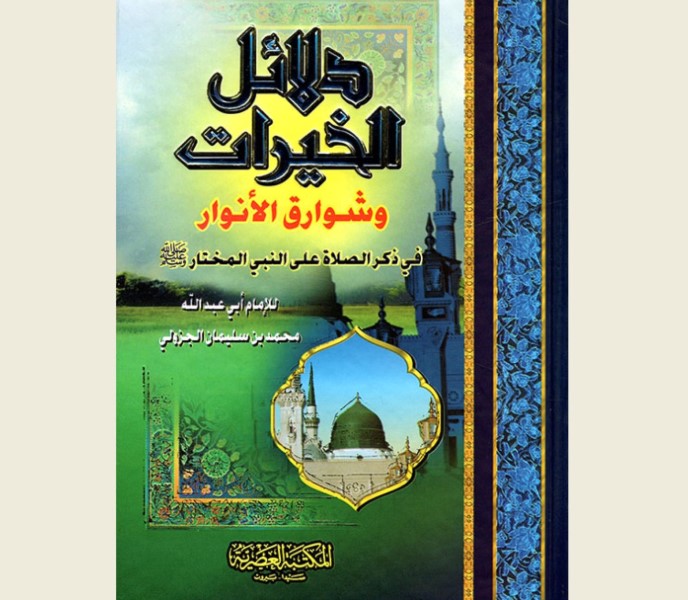
حمزة مولخنيف
وُلد الإمام أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أبي بكر الجزولي السملالي الحسني في ربوع سوس المغربية على الأرجح سنة 807 ه، في بيئة علمية وصوفية مشبعة بأنوار الزوايا وتقاليد العلم والورع. يرجع نسبه إلى البيت النبوي الشريف، وهو من قبيلة جزولة المشهورة، وقد نشأ في حضن ثقافة مغربية أصيلة تشربت روح القرآن والحديث، وامتزج فيها العلم بالزهد، والفقه بالتصوف، والفكر بالسلوك العملي.
درس الجزولي ببلده أولًا، ثم رحل إلى فاس حيث تشرّب علوم الشريعة واللغة والمنطق، وأخذ عن كبار العلماء والصالحين. إلا أن ما ميّزه عن غيره من علماء عصره هو انصرافه إلى تربية الباطن وتزكية النفس، حتى صار من كبار الأولياء المجددين في القرن التاسع الهجري، مؤسسًا لطريقة روحية كان لها أثر بالغ في الغرب الإسلامي والمشرق معًا.
وقد بلغ الإمام الجزولي ذروة إشعاعه الروحي والفكري حين ألّف كتابه الشهير «دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار ﷺ»، الذي لم يزل إلى اليوم من أكثر كتب الصلوات تداوُلًا في العالم الإسلامي، يتبرك به القراء، ويتغنى به المنشدون، وتتشرب به القلوب في حلق الذكر والزوايا، من فاس ومراكش إلى القاهرة ودمشق وجاوة.
لكن «دلائل الخيرات» ليس مجرد كتاب أوراد وصلوات، بل هو نصّ أدبي وروحي وفلسفي بامتياز، ينهض على رؤية شمولية للوجود والإنسان والروح والعلاقة بالمطلق. فهو يجمع بين جمال القول، وسر الذكر، وحرارة الحب النبوي، وعمق التجربة الصوفية التي تتجاوز حدود الطقس إلى أفق الوعي والتجلّي.
في ظاهره، يبدو الكتاب ترتيبا لمجموعة من الصلوات المأثورة والمبتكرة على النبي ﷺ، منظّمة بحسب أيام الأسبوع، تصحبها أدعية ومناجاة وتوسلات. لكن في باطنه، هو بناء رمزي متكامل، يختزل فلسفة الجزولي في العلاقة بين الإنسان والسرّ المحمدي، ويعبّر عن نزعة روحية تسعى إلى تذويب الكثرة في الوحدة، وإلى رفع الوعي من ظاهر العبادة إلى باطن المحبة.
إنّ كل صلاة من صلوات دلائل الخيرات ليست مجرد تكرار للثناء، بل هي تشكيل لغوي للوجد، وموسيقى باطنية تصوغ المحبة في نغمة، وتحوّل الذكر إلى حضور. فالجزولي لم يكن يكتب كعالم متكلّف أو ناسك منطوٍ، بل كفيلسوف عارف، يعي أن اللغة ليست وسيلة للقول فحسب، بل هي وسيلة للتجلّي.
ولذا جاءت عباراته مشبعة بالإيقاع القرآني، تتردد فيها الأسماء الحسنى والنعوت المحمدية في تناسق يجعل النص أشبه بترتيل مستمرّ، يخلق في السامع إحساسًا بالانتقال من الزمان إلى السرمد، ومن العالم الحسّي إلى فضاء الذكر المطلق.
لقد كان الإمام الجزولي يعيش في زمنٍ عرف تحوّلات سياسية وثقافية وروحية كبيرة في المغرب، بعد ضعف الدولة المرينية وبروز الحركات الصوفية والزوايا كقوة اجتماعية وروحية حامية للهوية والدين. فجاء كتابه استجابة عميقة لتلك الحاجة إلى إعادة بناء المعنى في زمن التصدّع.
دلائل الخيرات بهذا المعنى لم يكن مجرد عمل تعبّدي، بل مشروع ثقافي وروحي لإحياء الصلة بالنبي ﷺ بوصفه رمز الكمال الإنساني، ومركز المحبة الإلهية، ومفتاح الفهم العميق للوجود.
لقد رأى الجزولي أن الصلاة على النبي ليست فقط دعاءً، بل هي حركة وجودية؛ فيها يتجاوز الإنسان ذاته، ليشارك في التسبيح الكوني الذي تشارك فيه الموجودات جميعًا. إنها عودة من التفرّق إلى الوحدة، ومن الغفلة إلى الحضور، ومن العجز إلى الفيض. لذلك جعل من الصلاة على النبي طريقًا لتوحيد النفس، وتربية الوجدان، وتزكية القلب، وهي عنده ليست ذكرًا لفظيًا فقط، بل «معراج للروح نحو الأنوار المحمدية».
وهكذا يلتقي في دلائل الخيرات بعدان متكاملان: بعد أدبي لغوي يعكس ذوقًا بلاغيًا رفيعًا، وبعد صوفي فلسفي يُعبّر عن رؤية ميتافيزيقية للوجود والإنسان.
من الناحية الأدبية، يظهر الجزولي متأثرًا بالبلاغة القرآنية، وبالسجع الإيقاعي الذي يجعل من اللغة صلاة في ذاتها. الجمل تتوالى كأنها أمواج من النور، تُبنى على التكرار والتوازي، فيتحول النص إلى مقام من مقامات السماع الروحي.
ومن الناحية الصوفية، فإن كل كلمة في الكتاب مشبعة بدلالات رمزية تشير إلى مقامات السلوك: الذكر، المحبة، الشوق، الفناء، والبقاء. أما من الناحية الفلسفية، فالنص يؤسس لفكرة الإنسان الكامل كما تتجلى في الذات المحمدية، باعتبارها المظهر الأكمل للوجود الإلهي في العالم.
ولعل ما يميز الجزولي عن غيره من المؤلفين في فن الصلوات هو قدرته على تحويل المحبة إلى معرفة، والمعرفة إلى فن لغوي. فالصلاة عنده ليست مجرد شعور عاطفي، بل تجربة معرفية تكشف سرّ العلاقة بين الخالق والمخلوق، بين النور والمظهر، بين الكلمة والوجود.
في كل مقطع من مقاطع دلائل الخيرات يمكن أن نلمح أثرًا من فلسفة التجلي عند ابن عربي، ونَفَسًا إشراقيًا قريبًا من حكماء التصوف الفلسفي، دون أن يفقد النص بساطته التعبدية ودفء الإيمان الشعبي الذي جعله قريبًا من القلوب.
إن التأمل في البنية الداخلية لكتاب دلائل الخيرات يكشف أنه لم يُؤلف وفق منطق الترتيب الظاهري فحسب، بل وفق هندسة روحية دقيقة، تنبني على التدرج من ظاهر الذكر إلى باطنه، ومن خطاب الثناء إلى مقام الفناء في المحبوب. فالجزولي لا يقدّم الصلوات باعتبارها نصوصًا معزولة، بل كسلسلة من المراقي، يتصاعد فيها الذاكر من مقام إلى آخر، حتى يبلغ لحظة الكشف، حيث يغدو الذكر ذاته حضورًا محضًا لا يفصله عن الحق حجاب. في هذا المعنى، يتحول دلائل الخيرات إلى ما يشبه خريطة للطريق الروحي، تسلك فيها الروح من خلال الكلمات نحو النور الأصلي الذي صدرت عنه.
إنّ من أعجب ما في الكتاب أنّه يجعل اللغة نفسها وسيلة للترقي الروحي، فالعبارة عند الجزولي ليست مجرد وعاء للمعنى، بل هي كيان حيّ نابض، يتحوّل بالذكر إلى طاقة روحية. فكل تكرار في النص ليس إعادة، بل ارتقاء.
والعبارة الواحدة تتجدد دلالتها مع كل نطق بها، لأن الذكر عند الصوفي ليس من فعل اللسان وحده، بل من حركة الوجود كله. ومن هنا تتبدّى فلسفة اللغة في التصوف، حيث تصير الكلمة جسدًا للمعنى، والمعنى ظلًا للسرّ، والسرّ طريقًا إلى الحضور الإلهي.
في ضوء هذا الفهم، يمكن القول إن دلائل الخيرات يمثل تجربة فريدة في تقديس الكلمة، وتحريرها من أسر التقريرية. فالجزولي يكتب كما لو أنه يترجم ما لا يُقال، ويعبّر عن ما لا يُدرك بالحواس. لغته ذات بُعد إشراقي، تتجاوز المعجم إلى الإيقاع، وتتجاوز المعنى إلى النور. وهذا ما يجعل قارئ الكتاب لا يقرأ فقط، بل يشارك في إنشاد خفيّ، كأن الحروف نفسها تنطق بالحب وتفيض بالنور.
إنّ الصلوات الجزولية تُعيدنا إلى مركز الجمال في الفكر الإسلامي، حيث لا يُفصل الجمال عن الحقيقة، ولا العبادة عن الشعر. فالجمال عند الجزولي ليس ترفًا لغويًا، بل هو وجه الحقيقة حين تتجلّى في الصور. ولذا جاءت صلواته مفعمة بالصور البيانية الرفيعة التي تُشبه الموج أو النور أو النسيم، فيُكثر من التشبيهات والنعوت المحمدية التي تُظهر النبي ﷺ في هيئة نورانية تفيض بالعطف والصفاء والرحمة، حتى يتحول الذكر من فعل تعبدي إلى تجربة جمالية وجودية.
ولعل هذا ما جعل «دلائل الخيرات» لا يُقرأ بعقل الفقيه فحسب، بل يُتذوّق بذوق العارف، ويُتغنّى به بصوت المنشد. لقد جمع الجزولي بين الفقه والذوق، بين النص والوجد، بين الدرس والإنشاد، فكان كتابه مدرسة في الذكر ومدرسة في الجمال في آن واحد.
وإذا تأملنا الجانب الفلسفي في الكتاب وجدنا أنه يقوم على رؤية كونية موحّدة، ترى في النبي ﷺ الوسيط الأعظم بين العالمين، والمظهر الأكمل للأسماء الإلهية. هذه الفكرة التي نجد صداها في التراث الصوفي الكبير منذ الحلاج إلى ابن عربي، تتخذ عند الجزولي طابعًا تربويًا وشعبيًا في آنٍ واحد، إذ يجعلها قابلة للتذوّق اليومي عبر الذكر والصلاة.
فهو لا يخاطب النخبة الفلسفية، بل يخاطب الأمة كلها، داعيًا إياها إلى المشاركة في الفيض المحمدي الذي لا ينقطع. ومن هنا تتجلّى عبقريته في تحويل الفكرة الميتافيزيقية إلى ممارسة وجدانية، تجعل الفلسفة جزءًا من الحياة، والحياة طريقًا إلى النور.
إنّ الصوفية الجزولية كما تنعكس في دلائل الخيرات ليست صوفية اعتزال وانطواء، بل صوفية حضور ومشاركة في الوجود. فالنبي ﷺ في الكتاب ليس مجرد موضوع للمدح، بل هو مرآة للإنسان الكامل الذي يُلهم السالكَ كيف يكون رحيمًا، متواضعًا، نقيّ السريرة، محبًا للخلق، محققًا لروح العبودية الحقّة. الصلاة عليه ليست عبادة خارجية، بل تربية على الجمال الداخلي، لأن من أحبّ الكامل تمثّل كماله، ومن أكثر الصلاة عليه امتلأ نوره من نوره.
ولذلك ظلّ «دلائل الخيرات» على مرّ القرون مدرسة لتربية المحبة، يتخرج منها الزهّاد والمجاهدون والعلماء والعارفون، يحملون سرّ الذكر في قلوبهم، وينشرون في الناس نور السكينة. وليس غريبًا أن يصبح هذا الكتاب في تاريخ المغرب رمزًا للهوية الروحية، ومصدرًا لتوحيد الوجدان الجمعي حول صورة النبي ﷺ، خاصة في الأزمنة التي كان فيها الخطر الخارجي يهدد وحدة الأمة.
لقد أدى دلائل الخيرات وظيفة حضارية وثقافية لا تقل شأنًا عن أي نص فلسفي أو سياسي، لأنه أعاد بناء مركز المعنى في المخيال الجماعي. فمن خلاله صارت الزوايا والمدارس والأسر المغربية تحفظ تلاوة الصلوات اليومية، وتجد فيها دواءً للقلق ومرجعًا للطمأنينة.
وفي المجتمعات التي هاجرت إليها الطرق الجزولية، من إفريقيا الغربية إلى الحجاز والهند، حمل المريدون الكتاب كما يحملون الماء والزاد، حتى صار حضوره جزءًا من هوية التدين الشعبي، وتُزيّن به البيوت والمكتبات والمساجد. وهكذا تحوّل من نص فردي كتبه صوفي في القرن التاسع الهجري، إلى نصّ جماعي حيّ يعيش في ذاكرة الأمة حتى اليوم.
من الناحية الفلسفية الخالصة، يمكن قراءة دلائل الخيرات بوصفه تعبيرًا عن رؤية أنطولوجية للإنسان في العالم. فالصلاة على النبي كما يفهمها الجزولي ليست فقط صلة بين العبد والرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي فعل كوني يشترك فيه الوجود بأسره. الكائنات كلها تصلي، كما يقول القرآن: «وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم». فحين يصلي المؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يشارك في هذا التسبيح الكوني ويستعيد موقعه في شبكة الوجود الكبرى، حيث كل ذرة تنطق بالحمد.
من هنا تغدو الصلاة على النبي فعل تذكّر للكينونة الأصلية، واستعادة للانتماء إلى النور الأول. وهذا البعد الكوني هو ما يجعل النص الجزولي يتجاوز الزمان والمكان، ويُقرأ اليوم كما كان يُقرأ قبل ستة قرون، لأن روحه تتكلم لغة الوجود لا لغة الثقافة وحدها.
في ضوء ذلك، يمكن القول إن دلائل الخيرات ليس كتابًا في الذكر فحسب، بل هو نص في فلسفة الوجود من منظور المحبة. فالمحبة هي التي تجمع بين الله والخلق، بين الظاهر والباطن، بين الكلمة والمعنى. والنبي ﷺ هو المثال الأعلى لتلك المحبة التي صارت وجودًا، حتى قال العارفون إن الخلق كله إنما وُجد من نوره. الجزولي، حين يفيض صلواته ونعوته ومدائحه، إنما يسعى إلى إعادة وصل العالم بأصله، والإنسان بمصدر نوره، عبر جسر من الكلمات التي تحوّلت بصدق القلب إلى أنوار.
لقد استطاع الإمام الجزولي أن يصوغ في كتابه خلاصة الروح المغربية في بعدها المتوسطي والكوني معًا: روح تتعبد بالجمال، وتفكر بالحب وتذكر بالكلمة، وتحبّ الله في وجه نبيه الكريم. لذلك ظلّ أثره ممتدًا في المدارس الصوفية الكبرى التي خرجت من رحمه، والتي كان لها أثر في التربية الروحية، وفي المقاومة السياسية وفي صياغة الوجدان الديني للأمة المغربية والأفريقية.
إنّ الجمال في دلائل الخيرات ليس عرضًا بل جوهرًا، وليس ترفًا بل طريقًا إلى الحق. فقد فهم الإمام الجزولي أن القلب لا يُهذَّب بالبرهان العقلي وحده، ولا بالزجر الشرعي فقط، بل بإشراق الجمال في الكلمة واللحن والمعنى. لذلك جاءت صلواته كأنها لوحات من النور اللفظي، فيها يتداخل السمع والبصر والقلب، فيصير النص كائنًا حيًّا يُشعّ من داخله. فكل جملة تفتح بابًا على تأمل، وكل نعت من نعوت النبي ﷺ يُعيد القارئ إلى مرآة ذاته، حيث يرى في صفات الرسول صورة الكمال الممكن في الإنسان.
في فلسفة الجمال الصوفي، كما تتجلى في هذا الكتاب، يتحول الذكر إلى تذوّق للحقائق، والجمال إلى مرقاة نحو الحقيقة. فالجمال ليس مظهرًا يُعجب، بل هو أثر من آثار الحضور الإلهي في العالم. ومن هنا كان حبّ النبي ﷺ في رؤية الجزولي ليس انفعالًا وجدانيًا فحسب، بل إدراكًا لجمال الحقيقة المطلقة كما تجلّت في أبهى صورها الإنسانية. فالإنسان الكامل عنده هو مرآة الجمال الإلهي، وكلما ازدادت المحبة ازداد انكشاف الجمال.
إنّ الجمال هنا طريق للمعرفة، لا يقف عند الحس ولا يتوقف عند الفكر، بل يتجاوزهما إلى نور الشهود. ولذلك فإن دلائل الخيرات لا يُدرَك جماله إلا بالجمع بين القراءة والتسبيح، بين الفكر والوجدان. فالنص يدعو قارئه إلى أن يكون شاهدًا لا محللًا فقط، مُحبًّا لا دارسًا فحسب.
يستعمل الجزولي في كتابه لغة تؤنس بين الإشراق والرمز. فهو يكثر من الأوصاف التي تومئ أكثر مما تُصرّح، وتلمّح أكثر مما تُفصح، لأن الجمال في التصوف لا يُقال صراحة، بل يذاق ويُرى بالقلب. فتراه يصف النبي ﷺ بأنه “نور النور، وسرّ السرور، وضياء الوجود”، وهي عبارات تبدو شعرية في ظاهرها، لكنها في عمقها تعبير عن فلسفة وجودية ترى أن الكمال الإنساني هو مظهر الجمال الإلهي في الكون. هذه الرؤية تجعل من النبي ﷺ ليس فقط رسولًا مُبلّغًا، بل رمزًا كونيًا يجمع بين الأرض والسماء، بين المادة والروح، بين الكلمة والسرّ.
إنّ الجزولي يحرّر الإنسان من ضيق المادية بربطه بمصدر النور، وبذلك يصبح الذكر عنده فعل مقاومة ضدّ النسيان، والمحبّة فعل مقاومة ضدّ القسوة، والجمال فعل مقاومة ضدّ القبح الذي يطغى حين تُنسى الروح.
ولهذا بقي دلائل الخيرات حيًا في الوجدان الإنساني، لأنه يقدم ترياقًا ضدّ العدمية التي تبتلع المعنى في الأزمنة الحديثة. فكل من تلا صلواته شعر أن الكلمة نفسها دواء، وأن النور المنبعث من ذكر النبي ﷺ هو ترياق ضدّ وحشة العالم.
لقد تجاوز أثر دلائل الخيرات حدود الزوايا المغربية إلى العالم بأسره، وصار يُقرأ في المساجد والبيوت في الحجاز ومصر والهند والسودان وتركيا وإندونيسيا، وفي طرق الصوفية الكبرى: الشاذلية، القادرية، التيجانية، الخلوتية، وغيرها. هذا الانتشار الواسع لا يُفسّر فقط بالروح الدينية للكتاب، بل أيضًا بجماليته الفنية الفريدة التي جعلته نصًا ذا قابلية للتلقّي السمعي والجماعي.
إنّ تلاوته في الجماعة تولّد طاقة من الانسجام بين الأصوات والنفوس، حتى يغدو النص موسيقى روحية تشترك فيها القلوب. هذه الخاصية جعلت الكتاب أقرب إلى الشعر الصوفي، بل إلى الإنشاد الكوني الذي يحاكي تناغم الخلق في تسبيحه الدائم.
ومع الزمن، أصبح دلائل الخيرات نصًا مؤسسًا لثقافة الذكر الجماعي، ومصدراً لصياغة الذوق الديني عند ملايين المسلمين. فاللغة الجزولية بلاغة الذكر، والإيقاع الجزولي موسيقى المحبة، والصورة الجزولية لوحة النور. وفي هذا التداخل بين البلاغة والوجدان، تبرز عبقرية التصوف المغربي الذي استطاع أن يصوغ الإسلام في هيئة جمال، والعقيدة في هيئة حب، والمعرفة في هيئة ذكر.
من منظور فلسفي حديث، يمكن قراءة دلائل الخيرات بوصفه نصًا يعبّر عن ميتافيزيقا النور. فكل الوجود عند الجزولي يتأسس على العلاقة بين النور والمحبّة، بين الإشراق والفيض. فالنور هو الوجود، والمحبّة هي حركة النور نحو الظهور. ومن هنا تصبح الصلاة على النبي ﷺ تجسيدًا لهذه الحركة الكونية، إذ هي في جوهرها اعتراف بأن الوجود كله مدين لذلك النور الأول. هذه الرؤية تُقارب التصورات الفلسفية الكبرى عند الإشراقيين مثل السهروردي، وعند العرفاء كابن عربي، لكنها تمتاز بالبساطة التربوية التي تجعلها متاحة للقلوب قبل العقول.
ولأن دلائل الخيرات يُقيم صلته بالحق عبر الجمال، فقد كان له أثر عميق في الفنون الإسلامية. فالخطاطون كتبوا صلواته بالمداد الذهبي، والمنشدون غنّوها بالألحان المشرقية والمغربية، والزوايا جعلت منها محور مواسمها الروحية. وبهذا المعنى، أسهم الكتاب في صناعة الجمال الديني في الثقافة الإسلامية، حيث صار الذكر لونًا من الفن، والفن لونًا من العبادة. هذه الصلة بين الفن والعبادة هي ما جعل الحضارة الإسلامية تثمر ذلك التوازن النادر بين العقل والوجدان، بين الفكرة والذوق، بين التجريد والتصوير.
إنّ الإمام الجزولي لم يكتب كتابًا ليُقرأ فقط، بل ليُعاش. فقد أراد أن يكون دلائل الخيرات طريقًا نحو الله، ومدرسة في الذكر، وشفاءً للقلوب من ظلمة الغفلة. لذلك ظلّ الكتاب بعد قرون يُقرَأ بالحبّ ذاته الذي كُتب به. وكل من تلاه وجد فيه نصيبه من النور، لأن النور لا يهرم ولا يُستهلك. وربما لهذا السبب لم يعرف التاريخ الإسلامي نصًا آخر يوازيه في استمراره وشموله وتأثيره الروحي.
وفي سياق الفكر الإنساني المعاصر، الذي تهيمن عليه السرعة والقلق والانفصال، يبدو دلائل الخيرات أكثر من أي وقت مضى دعوة إلى استعادة المعنى المفقود. فهو يُذكّر الإنسان بأنه ليس كائنًا مستهلكًا، بل روحًا خُلقت للحبّ والمعرفة.
إنّ الصلاة على النبي في زمن الاغتراب هي إعلان انتماءٍ إلى النور، وتذكير بأن في القلب سكنى الله، وفي الإنسان قبسًا من الجمال الأزلي. من يقرأ الجزولي اليوم يجد فيه ما يتجاوز الدين الطقوسي إلى الدين الوجودي، الذي يجعل من الذكر فلسفة للحياة، ومن المحبة طريقًا للخلاص.
هكذا يثبت الإمام محمد بن سليمان الجزولي أنه لم يكن مجرد فقيه أو صوفي، بل حكيمٌ عاشقٌ جمع بين العلم والحال، بين الكلمة والنور. وفي كتابه دلائل الخيرات صاغ أعذب ترنيمة للمحبة في تراث الإنسانية، ترنيمة يتردد صداها في المساجد والزوايا والقلوب منذ ستة قرون، وما تزال إلى اليوم تذكّرنا أن الجمال طريق إلى الله، وأن من أحبّ الجمال أحبّ الحقيقة، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ذكرًا لاسم، بل حضورٌ للمعنى في القلب.
تُختتم سيرة الإمام محمد بن سليمان الجزولي كما ابتدأت: بسرٍّ من أسرار الولاية، إذ ظلّ نورُه ممتدًّا بعد رحيله كما كان مشعًّا في حياته. تروي المصادر أنّه تُوفي مسمومًا بمدينة آسفي نحو سنة 870هـ، بعد أن ذاع صيته واجتمع الناس حوله من كل صوب، فغدا حضوره الروحي باعثًا على الغيرة والحسد. لكن موته لم يكن انطفاءً، بل انتقالًا من حضورٍ جسدي إلى إشعاعٍ رمزي خالد، إذ بقي قبره مزارًا للعارفين، وكتابه دلائل الخيرات ميراثًا روحيًّا يُتلى على مرّ القرون.
وهكذا تجلّت في وفاته كما في حياته تلك المعادلة الصوفية الكبرى: أن العارف الحقّ لا يموت، بل يتحوّل إلى ذكرٍ دائم، وإلى نورٍ يفيض على القلوب، مصداقًا لقوله تعالى: ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون.



