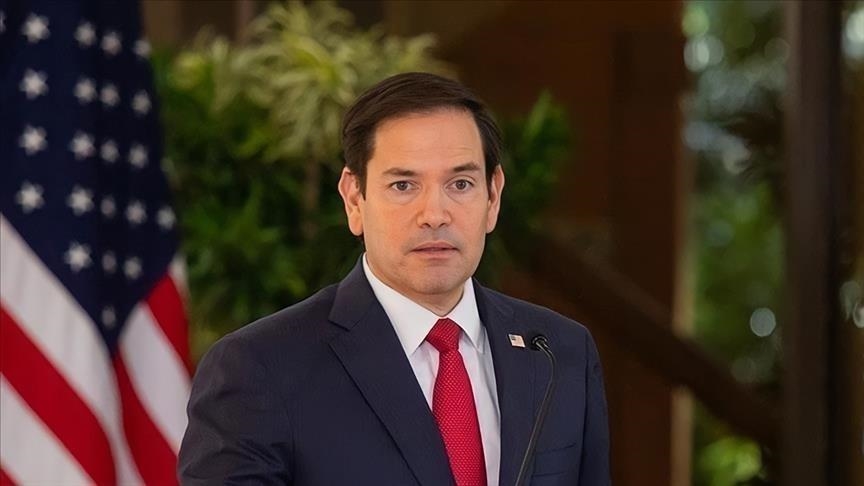حين يصبح «التقدم» صنمًا: تأملات في عبودية التكنولوجيا وانهيار معنى الاستخلاف

معتز فيصل
لم يعد الخطر الأكبر الذي يواجه مجتمعاتنا هو الفقر أو التخلّف أو نقص المعرفة، بل الافتتان. افتتانٌ ناعم، زاحف، يُصيب العقول باسم العلم، ويُخدّر الضمائر باسم التقدم، ويُعيد تشكيل الإنسان دون أن يشعر، حتى يفقد قدرته على السؤال والمقاومة.
أخطر ما نراه اليوم عند شريحة من شبابنا — ممن يسّر الله لهم الهجرة، وفتح عليهم أبواب التعليم والرفاه — هو القابلية الكاملة لاستيراد نماذج الإقتصاد وأساليب الحياة اليومية والتفاعلات البشرية وقيم المعاملات بينهم في ما تعرف بدول العالم الأول وإسقاطها على واقعنا إسقاطًا أعمى، بلا وعي تاريخي، ولا حسّ أخلاقي، ولا سؤال حضاري. كأن العالم لا يُفهم إلا من نافذة واحدة، وكأن «التقدم» وصفة جاهزة صالحة لكل زمان ومكان.
في هذا الوعي المشوَّه، لم يعد الإنسان إنسانًا، بل وظيفة. ولم تعد المهن البسيطة تعبيرًا عن شرف العمل والاستخلاف، بل علامات تخلف يجب إزالتها. الإسكافي، والنجّار، والجزار، والحرفي… كلهم في نظر هذا العقل الجديد بقايا زمن منقرض، يجب استبدالهم بالآلات، والماسحات الرقمية، والخوارزميات التي لا تتعب ولا ترحم. عالم بلا أيدٍ متسخة، بلا وجوه بشرية، بلا علاقات حية؛ عالم يُدار بالأرقام، ويُقاس بالربح والخسارة.
وهنا يبدأ الانحراف الفلسفي العميق: حين ينفصل العلم عن الحكمة، والتقنية عن الأخلاق، والتقدم عن الغاية. فالعلم، حين يُنزَع من سياقه القيمي، لا يعود وسيلة للعمارة، بل أداة للسيطرة. والتكنولوجيا ليست محايدة؛ إنها تحمل رؤية كاملة للعالم، ترى الإنسان مادة قابلة للرصد، والتصنيف، والتتبع، والتجريد من الخصوصية.
الدولة الحديثة ليست مهووسة بالبيانات من أجل إصلاح الإنسان، بل من أجل إدارته والتحكم فيه. هوس بالإحصاءات، وبالقياس، وبالتتبع الدائم للأجساد والسلوكيات. وما السباق المحموم نحو تقنيات التعرّف على الوجوه، والبصمات، وتعقّب الأنشطة اليومية، إلا تعبير عن هذه العقلية. تُرفع شعارات الأمن وحماية الحدود، لكن الحقيقة أبعد من ذلك: الخوف ليس من الجريمة، بل من الإنسان الحرّ الذي لا يمكن اختزاله في «داتا».
المؤلم — بل المخيف — أن تجد من شبابنا، وهم مسلمون يعلنون الإيمان بالله واليوم الآخر، من يتبنّى هذا النموذج ويدافع عنه بعصبية دينية جديدة. يُهاجم كل من يُبدي قلقًا أخلاقيًا، ويُسفّه كل من يطرح سؤالًا إنسانيًا، ويُلصق به تهم الرجعية والتخلّف والخوف من الجديد. وكأن السؤال صار جريمة، وكأن النقد خيانة، وكأن التاريخ لم يُعلّمنا أن كل طغيان بدأ باسم «التقدم».
لقد تحوّل «التطور اللامحدود» إلى دين بديل: له كهنته، ومحرماته، ومقدساته، وله صنمه الأكبر — التكنولوجيا — الذي لا يُسأل عما يفعل. تُقدَّم له الكرامة الإنسانية قربانًا، وتُضحّى من أجله بالخصوصية، وبالعلاقات البشرية، وبمعنى الاستخلاف نفسه. ومن يجرؤ على مساءلته يُقصى، ويُشيطَن، وربما يُنبذ اجتماعيًا.
في العمق، هذه ليست معركة تقنية، بل معركة معنى. هل الإنسان عبدٌ لله مُكرّم، أم موردٌ قابل للإدارة؟ هل التقدم وسيلة لخدمة الإنسان، أم أداة لإخضاعه؟ هل نملك شجاعة القول إن ليس كل جديد خيرًا، ولا كل علم هداية، ولا كل تطور خلاصًا؟
إن أخطر ما قد نصل إليه، هو أن نصحو يومًا فنكتشف أننا دافعنا عن السلاسل باسم الحرية، وباركنا الأصنام باسم العقل، وخسرنا الإنسان ونحن نظن أننا نُشيّد المستقبل.