“حكمة القلب” في متن ابن قيم الجوزيه
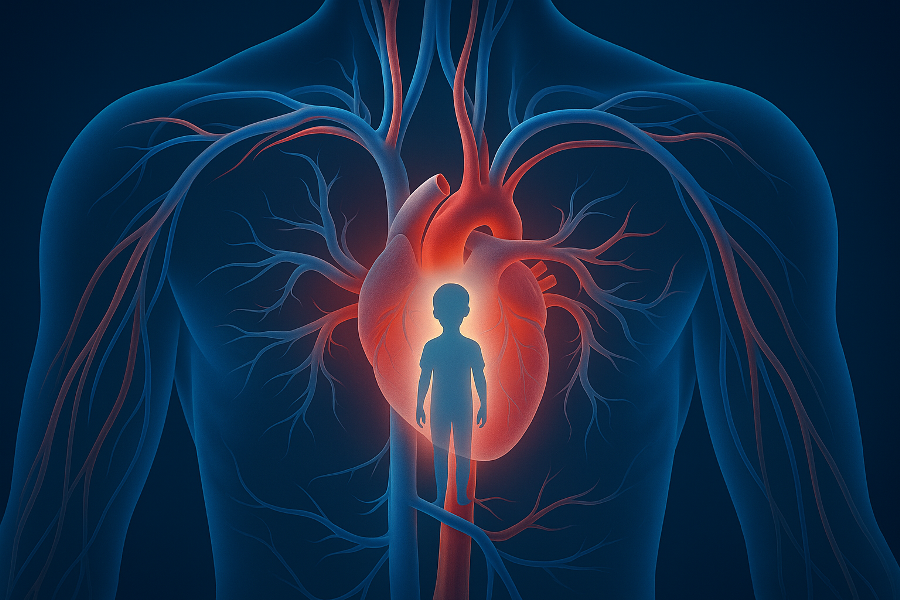
محمد زاوي
نحن المتأثرون بالحداثة الغربية والمنبهرون بها، لا نرى في القلب غير وظيفته المركزية في الجهاز الدموي، أقصد وظيفة ضخ السائل الدموي باتجاه سائر أعضاء الجسم، تلك الوظيفة التي يؤديها القلب بتركيب عضوي من أُذينين وبُطينين.
هذه الهيئة للقلب هي هيئته العضوية، وهي قاصرة عن الإفصاح عن “لطيفته الروحانية” بتعبير أبي حامد الغزالي في “إحياء علوم الدين” (كتاب “شرح عجائب القلب”).
وذلك لأن “القلب” عند الغزالي هو إما:
ـ ذلك “اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وهو لحم مخصوص، في باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه”. وهو موجود بهذه الهيئة عند البهائم والموتى أنفسهم، “قطعة لحم لا قدر له”، هكذا يقول الغزالي. (نفس المرجع)
ـ أو “لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، وهو المدرك العالم العارف من الإنسان”، “حقيقته متعلقة بعلوم المكاشفة” وهذه من “سر الروح” الذي لا يُفشى في الأرض (نفس المرجع).
فإلى أي حد يصيب أبو حامد الغزالي في هذا التقسيم؟ وهل لهذا “العالم القلبي الروحاني” وجود فعلي أم هو مجرد تفكير خاضع لنفس الجهاز العضوي، أي الجهاز الدموي في علاقته بالجهاز العصبي؟ ألا يمكننا الحديث عن “عالم روحاني” يحرك هذا الجهاز بدل أن يحصل العكس؟
هل من الضروري إخضاع هذه المقولات المشرقية، من قبيل “القلب” و”الروح” و”الغيب” الخ، للتفسير، أم أنها تستمد وجودها من نجاعتها في النفس المشرقية ولا تحتاج إلى إثبات علمي؟ أ لسنا هنا بصدد تعارض مرجعيتين، مرجعية غربية تخضِع العلاج للتفسير، ومرجعية مشرقية لا تشترط في نجاعة العلاج تفسيرا بالضرورة (مبدأ يشتغل به الطب الصيني وله أصل في المنطق الصوفي عند الهنود وعند المسلمين)؟
تتعدد أوجه استعمالَ القلب في “حكمة ابن القيم”، ونذكر منها ثلاثة استعمالات نظرا لأهميتها في تصور ابن قيم الجوزية:
القلب في علاقته بأصله: وهنا يتحدث ابن قيم الجوزية عن حاجة القلب للذكر حتى يخرج من “حالة القسوة”، إذ “في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى” (ابن قيم الجوزية، الوابل الصيب من الكلم الطيب، تحقيق سيد إبراهيم، دار الحديث، 1411، ص 77).
وكأنه يتحدث في هذا الاقتباس عن “قسوة أصلية” تحتاج إلى التذكير الدائم بالغيب عن طريق الذكر، ولو كانت غير أصلية لما احتاجت إلى تذكير دائم. ولو لم يكن الذكر طارئا، لما انسلخ عن القلب بتوقفه.
القلب في علاقته بالجسم: فهو بالنسبة للأعضاء ك”الملك في علاقته بجنده”. هو آمرها وناهيها، الراعي المسؤول عنها (وهي رعيته). تنعكس فيها مادته، “إذا صلح صلح سائر العمل، وإذا فسد فسد سائر العمل”. “يستعملها (الأعضاء) في ما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الإقامة والزيغ، وتتبعه في ما يعقده من العزم أو يحله” (ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، تحقيق محمد عزيز شمس، دار عالم الفوائد، ص 6).
لعل ابن القيم يبني هنا على وصف لأبي حامد الغزالي في “كيمياء السعادة”، حيث يعتبر القلب “أميرا على معسكرين: معسكر الظاهر (الأعضاء والجوارح) ومعسكر الباطن (الدماغ والخيال والتفكر والتذكر)” (أبو حامد الغزالي، كيمياء السعادة، ص 4). إن هذا المعنى لا يتنافى مع المعنى السابق، فقسوته الأصلية تورث قسوة الأعضاء والجوارح، وذكره الطارئ يورث ذكرها.
القلب في علاقته بالغيب: قانونه أن يصح بالذكر (والتذكر منه العملي، ومنه الفكري واللساني)، وأن يسقم بالهجر. لا يصح إلا إذا تعلق بالله، ولا يعرف إلا إذا انغمس واستغرق في ذات التعلق. ف”المعصية تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية، وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه (المرء) إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله” (ابن قيم الجوزية، الداء والدواء، تحقيق محمد أجمل الإصلاحي، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، 1429، ص 141). إن القلب لا يتعلق بالطارئ (الذكر) إلا ليعود إلى أصله، وكأنه يطوي أصلا (القسوة) بأصل (أصل القسوة/ أصل الأصل القلبي)، إلا أنه طي في حاجة إلى مكابدة بالذكر.
لا يتكلم ابن القيم بهذا التحليل، وإنما بخبرة إسلامية -مشرقية- لم ينتبه إليها منطق الحداثة وهو “يثبت” أصالة “الطبيعة البشرية” (قسوة القلب). إن تلك الطبيعة الأصلية ليست هي “الكل”، ليست هي “أصل الأصول”، إنها أصيلة في “الجزء” وهو “مجال الشهادة والتاريخ”.
في “سر الزهرة الذهبية: القوى الروحية وعلم النفس التحليلي” ينبه كارل غوستاف يونغ إلى الصعوبات التي يجدها الغربي وهو يحاول فهم “حكمة الشرق”. إن هذه الحكمة تتنافى مع منطقه الحداثي، وتعود به إلى عالم ربما لم يعد يتذكره. مسيحية القرون الوسطى ربما كانت أقرب إليه، إلا أن “القطيعة” طمستها أو كبلتها بقيود ما يحتاجه الرأسمال من تنميط للحياة و”إخضاعها للحساب” (عبد الله العروي، مفهوم الدولة).
إن الإنسان الغربي عندما يقرأ في “ثقافة الشرق”: “القلب هو الوعي السماوي” (سر الزهرة الذهبية) لا يستوعب معناها، أما إذا أخبِر عن تجليها الإسلامي: “القلب لطيفة روحانية” (إحياء علوم الدين) فإن بعده يصبح أكثر تأكيدا.
ورغم ذلك فإن القابلية الغربية ل”حكمة الشرق” لم تنطمس نهائيا نظرا لما يسميه ك. غوستاف يونغ “الوعي الجمعي”، حيث يشترك جميع البشر، كما يشتركون في “قوانين الطبيعة” و”قواعد التاريخ”.
لا يقتصر “الإنسان العالمي” (بتعبير إريك فروم في “مفهوم الإنسان عند ماركس”) على عالم الماديات فحسب، بل تتعلق أيضا بعالم الروحانيات حيث “تعيش” عوالم قديمة جدا، وحيث يصبح للرموز والميثات والأفهام قبل اغترابها التاريخي تأثير أكبر. “القديم الصامد في اللاوعي” (غ. يونغ)، لا يصمد في “لا وعي الشرق” فحسب، بل له في “لا وعي الغرب” صمودٌ بعيدٌ صمودَ الكنيسة (مشرقية الأصل) في عالم حرّفها وفرض قيودا مادية اجتماعية (رأسمالية) على روحانيتها.
ولا يقتصر صمود الشرق على اللاوعي فحسب، وإنما هو صمود في الوعي والممارسة أيضا، وذلك في مجال جغرافي حضاري كبير ينتظر عالما جديدا يحرره من واقع “التمركز حول الحداثة الغربية”.



