اليسار العولمي: قراءة في منطلقاته الفكرية وتناقضات مواقفه من القضايا الثقافية والقانونية والسيادية العالمية
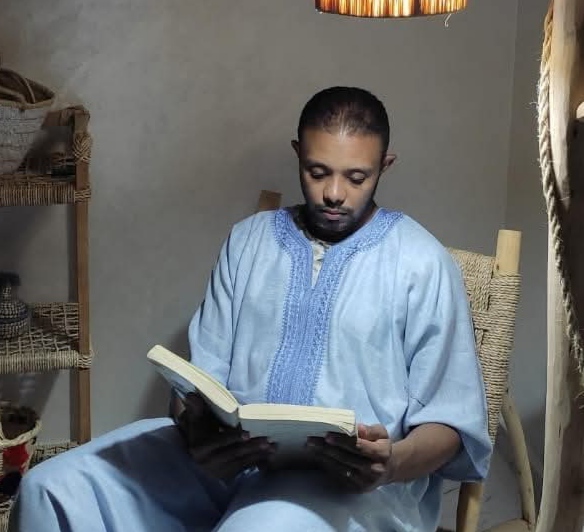
معتز فيصل ـ باحث في دراسات العولمة. الرباط
الملخّص
يهدف هذا المقال إلى تحليل التحولات الفكرية التي شهدها اليسار الغربي منذ نهاية الحرب الباردة، والوقوف عند التناقضات الجوهرية التي تميز ما يُعرف اليوم باليسار العولمي. فبينما يرفع هذا التيار شعارات مناهضة للإمبريالية، والمطالبة بالعدالة والمساواة والحقوق العالمية، فإنه في الواقع يمارس أشكالًا جديدة من الهيمنة الثقافية والسياسية باسم الإنسانية. يستند المقال إلى تحليل فلسفي وسوسيولوجي لأبرز المنطلقات الفكرية المؤثرة في اليسار العولمي (فوكو، دريدا، ماركوز، رورتي) ويقارن بين خطابه المثالي وممارساته الواقعية، ليخلص إلى أن اليسار العولمي يعاني من انفصام معرفي بين منظومته القيمية ورؤيته للعالم، ويتورط في إعادة إنتاج منطق الهيمنة الذي يدّعي مقاومته.
الكلمات المفتاحية:
اليسار العولمي – الإمبريالية الثقافية – ما بعد الحداثة – العدالة الاجتماعية – السيادة الوطنية – الفكر الغربي المعاصر
المقدمة:
شهد اليسار الغربي منذ نهاية الحرب الباردة تحوّلًا جذريًا في منطلقاته الفكرية، انتقل فيه من يسار مادي-طبقي إلى يسار ثقافي-هوياتي. هذا التحول، الذي ناقشه باحثون مثل فرانسيس فوكوياما في كتاب الهوية (2018) ومارك ليلا في The Once and Future Liberal، جعل اليسار الجديد أكثر انشغالًا بقضايا الأقليات، الجندر، و”العدالة الخطابية” بدلًا من القضايا الطبقية أو التحرر الوطني.
غير أن هذا التحول حمل في داخله تناقضًا هيكليًا: فبينما ينتقد اليسار الإمبريالية الغربية وهيمنتها، أصبح هو نفسه حاملًا لمنطق إمبريالي ثقافي جديد، يسعى لفرض معاييره الأخلاقية والسياسية على المجتمعات الأخرى باسم “الإنسانية” و”الحقوق العالمية”.
البيئة الفكرية الحاضنة لمنطق اليسار العولمي
تقوم فلسفة هذا اليسار على ثلاث ركائز فكرية رئيسة:
1. تحويل الصراع من طبقي إلى هويّاتي
لم تعد العدالة تُقاس بالمساواة الاقتصادية بين الطبقات كما عند ماركس، بل بتحقيق المساواة بين الهويات المختلفة: الجنسانية، العرقية، الجندرية، والثقافية.يتغذى هذا التيار العولمي من بيئة فكرية ما بعد حداثية، حيث تفككت المعايير الكبرى للحقيقة والهوية والسيادة. تعتبر كتابات فوكو، وجوديث بتلر، وإرنستو لاكلو، وشانتال موف دي وغيرها من الحواضن الفكرية له ؛ حيث تحولت السلطة عند هذه النخبة إلى شبكة رمزية تحاصر الجسد والمعنى، وصارت المقاومة فعلاً لغويًا أكثر من كونها ثورة مادية.
2. النزعة الأخلاقية الكونية (Moral Universalism)
يتعامل هذا اليسار مع قيم مثل حقوق الإنسان، وحماية البيئة، والمساواة الجندرية بوصفها مبادئ مطلقة تتجاوز الدول والثقافات، ما يجعل خطابه امتدادًا ناعمًا للإمبريالية الثقافية. فحين يُطالب مجتمع إفريقي أو عربي باحترام منظومة قيم مستوردة من الغرب، فإننا نكون أمام تغليفٍ إنساني للهيمنة الحضارية.
3. الارتهان لمؤسسات العولمة
على عكس اليسار الثوري القديم الذي كان يرى في البنك الدولي وصندوق النقد أدواتٍ للهيمنة، أصبح اليسار العولمي يرى فيها شركاء لإحداث “إصلاح إنساني” في النظام الاقتصادي العالمي. وهنا يظهر التناقض الأساسي: إنه يسار يعمل من داخل النظام الذي يفترض أنه يريد إسقاطه.إستمد هذا التيار العولمي المرتكزات الفلسفية أعلاه من مجموعة متنوعة من فلاسفة ما بعد الحداثة . يظهر في هذه القائمة بعض التمظهرات العملية لهذه الأفكار في المضمارين الثقافي والسياسي العالميين :
ميشيل فوكو: جعل السلطة والمعرفة متلازمتين، فصار كل خطاب يُرى كأداة قمع. تبنّى اليسار العولمي فكرته ليُدين الدولة الوطنية بوصفها “أداة سلطة” ضد الأقليات.
جاك دريدا: بتفكيكه للثنائيات (الهوية/الآخر، السيادة/الحرية) فتح الباب أمام إنكار أي مركز للحقيقة أو للسيادة.
هربرت ماركوز من مدرسة فرانكفورت، دعا إلى “تحرر الأقليات المكبوتة” حتى لو خارج الأطر الديمقراطية التقليدية.
ريتشارد رورتي: ربط الأخلاق بالاعتراف الاجتماعي لا بالمبادئ الثابتة، فصار الموقف السياسي اليساري يتحدد بمقدار “التعاطف” لا بمقدار “المنطق”.
نتيجة لذلك، أصبح اليسار العولمي يعتمد على أخلاقية عاطفية لا عقلانية، تستند إلى “الشفقة” لا إلى “العدالة المنهجية”، ما جعله يقع في تناقضات مستمرة.
نناقش هنا ثلاث تناقضات من أشهر التناقضات الجوهرية في اليسار العولمي المعاصر:
التناقض الأول/
التناقض بين معاداة الإمبريالية ورفض تفككها
يعلن اليسار العولمي عداءه للإمبريالية الأمريكية، لكنه سرعان ما يدافع عن النظام الدولي الذي أنتجته واشنطن حين يواجه تحديًا حقيقيًا.
فعندما صعد دونالد ترامب إلى السلطة للمرة الثانية يناير ٢٠٢٥ ، وبدأ بسياسات انعزالية تهدف إلى تقليص الدور الأمريكي الخارجي، اعتبر كثير من اليساريين ذلك تهديدًا لـ”الاستقرار العالمي”، رغم أن هذه السياسات مثلت، في جوهرها، ما كان اليسار يحلم به: تفكيك الهيمنة الأمريكية.
هذا التناقض يعكس ما وصفه سلافوي جيجك بـ”نفاق الليبرالية اليسارية” التي ترفض الإمبريالية خطابًا لكنها تحتاجها عمليًا لتثبيت نظام العولمة الذي يمنحها شرعية خطابها الإنساني الكوني.
التناقض الثاني/
التناقض في قضايا السيادة والهوية الوطنية
يبرز التناقض الفكري لليسار العولمي في مواقفه من القضايا السيادية. ففي الوقت الذي يدافع فيه عن وحدة الدول الغربية ويرفض انفصال أقاليم مثل كاتالونيا (إسبانيا)، كورسيكا (فرنسا)، أو اسكتلندا (بريطانيا)، يدعم بقوة مشاريع الانفصال في دول الجنوب.
فعلى سبيل المثال، يتعامل اليسار مع قضية الصحراء المغربية بوصفها “قضية تصفية استعمار”، متجاهلًا الارتباط التاريخي والسياسي العميق بين الإقليم والمملكة المغربية قبل الاستعمار الإسباني. وفي تركيا والعراق، ينظر إلى المسألة الكردية كقضية تحرر وطني، دون إدراك لتداعياتها على استقرار المنطقة ووحدة شعوبها.
هذا الموقف يعكس منطلقًا فكريًا ساذجًا يقوم على ثنائية الضحية/الجلاد، ويتغافل عن حقائق التاريخ والجغرافيا والسياسة. إنه ما يمكن تسميته بـ “الاستشراق المقلوب” الذي أشار إليه إدوارد سعيد (1978): إعادة إنتاج المركزية الغربية في ثوب إنساني مزيف، حيث يتم التعامل مع دول الجنوب كحقول تجريبية للمثالية الغربية.
التناقض الثالث/
الفلسفة القانونية وراء رفض الإعدام ومعاقبة المجرمين
يرى اليسار العولمي أن الجريمة ليست فعلًا إراديًا بل نتاجًا للظروف الاجتماعية، وهو ما يتقاطع مع النظرية الماركسية في فهم الانحراف. فوكو في كتابه المراقبة والمعاقبة (Foucault, 1975) اعتبر العقوبات أداة “لإعادة إنتاج السلطة”، وليست وسيلة لتحقيق العدالة.
أما مارثا نوسباوم وجوديث بتلر فترى كلتاهما أن العدالة الحقة هي في “إعادة الدمج الاجتماعي” لا في العقوبة (Nussbaum, 2010; Butler, 2004).
لكن هذه الرؤية تتجاهل ما أكده إيمانويل كانط في أسس ميتافيزيقا الأخلاق، حين قال إن العدالة لا تتحقق إلا إذا نال المجرم جزاءً يعادل فعله، لأن الامتناع عن القصاص ينتهك كرامة الإنسان بوصفه كائنًا حرًا مسؤولًا (Kant, 1785).
بتأثير بتلر، بدأ اليسار العولمي ينظر إلى العدالة كمسألة “تعاطف”، لا كمسألة “مسؤولية”.
فعوض أن يُنظر إلى المجرم كفاعل أخلاقي حر يتحمّل تبعات فعله (كما في فلسفة كانط أو هابرماس)، يُعاد تعريفه كـ”ضحية ظروف اجتماعية” أو كـ”منتج لبنية سلطوية”.
في هذا الإطار، يصبح الإعدام، أو حتى السجن الطويل، ليس عدالة بل “إعادة إنتاج للعنف”، وفق منطق بتلر في Frames of War (2009).
هذه الرؤية جذّابة أخلاقيًا، لكنها قصيرة النظر فلسفيًا، لأنها تفرغ العدالة من بعدها المعياري والعقلاني. فهي، كما يصفها الفيلسوف الفرنسي آلان فنكلكروت (2013)، تنتمي إلى “الإنسانوية العاطفية” التي تستبدل التفكير الأخلاقي بالشفقة الإنسانية، مما يجعلها عاجزة عن مواجهة الشر أو المسؤولية الأخلاقية الفردية.
لماذا يُعد فكر بتلر قصير النظر؟
1. إلغاء المسؤولية الأخلاقية:
بتقليلها من دور الإرادة الحرة، تُفرغ بتلر الفعل الإجرامي أو السياسي من بعده الأخلاقي، مما يجعل الردع والقصاص بلا معنى.
2. إنكار السيادة القانونية:
لأنها ترى في الدولة دائمًا أداة قمع، لا يمكن أن تُفهم العدالة كجزء من مشروع وطني جامع.
3. تغليب العاطفة على المعيار:
العدالة عندها تستند إلى الشفقة، لا إلى الواجب، وهو ما يتعارض مع تقاليد الفلسفة الأخلاقية من أرسطو إلى كانط.



