السلفية الجهادية وأزمة تراجع المواكبة البحثية
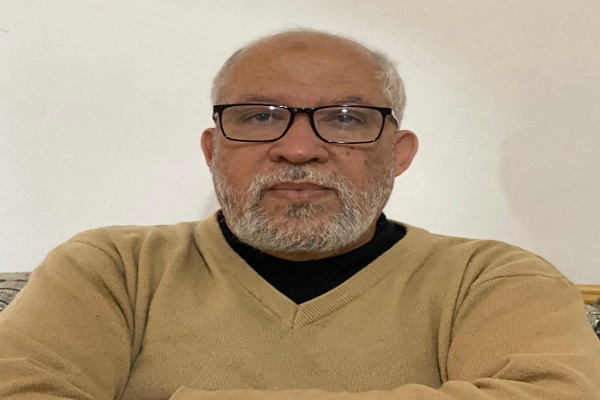
عبد الفتاح الحيداوي
شهدت الساحة الفكرية والبحثية خلال العقود الماضية اهتمامًا بالغًا بظاهرة السلفية الجهادية، تجلى في كمٍّ هائل من الدراسات والندوات والكتب التي سعت إلى مقاربة هذه الظاهرة من زوايا متعددة؛ فمنها من ركز على الجذور العقدية والفكرية، من خلال تحليل البنية المفاهيمية لهذا التيار، كمسألة التوحيد، والتكفير، والجهاد، والحكم على المجتمعات، ومنها من اهتم بالسياقات السياسية والاجتماعية التي أسهمت في بروز التيارات الجهادية، كالاستبداد السياسي، والتدخلات الخارجية، والحروب الأهلية، والهامشية الاقتصادية والاجتماعية. غير أن المتتبع للمشهد البحثي المعاصر يلاحظ تراجعًا ملحوظًا في تناول هذه الظاهرة، سواء من حيث الكم، عبر قلة الإنتاج البحثي الجديد، أو من حيث العمق، حيث تعاني الكثير من الدراسات المعاصرة من التكرار وضعف التحليل النظري. ويزداد هذا التراجع وضوحًا بعد الانحسار الميداني لبعض التنظيمات الجهادية كتنظيم الدولة (داعش)، مما دفع العديد من الباحثين إلى توجيه اهتمامهم نحو قضايا أخرى مستجدة. ومع ذلك، فإن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة انحسار الظاهرة من الواقع، بقدر ما يكشف عن حاجة ملحة إلى تجديد أدوات التحليل وتوسيع زوايا المقاربة، كاستثمار مناهج علم النفس الاجتماعي، أو دراسة تأثير الوسائط الرقمية في إعادة تشكيل الخطاب الجهادي. إن استمرار الغياب النقدي والتحليلي عن هذا الموضوع قد يترك فراغًا معرفيًا.
أولًا: التحول من التفكيك إلى التبسيط
شهدت الظاهرة السلفية الجهادية اهتمامًا متزايدًا من قِبَل الدارسين والباحثين، نظرًا لما تمثله من إشكال معرفي ومجتمعي معقّد. وقد اتسمت الدراسات الجادة في مراحل سابقة بمحاولة تفكيك بنية هذا الخطاب من الداخل، عبر الاشتغال على نصوصه المرجعية، وتحليل آلياته التأويلية، وتتبع طرائقه في بناء الحجاج الشرعي، فضلًا عن دراسة رموزه ورصد تطوره التاريخي ضمن سياقاته الفكرية والسياسية.
ومن بين هذه الدراسات يمكن الإشارة إلى أعمال أبو مصعب السوري في كتابه دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، الذي يمثل وثيقة مركزية لفهم التنظير الجهادي المعاصر، بما يحتويه من تأصيلات فقهية واستراتيجية وتاريخية. كما اشتغل بعض الباحثين مثل جيل كيبل (Gilles Kepel) وحسن هنية وابو رمان وأوليفييه روا (Olivier Roy) على تحليل البعد الفكري للتيار الجهادي، مركزين على تطور الخطاب السلفي في علاقته بالواقع السياسي والاجتماعي في العالم الإسلامي.
غير أن أغلب الكتابات المعاصرة اتجهت نحو مقاربة أمنية صرفة، تنظر إلى الظاهرة من زاوية خارجية، فتركّز بالأساس على البعد العنيف والممارسات الميدانية، دون مساءلة البنية المعرفية التي يستند إليها الخطاب، أو تحليل منطلقاته النظرية والمنهجية. ويتجلى هذا التوجه في كثير من التقارير الصادرة عن مراكز الدراسات الأمنية، مثل تقارير معهد بروكينغز (Brookings) أو راند (RAND Corporation)، التي تركّز في الغالب على البنية التنظيمية للجماعات، وتطور استراتيجياتها العسكرية، والتهديدات الأمنية الناتجة عنها، مع إهمال شبه تام للجانب التأويلي والمعرفي الذي يشكل ركيزة لشرعنة عملياتها داخل هذه الجماعات.
هذا التحوّل في زاوية المعالجة أفضى إلى نوع من التبسيط في فهم الظاهرة، حيث تم اختزالها في أبعادها العملياتية، في مقابل إغفال العوامل الفكرية التي تُعدّ جزءًا أصيلاً في بنية هذا التيار. ومن هنا تبرز الحاجة إلى مقاربات معرفية أكثر عمقًا، تستند إلى تحليل داخلي للخطاب الجهادي، بغرض فهم منطق اشتغاله، والآليات التي يستخدمها في إنتاج المعنى، وتبرير العنف باسم الدين، وهو ما يمكن أن يشكّل مدخلًا لتفكيك الظاهرة بطريقة علمية وفعالة.
ثانيًا: غياب المراكز المتخصصة وتراجع الاهتمام الأكاديمي
شهدت بداية الألفية الثالثة طفرة ملحوظة في تأسيس مراكز بحثية متخصصة في دراسة الحركات الإسلامية عمومًا، والسلفية الجهادية خصوصًا، وذلك بالتزامن مع تصاعد التهديدات الأمنية المرتبطة بهذه الظاهرة، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. ومن أبرز هذه المراكز، مركز “مشروع مكافحة الإرهاب” في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت (CTC at West Point)، والذي قدّم دراسات نوعية عن تنظيم القاعدة والشبكات المرتبطة به، كما أن “المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي” (ICSR) في كينغز كوليدج لندن، لعب دورًا بارزًا في تحليل الظاهرة الجهادية في أوروبا. غير أن كثيرًا من هذه المراكز إما أُغلق أو أعاد توجيه اهتمامه نحو التحليل السياسي والأمني على حساب المقاربة المعرفية النقدية. على سبيل المثال، تحوّل “معهد راند” (RAND Corporation) في الولايات المتحدة من إنتاج أوراق تحليلية ذات طابع أكاديمي إلى تقارير موجهة لصنّاع القرار، وهو ما انعكس على نوعية الخطاب والتحليل المُقدَّم.
في السياق العربي، ظهرت بعض المبادرات الأكاديمية التي حاولت التأسيس لبحث معمق في الظاهرة الجهادية، مثل “مركز المسبار للدراسات والبحوث” في دبي، الذي خصّص سلسلة من الإصدارات لتحليل الظاهرة السلفية الجهادية في مناطق متعددة من العالم الإسلامي، غير أن نشاطه شهد تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لأسباب يُرجّح أنها تتعلق بالتغيّرات الإقليمية والحسابات السياسية.
تُظهر هذه الأمثلة كيف أن التحولات السياسية والأمنية أثّرت بعمق على البنية المعرفية لدراسة الظاهرة الجهادية، حيث باتت تخضع لرقابة ضمنية أو صريحة، ما أسهم في تحويل كثير من مراكز البحث من فضاءات معرفية نقدية إلى أدوات تحليل سياسي وأمني..
ثالثًا: القراءة الأمنية بوصفها عائقًا معرفيًا
القراءة الأمنية، على الرغم من أهميتها في بعض السياقات، تظل جزءًا من منظومة القراءات الممكنة وليست مجملها، خاصةً أنها تتعامل مع الجماعات الجهادية بوصفها تهديدًا أمنيًا يستوجب الاحتواء أو التصفية، لا بوصفها منتوجًا فكريًا مركبًا، ينبني على منطق داخلي وخطاب متماسك ضمن شروطه المرجعية والتاريخية. يتجلى هذا المنظور الأمني في العديد من التقارير الصادرة عن مراكز البحث الغربية، مثل تقارير RAND Corporation أو Carnegie Endowment for International Peace، التي غالبًا ما تركز على البنية التنظيمية والتمويل والعمليات، دون التوقف عند الأنساق الفكرية والتأويلية المؤسسة لهذا الخطاب. ومثال ذلك، القراءة الأمنية التي سادت عقب أحداث 11 سبتمبر، حيث تم اختزال الظاهرة الجهادية في شخصيات مثل أسامة بن لادن أو أيمن الظواهري، في حين أُغفل البعد الإيديولوجي الممتد لجذور سلفية جهادية تعود إلى مفكرين أمثال سيد قطب وعبد الله عزام، والذين أسسوا لبنية خطابية تنهل من التراث الإسلامي وتعيد تأويله ضمن منطق الصراع الكوني بين “الحق والباطل”.
من هذا المنظور، فإن الاقتصار على المقاربة الأمنية يُقصي الأبعاد الإيديولوجية والتأويلية التي تسهم في إنتاج الخطاب الجهادي، وتُغيب الأسئلة المعقدة المرتبطة بمفاهيم مثل “الطاغوت”، “الولاء والبراء”، و”الحاكمية”، وهي مفاهيم تحتاج إلى مقاربة معرفية تأويلية قادرة على تفكيك البنية الرمزية لهذا الخطاب، بدلًا من التعامل معه بوصفه مجرد تهديد عسكري أو أمني. وقد نبّه بعض الباحثين، مثل جيل كيبيل (Gilles Kepel) وأوليفييه روا (Olivier Roy)، إلى ضرورة تجاوز المقاربة الأمنية البحتة نحو مقاربة تحليلية تُعنى بفهم المنطلقات الفكرية والظروف الاجتماعية والسياسية التي تسهم في تشكل الظاهرة الجهادية.
رابعًا: الحاجة إلى دراسات “من الداخل”
إن أي محاولة جادة لفهم الظاهرة الجهادية ينبغي أن تنطلق من مساءلة منطقها الداخلي، لا من اختزالها في بعدها الأمني أو الاستخباراتي فحسب. ما الذي يجعل الجهادي يبرر فعله بوصفه عملاً مشروعًا بل وواجبًا دينيًا؟ ما هي مصادر الشرعية التي يستند إليها؟ كيف يُنتج النص، ويعيد تأويله، ويؤسّس له سلطته الرمزية؟ وما العلاقة التي تربط بين التراث السلفي الكلاسيكي، كما في نصوص ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب، وبين التأويل الجهادي الحديث في فكر منظّرين مثل أبي محمد المقدسي، وأبي قتادة الفلسطيني، أو أبي بكر الناجي مؤلف “إدارة التوحش”؟
إن هذه الأسئلة لا يمكن التعامل معها إلا بأدوات تحليل معرفية ومقاربات أنثروبولوجية وسوسيولوجية ونصية، تأخذ بعين الاعتبار البنية الخطابية الداخلية للجماعات الجهادية، ومرجعياتها النصوصية، وآليات التأويل التي تعتمدها. وقد ظهرت في هذا السياق دراسات مهمة تُمثّل ما يمكن تسميته بـ”القراءة من الداخل”، مثل كتاب “القافلة” للباحث توماس هيغهامر (Thomas Hegghammer)، وكتاب “السلفية الجهادية تاريخ فكرة الكاتب شيراز ماهر، بالإضافة إلى كتاب “دراسات في السلفية الجهادية” اكرم حجازي ، الذي يُعدّ من أهم النصوص التأسيسية لفهم المرجعية الداخلية لهذا التيار.أيضا كتاب السلفية العالمية لرول ميير.
كما أن بعض الباحثين اشتغلوا على هذه الأسئلة الحساسة، مثل أطروحة محمد مصباح الجهاديون المغاربة: جدل المحلي والعالمي او كتاب الباحث منتصر حمادة في نقد تنظيم “القاعدة وهو قراءة نقدية لما صدر من كتب عن تنظيم القاعدة.
، أو أطروحة الباحث الفرنسي François Burgat المعنونة بـفهم الاسلام السياسي Understanding Political Islam، والتي تحاول فهم الظاهرة الإسلامية – بما فيها الجهادية – من داخل منطقها الخاص، لا من خلال إسقاطات أيديولوجية خارجية.
إن المقاربة التفكيكية ذات الطابع الاستخباراتي، وإن كانت ضرورية في سياقات معينة، إلا أنها تبقى عاجزة عن تفكيك العمق التأويلي والرمزي لهذه الظاهرة، مما يستدعي تطوير دراسات معرفية تعتمد على تحليل الخطاب، واللسانيات، وعلوم التأويل، في مقاربة هذه النصوص الجهادية المعاصرة.
إن العودة الجادة إلى دراسة الظاهرة السلفية الجهادية ليست ترفًا فكريًا يُمارسه الباحثون من باب الفضول أو السعي وراء الجديد، بل هي ضرورة ملحة يفرضها الواقع المعاصر، لفهم أحد أكثر التيارات تأثيرًا وتشعبًا في العالم الإسلامي. فقد أصبحت هذه الظاهرة تمثل تحديًا فكريًا وسياسيًا وأمنيًا على مستوى عالمي، ما يجعل فهمها وتحليلها بشكل علمي من أولويات البحث الأكاديمي في العصر الراهن. فهذه الظاهرة ليست مجرد حدث عابر أو موقف معزول، بل هي تيار فكري معقد أفرزته جملة من العوامل التاريخية والدينية والسياسية، وما زال ينشط ويؤثر بشكل كبير في مختلف المجالات.
لكن الفهم هنا لا يعني التبرير أو التبني لهذا الفكر ، بل يهدف إلى دراسة وتفكيك هذا التيار من خلال أدوات علمية موضوعية ونقدية، تركز على تحليل جذوره الفكرية والشرعية، بعيدًا عن الأحكام المسبقة. إذ إن الهدف ليس إضفاء شرعية على هذه الظاهرة، بل فحص بنائها العقلي والنفسي والاجتماعي عن كثب. فالظاهرة السلفية الجهادية ليست مجرد ردود فعل على التحديات المعاصرة أو السياقات السياسية فقط، بل هي نتيجة لتفاعل معقد بين مجموعة من العوامل النصية والتاريخية واللغوية، التي شكلت عقيدتها ورؤيتها للعالم.
إن الفكر لا يُهزم إلا بفكر أقوى منه. وهنا يكمن التحدي: كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة الفكرية من خلال أدوات فكرية أكثر قدرة على التفكيك والنقد؟ إن الفكر السلفي الجهادي لا يمكن أن يُهزم بخطابات أمنية أو سياسات قمعية، لأنها تبقى بعيدة عن معالجة الجذور الفكرية التي تغذي هذه الظاهرة. فالحلول الأمنية، على الرغم من أهميتها في التصدي للأنشطة الإرهابية، تظل عاجزة عن الوصول إلى منبع الفكر الجهادي. لذلك، يجب أن يكون الخطاب البديل عقلانيًا ونقديًا، يعتمد على المنهج العلمي الذي يعالج الأفكار ويُحلل الأيديولوجيات، لا أن يكتفي بمحاصرة الظاهرة من الخارج.
وفي هذا السياق، تأتي أهمية البحث في تفكيك بنية الفكر السلفي الجهادي من الداخل، من خلال النظر في النصوص المؤسسة له، والأطر الفكرية التي يبنى عليها، والسياقات التي أنتجت هذا الفكر. فتفكيك هذه البنية يتطلب دراسة النصوص الدينية التي يحتكم إليها السلفيون الجهاديون، وفحص كيفية تفسيرها واستخدامها في تبرير العنف والجهاد، مع مراعاة السياقات السياسية والاجتماعية التي أدت إلى تفعيل هذه التفسيرات. كما أن نقد هذا الفكر يجب أن يكون مستندًا إلى رؤية عقلانية تجسد تفاعلًا نقديًا مع النصوص والواقع في آن واحد، مع الاعتراف بأن الفكر لا يمكن تغييره إلا من خلال الفكر، وأن الاجتهاد الفكري هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا التغيير.



