الدراسات القرآنية بين القديم والحديث: الدراسات المعاصرة نموذجا
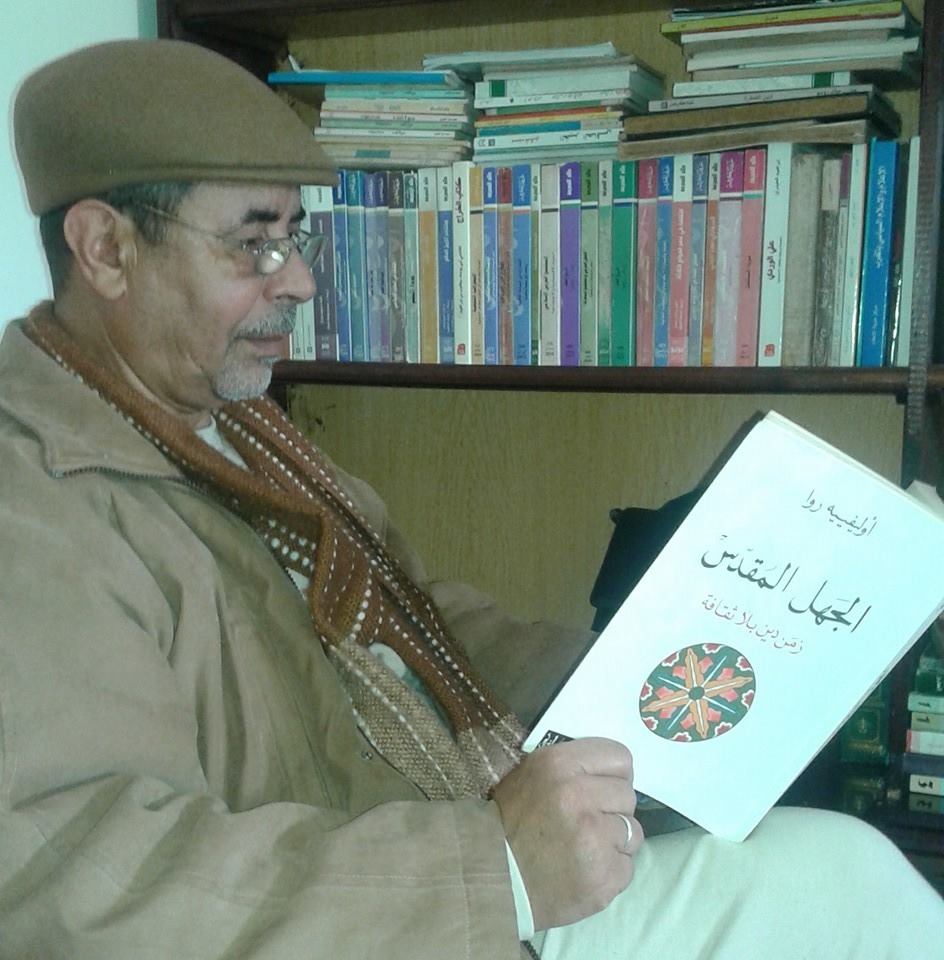
محمد أومليل
تحدثنا سلفا عن خمسة فصول:
1 محورية القرآن
2 موانع الفهم والاستمساك
3 الدراسات القرآنية القديمة
4 الدراسات القرآنية الجديدة
5 الدراسات القرآنية الحديثة.
منحنا لكل مرحلة من المراحل الثلاث (القديمة، الجديدة، الحديثة) خمسة قرون نرصد في كل مرحلة أفضل ما أنجز فيها من دراسات قرآنية.
قصدي من التذكير بما تقدم سرده؛ الربط بين الفصول، السابقة واللاحقة، بغية فهم مسار البحث من حيث سيرورته وصيرورته ومدخلاته ومخرجاته؟
“الدراسات المعاصرة” نقصد بها تاريخيا الألفية الثالثة وما أنجز في الفترة الراهنة شريطة أن يكون معاصرا موازيا للسقف المعرفي الراهن وللمستجدات المعرفية والعلمية والمنهجية لعصرنا الحالي، أو متجاوز كل ما تقدم ذكره..
ليس كل ما أنجز من دراسات قرآنية في عصرنا الحالي هي دراسة معاصرة بالضرورة؛ وجب التمييز بين العصرية والمعاصرة.
كل معاصر عصري، وليس كل عصري معاصرا بالضرورة.
قام بتوضيح ذلك العلامة علال الفاسي، رحمه الله، بشيء من التفصيل في كتابه القيم: (النقد الذاتي) نشر سنة 1950. ضمن الكتاب فقرة تحت عنوان: “الفكر بين العصرية والمعاصرة”، ورد فيها ما يلي:
” إن أساس الغلط عند الناس هو أنهم يخلطون بين العصرية وبين المعاصرة، أو بين ما هو عصري وبين ما هو معاصر، مع أن الثاني قد يكون مثالا حيا لما مر في الأزمنة الوسطى أو البدائية للتاريخ، كما أن الأول يمكن أن لا تجد له وجودا في العهد الذي نعيش فيه، بينما نعثر عليه في زوايا الفكر البشري العتيق “(1).
فعلا، هناك من يعيش بيننا في الألفية الثالثة بعقلية القرون الوسطى وبأفكار أكل عليها الدهر وشرب وتم تجاوزها حيث أصبح ضررها أكثر من نفعها وتم تعويضها بأفكار تتسم بالجدة والجدوى والفاعلية وأكثر نفعا من سابقتها بحيث لا مجال للمقارنة.
على سبيل المثال؛ ما ورد من آراء ضمن كتاب (الإتقان في علوم القرآن) معاصرة لزمننا وجد صادمة للكثير ممن يعيشون في عصرنا الحالي؛ وكأن السيوطي معاصر لنا، والمصابون بالصدمة تجاه آرائه يعيشون في زوايا الفكر البشري العتيق!
كتاب (الإتقان) يعد مرجعا أساسيا لكل دارس للقرآن بما في ذلك المستشرقون القدماء والجدد والعلمانيون والحداثيون والإسلامويون!
وليس السيوطي وحده من يعاصرنا بآرائه، بل أمثاله كثر في عدة علوم، ابن خلدون في مقدمته الشهيرة، مثلا، شهد له بعض أكابر الفكر المعاصر بأن بعض آرائه ما زالت معاصرة لنا، من ضمنهم: السوسيولوجي علي الوردي، والمؤرخ عبد الله العروي، والفيلسوف محمد عابد الجابري؛ كلهم اشتغلوا على فكر ابن خلدون.
الكثير من الأفكار سرقت من قبل الغرب عن المتقدمين من علماء مسلمين بين اللاحق والسابق عدة قرون؛ أبو حامد الغزال/دفيد هيون، ابن تيمية/فرنسيس بيكون، ابن خلدون/أوغست كونت..، ما تم ذكره على سبيل المثال لا الحصر.
يقول علال الفاسي في هذا الصدد: “ومتى رجعنا إلى التاريخ الإسلامي عثرنا على نماذج راقية مضى عليها اثنى عشر قرنا ونيف، بينما هي في هذا الوقت لا توجد إلا في دائرة المثل العليا التي يكافح من أجلها الناس دون أن يدركوها “(2)، ويقصد عدل عمر بن الخطاب إبان حكمه في الخلافة الثانية بعد خلافة أبي بكر الصديق.
هذا ينطبق على بعض المتقدمين من أهل العلم والفكر، وفي المقابل هناك من المتأخرين ممن يعيشون في الألفية الثالثة بسقف معرفي يفوق السقف المعرفي للزمن الراهن وللعقل الجمعي؛ هؤلاء منحهم الله السبق المعرفي يعلمون ما ليس عند أغلبية الناس؛ هؤلاء مجددون يسبقون زمنهم بسنوات ضوئية، أفكارهم بمثابة نواة تحتاج إلى زمن طويل لكي تنمو وتنضج وتكون قابلة للهضم!
إذن الشرط في “الدراسات القرآنية المعاصرة”؛ أن تتضمن الدراسة آراء جديدة وصادمة ومستفزة معرفيا ومثيرة للجدل والنقاش، مما يفيد أن التاريخ الراهن للدراسة ليس شرطا للمعاصرة، بل الشرط في جدوى المحتوى.
عموما العبرة ليست مرتبطة بزمن معين قديما كان أو حديثا، بل العبرة بالمحتوى والجدوى.
“فلقد انقسم المجتمع إلى فريقين: واحد يرى أن كل ما فعله القدماء أو فكروا فيه هو الصحيح الذي يجب أن يشايع، ولذلك فهو يفقد ثقته في كل ما لم تأت به الأوائل أو لم يجده في تقاليد الوسط الذي نشأ فيه. وآخرون طغت عليهم رغبتهم في الجدة والابتكار، فأصبحوا يؤمنون بأن كل ما نقل من الماضي يجب أن ينقرض.. والحقيقة أن عند الفريقين خطأ شنيعا في نقطة البداية للتفكير، ذلك أن المحافظة لا تعني أبدا أن لا يفعل الإنسان إلا ما كان عتيقا باليا، كما أن العصرية لا تعني دائما أن ينبذ المرء كل ما لم يكن جديد الوضع أو حديث الابتكار “(3).
علال الفاسي، نفسه، له آراء، وردت في الكتاب، الذي اعتمدناه، ما تزال تكتسي الجدة ومعاصرة لنا، وبعضها جد صادمة مستعصية على الاستيعاب والقبول بها بالنسبة للكثير من الناس عامة ونخبة!
لدى السوسيولوجي علي الوردي رأي حول المحافظين والمجددين في غاية الأهمية، مفاده: أن المجتمع في أمس الحاجة للفريقين لتحقيق التوازن من خلال التدافع الاجتماعي؛ فدور المحافظين الحفاظ على سلامة المجتمع من الانحلال والانفلات عن هوية المجتمع ومعتقداته وقيمه حتى لا ينجر وراء المجددين بالمطلق، ودور المجددين؛ تحريك المجتمع وتخليصه من الجمود والركود والتقليد والتكرار والاجترار والدفع به نحو التقدم!
يعبر عن ذلك بلفظه: “فهناك جماعة المحافظين الذين يريدون إبقاء كل قديم على قدمه وهم يؤمنون أن ليس في الإمكان أبدع مما كان. ونجد إزاء هذه الجماعة جماعة أخرى معاكسة لها هي تلك التي تدعو إلى التغيير والتجديد وتؤمن أنها تستطيع أن تأتي بما لم يأت به الأوائل.
من الضروري وجود هاتين الجماعتين في كل مجتمع، فالمجددون يسبقون الزمن ويهيئون المجتمع له، وخلو المجتمع منهم قد يؤدي إلى انهياره تحت وطأة الظروف المستجدة. أما المحافظون فدأبهم تجميد المجتمع، وهم بذلك يؤدون للمجتمع خدمة كبرى من حيث لا يشعرون، إنهم حماة الأمن والنظام العام، لولاهم لانهار المجتمع تحت وطأة الضربات التي يكيلها له المجددون الثائرون “(4).
رؤية موضوعية بمعزل عن أي تحيز أيديولوجي.
عموما الباحث عن الحكمة يرصدها وينهلها من كل مصادر المعرفة قديمة كانت أو حديثة دون استثناء؛ يفتل كل ذلك في حبل ينفع به نفسه والعباد والبلاد بحكم نزعته الكونية!
رحم الله كل من علمنا علما صائبا، وغفر الله لكل من علمنا علما خاطئا.
المراجع:
-2،1، علال الفاسي، النقد الذاتي، ص 80.
-3، م س، ص 79.
-4، علي الوردي، مهزلة العقل البشري، ص 149.



