إشارات في قراءة السيرة النبوية (8)
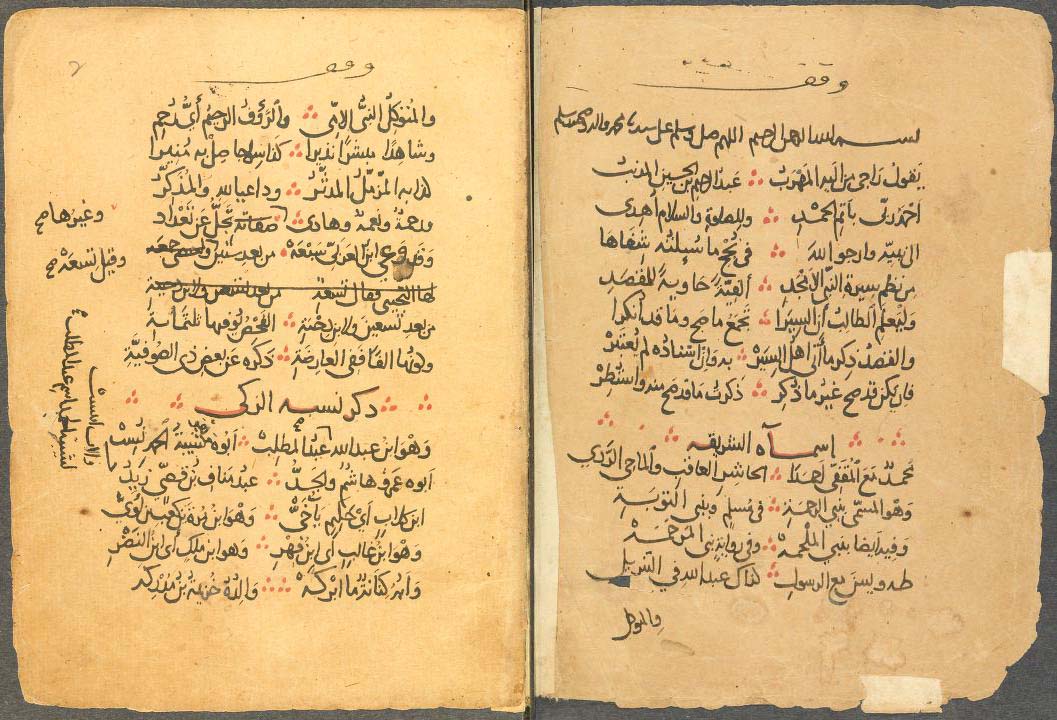
محمد زاوي
يرى عبد السلام الموذن في دراسته “النبي محمد والدولة القومية العربية” أنه لولا مجيء محمد (ص) والإسلام لعرف العالم تاريخا غير الذي نعرفه الآن. ومعروفة مرجعية الموذن الماركسية، ما يضفي على قوله حجة تاريخية وموضوعية ملموسة تشهد بأهمية “البعثة النبوية” لا في تاريخ العرب فحسب، بل في تاريخ العالم ككل.
ط
فقد استطاع النبي محمد (ص) بعبقرياته الإيديولوجية والسياسية والعسكرية توحيد القبائل العربية متعددة الآلهة (الأصنام) في دولة واحدة بسطت نفوذها في كامل المنطقة العربية ثم توسعت لتبلغ جغرافيات بعيدة (الأندلس، الصين، الهند، إفريقيا).
في نظر ع. الموذن، فإن شبه الجزيرة العربية بقبائلها المشتتة كانت منفتحة على أربعة احتمالات: التحالف مع الفرس أو الروم، الانهزام أمامهما، الدوران في حلقة مفرغة، التوحيد وتأسيس دولة. وهذا الاحتمال الأخير هو الذي عرفته المنطقة العربية بقيادة النبي محمد (ص).
هل يدل كلام ع. الموذن على إعجاز في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مرجعيته المادية التاريخية ترفض ذلك، ولكنه سؤال مشروع حول سيرة غير مسبوقة في سير الأنبياء.
***
يرى بندلي الجوزي في كتابه “من تاريخ الحركات في الفكرية في الإسلام” أن الإسلام بدأ ثائرا على الظلم الاجتماعي قبل أن تتحول سيرته على يد خلفاء بني أمية إلى سيرة جبر وتفاوت بين الناس. فقد بُعث الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينة تجارية هي مكة، أهلها “انكبوا على التجارة حتى ألهتهم عن غيرها من الأشغال” (بندلي الجوزي، من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام، تحقيق محمود إسماعيل، دار رؤية، الطبعة الأولى، 2006، ص 40)، فراكموا ثرواتهم بغير حق من ربا واستعباد والظلم.
وحيثما كان التفاوت انقسم المجتمع إلى طبقات، يقول الجوزي: “كل ذلك أدى إلى وجود طبقتين غير متناسبتي العدة والعدد: طبقة المثرين وأصحاب البنوك وسدنة الكعبة وأصحاب السلطة أو طبقة الأرستوقراطية أو الملأ أو الأعزاء… وطبقة الصعاليك والفقهاء والأرقاء أو الأراذل ومن كانت تتوقف حياته وسعادته على إرادة أصحاب اليسار” (ص 47). وقد كان أفراد هذه الطبقة الثانية يعيشون في ظل النظام المكي واقعا مزريا “لا يملكون فيه شيئا حتى أنفسهم”، كما كانوا “معارضين فيه للأخطار واليأس والعذاب والذل الاجتماعي والرق الأبدي”، “يعيشون في شعاب البلدة وأطرافها البعيدة في بيوت حقيرة قذرة وعيشة ضنكة وجوع مستمر” (ص 48).
كل هذا تمهيد ليقول الجوزي إن “النبي محمدا بُعث من أجل هذه الفئة، ومن أجل تخفيف التفاوت بين الناس. وإذا تساءل القارئ عن أصول الوعي الاجتماعي عند هذا النبي العربي فإن الجوزي يبرر وعي محمد (ص) ب”معرفته للوسط الاجتماعي الذي ولِد وعاش فيه قبل الدعوة نحو عشرين سنة” (ص 51). فقد انتبه إلى تفاوت مجتمعه في عائلته وهو يرى الفرق الشاسع بين حاله وملكية أعمامه، وفي تجارة خديجة عندما كان يقف على الآفات الاجتماعية المنتشرة من ظلم وغش وربا وسرقة الخ. (ص 53ـ54)
جهر بدعوته الاجتماعية الإصلاحية بين قومه في مكة فاستضعفوه ورفضوا دعوته وكانوا له المكائد، فاضطر لهجرتها إلى يثرب حيث أصبح “سيد قومه وزعيم عشرته” قادرا على النزال والحرب، ثم التوسع فيما بعد (ص 60). وبعد أن استتب له أمر المدينة وضع تشريعات إصلاحية اجتماعية (المحبة، المساواة، الإخاء، الخ) واقتصادية (إيجاب الزكاة، إنفاقها على مستحقيها، تحريم الربا، الخ) (ص 61).
هل كان النبي محمد (ص) اشتراكيا؟ لم يكن كذلك، لأنه لم يكن يسعى إلى استئصال التفاوت الاجتماعي، وإنما إلى التخفيف من حدته. فلو كان يصبو إلى الاشتراكية بما هي تحرير الملكية الخاصة من أيدي مغتصبيها “لكان لجأ بعد أن أصبح صاحب أمر ونهي في جزيرة العرب إلى وسائل” أخرى غير الأساليب “الإصلاحية” المذكورة (ص 63). وقد كان لهذه الدعوة أن تتراجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لتستحيل نظاما قائما على تفاوت واضح باستيلاء بني أمية على الحكم.
تتميز قراءة بندلي الجوزي بما يلي:
-اختزال الدعوة النبوية في بعدها المادي التاريخي.
-اختزال هذا البعد في معركة اجتماعية طبقية.
-اختلاق عوامل ومبررات غير مثبتة ل”الوعي الاجتماعي” لدى الرسول (ص).
-قياس التجربة النبوية للتجارب الاشتراكية وهذه متقدمة في الزمن.
-إغفال وتهميش العوامل الأخلاقية والعقدية وما لها من تأثير سياسي واجتماعي.
إن الفهم المادي التاريخي للسيرة مهم ومفيد، ولكنه عادة ما يسقط في جملة أخطاء معرفية من أبرزها: التعسف في إدراج المعطيات، والإسقاط في القراءة، وإهمال العوامل غير المادية/ الاقتصادية.
(يتبع)



