إشارات في السيرة النبوية (10)
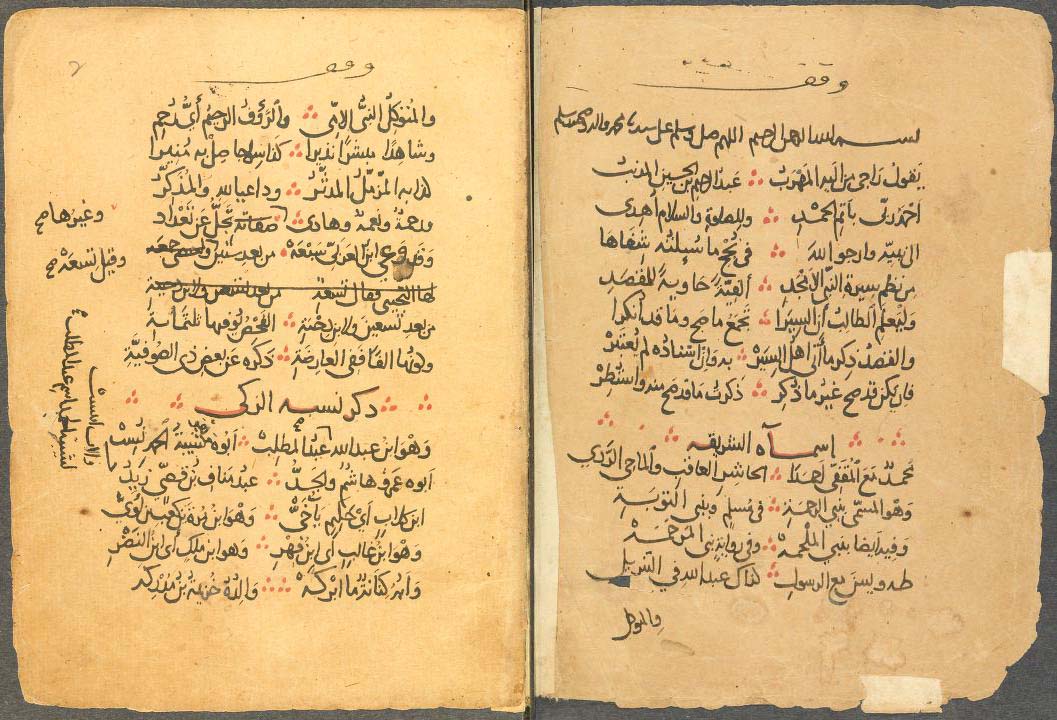
محمد زاوي
التمييز بين المكي والمدني لا يعني غياب الخطاب المكي في الخطاب القرآني بالمدينة، وإنما هو انحسار في موضوع النص المكي -أي الوجدان والعقيدة-يمكن تفسيره بما تفرضه شؤون تأسيس الدولة وتنظيم المجتمع.
وإن قارئ القرآن ليجد الخطاب المكي مرتبطا بأحكام التشريع المدني بكيفية لا تكاد تنقطع، ناهيك عن مقدمات السور المدنية وخواتمها وبعض المواضع ضمنها. إنه استصحاب مكي بصور أربع هي (مع أمثلة من سورة البقرة):
-الارتباط بحكم التشريع: “إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم” (سورة البقرة). الحكم هنا في السعي بين الصفا والمروة باعتباره ركنا من أركان الحج، فجاء الحكم وجاء معه التذكير بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات (“فإن الله شاكر عليم”).
-مقدمات السور المدنية: “ذلك الكتاب لا ريب، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب” (سورة البقرة)/ و”الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون” (سورة البقرة)؛ وهذا قرآن في العقيدة قدّم الله تعالى به لأحكام سورة البقرة.
-خواتم السور المدنية: كقوله تعالى: “كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرّق بين أحد من رسله” (سورة البقرة)، وهو قرآن في العقيدة ختم الله تعالى به سورة مدنية.
-مواضع ضمن السور المدنية: ومنه “آية الكرسي” في سرة البقرة، والتي جاءت في توحيدي “الربوبية” و”الأسماء والصفات”.
فلماذا هذا التذكير العقدي (المكي) في زمن المدينة؟
أولا؛ للتذكير بمصدره حتى لا يظن مسلمو المدينة أن التشريع دنيوي لارتباطه بمصالحهم أكثر مما يرتبط بها الخطاب العقدي والشعائري المكي.
وثانيا؛ لتعزيز التأثير العقدي في نفوس تتحمل مسؤولية تنظيم المجتمع الجديد وحمايته من الأخطار التي تهدده وتوسيع نطاقه وتعميمه على القبائل العربية وخارج شبه الجزيرة العربية.
ثالثا؛ لحفظ جوهر الدين العقائدي/ الشعائري وحكمته الأخلاقية في خضم الممارسة التاريخية وما تفرضه من ضرورات في السلم والحرب. التكيف مع هذه الضرورات، لا يعني القبول المطلق واللانهائي بها، وإنما هو قبول مؤقت يستدعي التذكير بالجوهر الإنساني للدين.
(يتبع)



