إحياء الذاكرة العلمية والروحية في المغرب العميق: قراءة نقدية في كتاب إحاحان
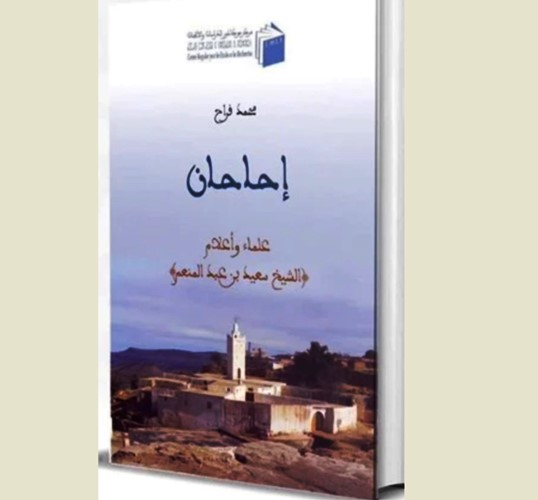
حمزة مولخنيف
يأتي كتاب «إحاحان: علماء وأعلام الشيخ سعيد بن عبد النعيم» الصادر عن مركز موكادور للدراسات والأبحاث، ضمن النسق الجديد الذي بدأ يتشكل في المغرب خلال العقود الأخيرة، والذي يروم إعادة الاعتبار للذاكرة المحلية، وإحياء التراث العلمي والروحي الذي ازدهر في ربوع المغرب العميق، حيث ظل العلماء والزوايا والصلحاء يشكلون شبكة معقدة من التأثير الديني والاجتماعي والثقافي.
في هذا الإطار، يندرج عمل الدكتور محمد فراح باعتباره حلقة من مشروع أوسع، هو إعادة كتابة التاريخ العلمي والثقافي المغربي من الأسفل، من خلال أعلام لم تنل بعد حظها من البحث والتحليل، رغم ما تركوه من بصمات على الحياة الدينية والفكرية في مناطقهم.
إن الحديث عن «إحاحان» هنا لا يُفهم فقط بوصفه إحالة إلى رقعة جغرافية بعينها، بل كمدخل لفهم نسق من أنساق الوجود الثقافي المغربي، ذي الجذور الأمازيغية والعربية المتشابكة، حيث الدين والعلم والتصوف واللغة تتفاعل في بنية واحدة.
فالمؤلف عبر استحضاره لمنطقة إحاحان، لا يكتب تاريخ مكان فحسب، بل يكتب تاريخ فكرة، هي فكرة التداخل بين الجغرافيا والمعرفة، بين الأرض والروح، بين الذاكرة والهوية. فالكتاب بهذا المعنى ليس مجرد تراجم لعلماء وأعلام، بل هو أيضاً بحث في فلسفة المكان ودينامية الذاكرة الجماعية، وكيف تتجسد القيم الروحية في الإنسان والمجتمع المحلي.
يتخذ فراح من شخصية الشيخ سعيد بن عبد النعيم محوراً مركزياً لبناء سرديته التاريخية والفكرية، بوصفه نموذجاً لعالم مغربي عاش في بيئة قروية، لكنها كانت على بساطتها الظاهرة، تحمل عمقاً علمياً وروحياً مدهشاً.
فالشيخ سعيد ليس مجرد فقيه أو متصوف، بل هو تجسيد لتلك الصيغة المغربية الأصيلة التي جمعت بين العلم والعمل، بين النظر والمجاهدة، بين الفقه والتزكية، في إطار ما يمكن أن نسميه التدين المغربي الوسطي، الذي تشكل عبر قرون من التفاعل بين المذهب المالكي والتصوف السني والعقيدة الأشعرية.
يحاول المؤلف أن يرسم للشيخ سعيد بن عبد النعيم صورة مركبة، لا تقتصر على الجانب التوثيقي أو السيري، بل تنفتح على بعد تأويلي نقدي. فهو يقرأ شخصية الشيخ من خلال آثارها في الناس وفي المكان، في الأقوال والأفعال، في المواقف التعليمية والدعوية، وفي رمزية حضوره الممتد بعد وفاته في الذاكرة الجماعية لأهالي إحاحان.
وهنا تتجلى نَفَس المؤرخ الفيلسوف عند محمد فراح، إذ لا يكتفي بالسرد، بل يفسر ويؤول، فيعيد بناء صورة الشيخ ضمن أفق فلسفة التاريخ المحلي، حيث تتحول التجارب الفردية إلى رموز جماعية.
تنبع أهمية هذا العمل من كونه يندرج في صميم المشروع المغربي الراهن الرامي إلى ترميم الذاكرة الثقافية الوطنية، في مواجهة موجات النسيان التي أنتجها العصر الرقمي والتمدين المفرط، حيث تتعرض الهوية المحلية لخطر الذوبان.
فإحياء سيرة الشيخ سعيد، ومعه علماء وأعلام إحاحان، ليس مجرد عمل توثيقي أو احتفالي، بل هو موقف معرفي وأخلاقي، لأن كل كتابة عن الماضي هي في جوهرها كتابة عن الحاضر، وكل استحضار للعالم الصالح هو نقد ضمني للواقع الفاسد. فالذاكرة ليست حنيناً إلى ما مضى، بل هي قوة فاعلة في بناء الذات الجماعية.
منهجياً، يزاوج فراح بين المقاربة التاريخية والوصفية والتحليلية. فهو ينطلق من النصوص والروايات الشفوية والمصادر المحلية، ليعيد تركيب صورة المشهد العلمي بإحاحان عبر قرون، مركزاً على الروابط بين العلماء والزوايا، وبين التعليم الديني والحياة الاجتماعية.
يقرأ الوثيقة بعين الناقد لا بعين الناسخ، ويُفهم الرواية في سياقها التاريخي والنفسي، مستعيناً بمفاهيم من علم الاجتماع التاريخي والأنثروبولوجيا الثقافية. هذه المنهجية التعددية تمنح الكتاب بعداً علمياً رصيناً، وتخرجه من دائرة التراجم التقليدية إلى فضاء البحث المتعدد الأبعاد.
في تعامله مع شخصية الشيخ سعيد بن عبد النعيم، يعتمد المؤلف على مقاربة تجمع بين التأريخ والتأمل الفلسفي. فهو ينظر إلى الشيخ بوصفه فاعلاً في التاريخ لا مفعولاً به، أي أنه ليس مجرد شخصية ماضوية نستحضرها في إطار التقديس، بل رمز لفهم كيفية تشكل الوعي الديني المحلي.
ومن هنا، يبرز فراح البعد الفلسفي في تجربة الشيخ، أي قدرته على أن يجعل من الدين تجربة وجودية تتجاوز الطقوس إلى المعنى، ومن العلم رسالة لا تُختزل في التدريس، بل تمتد إلى تهذيب النفوس وبناء القيم.
اللافت أن فراح لا يفصل بين علم الشيخ وسلوكه، لأنه في الفكر المغربي الأصيل لا يمكن التفريق بين الفقه والتصوف إلا من باب التجريد النظري. فالعالم عند المغاربة هو بالضرورة متصوف، والمتصوف الحق هو بالضرورة عالم.
والشيخ سعيد في هذا الإطار، يمثل نموذجاً لما يسميه المؤلف بـ«العالم المربي»، أي ذاك الذي يجمع بين العلم والمعرفة وبين النظر والعمل، ويُحوِّل العلم إلى وسيلة للإصلاح الاجتماعي والروحي.
هذا التصور يجد جذوره في المدرسة الجُنيدية، كما تجلت في تجارب المغاربة الكبار من أمثال أحمد زروق ومحمد بن ناصر الدرعي وغيرهم.
في كتابه، لا يكتفي فراح بسرد أخبار الشيخ سعيد، بل يسعى إلى تحليل السياق التاريخي الذي أنجب هذه الشخصية، أي حاحة كفضاء ثقافي وروحي. فالمنطقة، كما يوحي العنوان لم تكن هامشاً في التاريخ المغربي، بل أسهمت في تشكيل ملامح الخطاب الديني الوسطي الذي طبع المغرب منذ العصور الوسطى.
فقد كانت حاحة معبراً للتواصل بين الحواضر العلمية الكبرى (مراكش، سوس، تارودانت، سجلماسة، فاس) وبين القرى الجبلية، وهو ما جعلها تربة خصبة لنشوء علماء حملوا رسالة العلم والذكر في آن واحد.
من الناحية الأدبية، يتسم أسلوب الكتاب بلغة رصينة تجمع بين الدقة الأكاديمية والنفَس الأدبي، إذ يحرص المؤلف على أن تكون الجملة مشحونة بإيقاع بلاغي دون أن تفقد بعدها التحليلي. ففي كل فقرة، يحضر الحسّ التأملي إلى جانب الحسّ التاريخي، ما يجعل القراءة متعة فكرية أكثر منها مجرد تتبع لمعلومات.
ولعل هذا التوازن بين العلم والأدب هو ما يمنح الكتاب قيمة مزدوجة: فهو عمل توثيقي من جهة، وتأمل جمالي في الذاكرة والروح من جهة أخرى.
إن محمد فراح، في تناوله للشيخ سعيد بن عبد النعيم، لا يتعامل معه كشخص منقطع عن الزمان، بل ككائن في صيرورة. إنه يراه امتداداً لتاريخ طويل من العلماء الذين أسسوا لتقليد علمي وروحي متين في حاحة والمغرب عموماً.
لذلك يتعامل مع الشيخ كحلقة في سلسلة، لا كاستثناء. هذه النظرة التسلسلية للتاريخ تمنع السرد من السقوط في التقديس الفردي، وتحوّل التجربة الشخصية إلى نموذج تاريخي مفتوح على التأويل.
يبدو أن فراح واعٍ بأن كتابة التاريخ المحلي ليست مجرد تجميع للمعطيات، بل هي فعل تأويلي بامتياز، لأن المؤرخ لا يكتب ما وقع فقط، بل يكتب ما تعنيه الوقائع. ولذلك فإن تحليله لشخصية الشيخ سعيد يتجاوز وصف الأحداث إلى قراءة الرموز.
فالعالم الذي يدرّس في زاوية قروية هو، في منظور المؤلف تجلٍ لفكرة أعمق: أن العلم لا يحتاج إلى مركز، وأن الهامش يمكن أن يكون حاملاً للحقيقة بقدر ما هو حامل للتواضع. وهذه الرؤية تعيد الاعتبار إلى الهامش بوصفه مكاناً لتوليد المعنى، لا مجرد جغرافيا للنسيان.
يظهر في ثنايا الكتاب حضور قوي للهمّ الفلسفي، إذ أن فراح لا يتعامل مع التاريخ بمنطق السرد الزمني، بل بمنطق السؤال الوجودي. فهو يطرح من خلال الشيخ سعيد سؤالاً عن معنى أن يكون الإنسان عالماً في سياق قروي، عن علاقة المعرفة بالمكان، وعن جدلية الروح والعقل في التجربة المغربية.
ومن هنا، يمكن القول إن الكتاب ليس فقط دراسة في التاريخ، بل أيضاً في فلسفة التاريخ، لأن المؤلف يسعى إلى استنطاق الماضي ليكشف عن القيم التي ما تزال قادرة على إنارة الحاضر.
يتجلى البعد النقدي في العمل من خلال الموقف الضمني الذي يتبناه فراح تجاه واقع المعرفة الدينية المعاصرة. فحين يستعرض سيرة علماء إحاحان، فإنه في الحقيقة يُقارن – ضمنياً – بين نمطين من العلم: علم أصيل متجذر في القيم، وعلم معاصر فقد روحه وأخلاقه.
هذه المقارنة غير المعلنة تمنح الكتاب طابعاً إصلاحياً لأنه لا يكتفي بإحياء الماضي بل يستثمره لتشخيص الحاضر. ومن هذا المنظور، يُمكن اعتبار الكتاب جزءاً من مشروع نهضوي هادئ، يشتغل من داخل التراث لا ضده.
يبرز كذلك في الكتاب اهتمام المؤلف بالمنهج التكاملي الذي يدمج بين التاريخ والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا والدين، مما يعكس وعياً معرفياً متقدماً بضرورة تجاوز التخصص الضيق في دراسة الظواهر الثقافية. فهو يقرأ الشيخ سعيد بن عبد النعيم ليس فقط كعالم دين، بل كظاهرة اجتماعية وروحية، كرمز لتوازن الإنسان المغربي بين الأصالة والتجدد. وهذا الإدراك يجعله قريباً من اتجاهات الفكر التاريخي الجديد، الذي يرى أن دراسة الأعلام ليست مجرد تراجم، بل هي مدخل لفهم أنماط الوعي الجمعي.
إن فراح في عمله هذا يبدو وفياً لروح المدرسة المغربية في الكتابة التاريخية، تلك التي يمثلها أحمد التوفيق، محمد حجي، عبد الله العروي، محمد المنوني وعبدالله نجمي من حيث الجمع بين التوثيق والتحليل، لكن بصبغة محلية متجذرة. فهو لا يتعامل مع الوثيقة كمصدر ميت، بل ككائن حيّ ينطق ويُؤول، وهذا ما يمنح بحثه نكهة فلسفية تتجاوز حدود الأكاديمية الجامدة.
إن الشيخ سعيد بن عبد النعيم كما يقدمه الكتاب، هو نموذج للعالم الملتزم الذي عاش العلم لا بوصفه مهنة، بل بوصفه عبادة، عاش الفقه كتربية للروح قبل أن يكون استظهاراً للنصوص. وهذا المعنى الأخلاقي هو ما يسعى المؤلف إلى إبرازه، لأن العلم في التراث المغربي لم يكن أبداً مجرد تكديس للمعلومات، بل كان مشروعاً لبناء الإنسان المتوازن، المترفع عن الأهواء، المرتبط بالأرض والسماء في آن.
يُعيد فراح الاعتبار أيضاً إلى الزاوية كفضاء معرفي وروحي، إذ يُبرز الدور الذي لعبته الزوايا في نقل العلم الشرعي وتعليم القرآن وتخريج العلماء وإصلاح المجتمع. فالزاوية عنده ليست بديلاً عن المسجد أو المدرسة، بل هي فضاء تكاملي يجمع بين التعليم والتربية والخدمة العامة.
ومن خلال الزاوية الإحاحانية، يبرز المؤلف كيف أن العلماء المغاربة استطاعوا أن يصوغوا نموذجاً خاصاً في التكوين العلمي والروحي، لا يستورد من الخارج، بل ينبع من خصوصية البيئة المغربية.
من الناحية الفلسفية، يطرح الكتاب سؤال العلاقة بين العلم والقداسة، بين الإنسان والتاريخ. فالعالم في نظر فراح، هو ذاك الذي يُحوّل المعرفة إلى حضور أخلاقي، ويجعل من ذاته شاهداً على إمكانية التوفيق بين العقل والإيمان. ولعل هذا هو ما يجعل الشيخ سعيد بن عبد النعيم أقرب إلى فكرة “القديس العالم”، حيث تتوحد المعرفة بالفضيلة، ويتحول العلم إلى سبيل للخلاص الفردي والجماعي.
يبدو الكتاب في نهاية المطاف عملاً تأسيسياً بامتياز، لأنه يضع لبنة في مشروع إعادة كتابة التاريخ العلمي المغربي من منظور محلي متصالح مع ذاته، بعيد عن المركزية الحضرية التي طالما همّشت الأرياف والجبال.
فإحاحان، كما يبرز في الكتاب، ليست فقط مجالاً جغرافياً، بل رمزاً لهويةٍ مغربية أصيلة قاومت النسيان عبر العلم والإيمان. ومن خلال إعادة إحياء سير علمائها، يعيد المؤلف رسم ملامح الإنسان المغربي المتشبث بجذوره، المنفتح على الكون، الباحث عن المعنى وسط زحمة العالم الحديث.
في ختام هذه القراءة، أمكن القول إن «إحاحان: علماء وأعلام الشيخ سعيد بن عبد النعيم» ليس مجرد كتاب في التاريخ المحلي، بل هو نصّ فلسفي في شكل دراسة مونوغرافية. إنه كتابة في الذاكرة، وفي الوقت ذاته نقد للذاكرة، ومحاولة لتأسيس وعي جديد بالتراث من داخل التراث نفسه.
فمحمد فراح، في هذا العمل، لا يستعيد الماضي ليمجّده، بل ليستخلص منه دروس الحاضر، مؤكداً أن النهضة الحقيقية تبدأ من الذاكرة، وأن من ينسى علمائه يفقد جزءاً من روحه.
وهكذا يصبح الكتاب شهادة مزدوجة: شهادة على عمق التجربة العلمية والروحية بإحاحان، وشهادة على حاجة المغرب المعاصر إلى العودة إلى مصادره الأصيلة كي يستعيد توازنه بين العلم والإيمان، بين الأرض والسماء.
إن هذا العمل، بما فيه من جدية بحثية وعمق فلسفي وأناقة لغوية، يضع صاحبه ضمن الجيل الجديد من الباحثين الذين يكتبون التاريخ لا كأرشيف، بل كقدر ثقافي وروحي، ويفتح أفقاً جديداً في كتابة التراث المغربي بوصفه تراثاً حياً لا ينفكّ يولّد المعنى عبر العصور.



